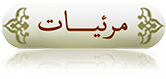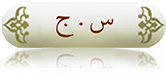اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 |  «السابقالتالي»
2025/09/30 رحلتي إليّ (إلى التسميم الثاني) -3- إلى التسميم الثاني
كان من بين زملائنا الذين قدموا معنا من جرادة إلى وجدة بقصد إتمام الدراسة الثانوية، الزميل الذي ضربته زمن دراستنا في السلك الأول من الثانوي قبل بضع سنوات؛ ضربته دفاعا عن نفسي، ولم أكن بأي وجه من الوجوه معتديا، على عادتي. ولكنّ صاحبنا هذا، كان من الحاقدين وصغار النفوس، فهو مع أنه كان مستمرا على اجتنابي طيلة سنوات، لم ينس ما فعلته به. وكان من خلصائه، ذاك الذي كان معه طيلة سنوات دراستنا، يسير في ظلّه كالخادم المطيع؛ ولم أكن أنا أفهم تلك الصلة بين التابع والمتبوع، ظنّا مني أن ذلك يكون بين كبير وصغير، إما في المقام وإما في السن؛ لا بين قرينيْن لا يكاد أحدهما يفضُل الآخر بشيء... وكان هذان الزميلان يُدبّران لي المكائد على قدر ما يستطيعان، وكان في مقدّمة تلك المكائد أن سلّطا عليّ أحد أقاربهما الذي كان يكبرهما سنّا، وكان يائسا من اجتياز عقبة الباكالوريا، ليصير ملازما لي في جلّ الأوقات؛ خصوصا وأنه لم يكن أمامي غيره. كانت هذه الجماعة من الماكرين يريدون أن يصرفوني بذلك عن الدراسة، خوفا من أن أتقدّمهم كما كنت أفعل في السنين الماضية. أما أنا، فكنت من جهة أصارع السمّ الذي يسري في جسدي، ومن جهة أخرى كنت مشوّش الذهن مضطرب الباطن، إلى الحد الذي لم أعد أطيق معه متابعة الدروس كلها بانتظام وحقيق اهتمام... في هذه المرحلة من عمري، بدأت تتقاطر عليّ "الأسئلة الوجودية"، التي عرفها الفلاسفة على مرّ التاريخ البشريّ كلّه؛ ولكنّني أنا لم أكن متفلسفا، ولا كنت قد بلغت المـُكْنة الفكريّة لأسلك ذلك السبيل. لم أكن أميّز بعدُ ما أنا مقبل عليه، بقدر ما صرت أميّز الفروق التي تجعلني خارج التصنيف الاجتماعي بالتدريج. فـ-مثلا- عندما كنت أسمع كلام الناس عن المال ومركزيته في حياتهم، كبارهم وصغارهم، كنت أنا لا أجد له تلك المكانة في نظري؛ بل ذكرت مرة لوالدي أنني لا حاجة لي بالمال إن أنا كسبته في قابل أيّامي، فأجابني على الفور، وهو يضحك ضحكة خبيثة: - لا تُلق به، وإنما أعطناه فحسب!... قد يظنّ ظانّ، أن الأمر غير جادّ فيما يخصّني: فإما أن يكون نزوة عابرة، أو قلة خبرة لا تلبث أن تتبدّل نتائجها بعد تجربةٍ تُطيح بشطحاتي العقلية. أما الحقيقة، فهي أن هذا المبدأ (كغيره من المبادئ التي ستَبين تباعا) سيكون حاكما على حياتي كلّها، ظاهرا وباطنا. وهذا يعني أنني سأمرّ بمشاقّ على مرّ مراحل حياتي، يقلّ في الناس من يصمد لها... عندما بدأت الأسئلة الوجودية تلح عليّ، صار تتابعها وتوالدها يرد بطريقة لا يد لي فيها: في كل مرّة يأخذني سؤال إلى جانب. وأكثر ما ذهب بلبّي، الكثرة التي في العالم؛ نعم الكثرة، من دون أن أعلم من مدلول المصطلح العرفاني قليلا أو كثيرا. فكنت أتساءل: لمَ فلان -مثلا- فقير، بينما الآخر غني؟... ولمَ نجد مع كل فقير من هو أفقر منه؟... ونجد مع كل غنيّ من هو أغنى منه؟... كان أقراني يجدون لذلك جوابا جاهزا، وهو أن الغني درس جيّدا، ثم شغل منصبا مرموقا، ولعله صاهر إحدى العائلات الكبيرة بعد اشتغاله بمنصبه، أو ورث مالا عن آبائه وأجداده، ولم تصادفه في حياته المنغصات (Contretemps) التي قد أصابت كثيرين من غيره. كان الآخرون يقنعون بالأجوبة الجاهزة، ويرون أن في متابعتها مضيعة للوقت، والحق -من غير شك- معهم بمنطق ما؛ إذ لا بد للمرء إما أن يشتغل بالتفكر، الذي يذهب به إلى حيث لا يعلم فيما بعد؛ وإما أن يكون عمليّا ويتبع توجيهات مجتمعه المتمثلة على الخصوص في مناهج التربية والتعليم. والطريق الأول (طريق التفكر)، مغامرة، قد تُفضي إلى شيء يُذكر، كما قد تلقي بالمرء إلى الجنون أو إلى الانتحار أو إلى غير ذلك من الخواتم الكريهة؛ في الحين الذي يبدو فيه الطريق الثاني (طريق التقليد) مضمون العواقب، ولو جزئيا. ومِن كل مَن عرفت، من الناس، لم أجد من يختار الطريق الأول سبيلا لعيشه، وهذا يدل على نُدرة هذا الصنف في الناس. أما أنا، فلم أختر الطريق الأول، كما قد يختاره الفيلسوف، ولكنني أُلقيت إليه قهرا. بل لقد كنت أظنّ أن غيري من الناس عموما ومن أقراني خاصة، كانوا أبرع منّي في سلوك هذا الطريق، وكانوا أسرع منّي في قطف ثمار "سلوكهم" فيه. وهذا، لأنني ما كنت على علم بتجارب الناس، فلم يبق لي إلا أن أُحسن بهم الظن، وأن أتهم نفسي بالقصور؛ وهو ما سيظهر لي خلافه بعد سنوات طويلة من سلوك طريق الغربة... وإلى جانب ذلك، ما كنت أقنع بالأجوبة الجزئية؛ وإنما كنت أريد أن أتبيّن الخيوط الناظمة لكل "العلاقات" التي تربط الأشياء فيما بينها، من دون اختيار منّي. وكان هذا الصنف من المسائل، يستهلك كل طاقتي، ولا يترك لي إلا قليلا أتمسك به لأُبقي على صلة باهتة بالمجتمع الذي كنت أعيش فيه... لم أكن أعي، أو أرغب، في أن أكون من أفراد البشرية الأفذاذ، الذين سلكوا هذه السبل الوعرة؛ كما لم أكن مطلعا على مختلف الفلسفات التي تناولت ما صرت أنا موثَقا إليه، ولا أستطيع منه فكاكا... وفي الحين الذي كان زملائي في الدراسة يستميتون في الفهم عن الأساتذة من أجل الإعداد للامتحان الكبير، تساءلت أنا مرة داخل حصة للفيزياء، حيث كان الأستاذ يجهد أن يفكك لنا الضوء الأبيض بتجارب مخبرية مختلفة، ولمدة ساعات متلاحقة: ما الذي سيُضيفه إلي العلم بالضوء الأبيض والأضواء الأخرى المركِّبة له، في الإجابة عن أسئلتي التي تتملّكني؟... فأجبت لا شيء!... فأنا كمن يُشارف على الموت ظمأً، وهو ينشغل بحلّ شبكة للكلمات المتقاطعة!... على الأقل الآن... فصممت بيني وبين نفسي على ألا أعود إلى دراسة الفيزياء، حتى أخلص من الأسئلة الكبرى... وأبقيت إلى جانب ذلك، على حضور بعض الحصص من باب تغيير "الجو"، أو من باب استراق السمع إلى بعض الأطروحات التي ربما ستفيدني -ولو جزئيّا- في بلوغ ما كنت أطمح إليه... لم أكن على وعي تام، بأنني قد قررت الخروج من الطريق العام المسلوك، إلى طريق فرعي مجهول... وأذكر هنا، أن الوالدة بعد أشهر، حكت لي رؤيا قد رأتها لي: قالت: رأيتك يا ولدي مفتّح العينيْن ولكنك لا تبصر، ومع ذلك كنت تسير في الطريق من دون أن تتعثّر؛ ثم ما لبثت أن خرجت إلى طريق صعب ملتو وكأنك تصعد جبلا، ولم يكن من يسير في طريقك سواك!... وقد كانت امرأة (هي الدنيا من جهة التعبير) تعرض عليك مجموعة مفاتيح على طريق آخر مخالف وسهل. حكت لي الوالدة الرؤيا، وهي تُشفق عليّ، لصغر سنّي، وغلبة سذاجتي عليّ؛ وأما أنا فكنت من جهة باطني كمن أُخضِع للتخدير من أجل إجراء عملية جراحية: على علم ببعض ما سألاقيه إجمالا، غير محسٍّ بثقل ما أنا مقبل عليه؛ لأنني لو أحسست، لَمِتّ لساعتي... كل هذا، سيتضح بالتدريج مع مرور أيام عمري!... أين أنا، مما كان عليه أقراني من إقبال على دنياهم بآمال عرضها الأرض بأسرها!... كانت أسئلتي وجدانية، ولم تكن فكرية؛ حارقة تستهلكني مع الأوقات. وهذا يجعل أجوبتها وجدانية غير فكرية أيضا؛ وهو أمر عسير، لم يخض غماره إلا كبار العارفين من أمتنا. أما الأمم الأخرى، فأبواب ذلك موصدة دونها، لسبب سيَبين لي فيما بعد عمليّا وبطريق الذوق (التجربة الذاتية). لم أكن أميّز في ذلك الوقت هذه التفاصيل، لأن هذه التفاصيل تدخل ضمن علوم المنهجيّة والإبيستيمولوجيا، وأنا كنت مبتدئا، لا أعلم شيئا من الأصول والمبادئ، ولا من فروعها وتشعيباتها. أنا كنت كـ "حيّ بن يقظان" من غير تفلسف؛ وهذا يعني أنني كنت أسلك سبيل الذوق المعرفي -كما أسلفت- من دون أن أعلم حتى اسمه؛ غير أن الأمر صار يشتد عليّ ويشتدّ... ما عرفته في هذه المرحلة كان أشدّ مما يعرفه الدارسون للإمام الغزالي عنه، إبّان زمن حيرته التي بلغت به أن يمتنع عن الطعام. وهذا، لأنني وجدت أنا نفسي سائرا في طريق الامتناع عن العيش برمّته، لا عن الطعام وحده!... وإن كان لب الأمر واحدا في الحقيقة، وإنما الاختلاف في قوة الوارد وحدها فقط...
***
لقد كانت كل الغربة التي أعرفها فيما سبق، غربة اختلاف متبوعة برفض من المحيط الاجتماعي بسبب التميّز؛ أما الآن -وبعد بدء تعقّلي للأمور- فإن الغربة ستصبح مضاعفة، عند انضياف الغربة الاختيارية -ولا اختيار- إليها؛ وسيبلغ الحد فيها فيما بعد إلى أن صرت أرى نفسي وكأنني من كوكب آخر، نزل بطريقة تخرج عن إرادته إلى كوكب الأرض الغريب. فصرت في أحيان كثيرة، أتفرّج على الناس، وهم يعيشون بحسب ما كان يبدو لي، عيشة تُشبه العيشة؛ ولكنها بالقطع ليست هي، وإنما هي أقرب إلى السلوكات الآلية... أنظر إليهم حينا، وأعود إلى نفسي حينا، ليتأكد لي أنني لست منهم. لم أكن أعلم لمَ أنا لستُ منهم؟ ولا لمَ هم ليسوا منّي؟ فهذا هو ما كنت أسعى إلى تبيّنه، ولكنّ المسلّمة التي انطلقت منها وجدانيا هذه هي، ثابتة لا أشك فيها مثقال ذرّة... وأنا عندما كنت أنظر إلى طريقة عيش الناس، كنت أجدهم نسخا متشابهة، يكادون يعودون إلى المرجع ذاته، المؤسِّس لآرائهم ومواقفهم (إن صحّ أن تكون لهم آراء ومواقف)، ولأقوالهم وأفعالهم وحتى أحوالهم. والغريب في الأمر، هو أن هذا المرجع الناظم، لم يكن لديهم "العقلَ" الذي ينبغي أن توزن به الأمور، بحسب المنطق والأنساق؛ أو يكن "الدينَ"، كما كان يزعم جيل الكبار في أحيان كثيرة. وبما أنني لم أكن أجد لمجتمعنا لا عقلا ولا دينا معتبريْن؛ على أنني كنت أؤخّر الدين في النظر، بسبب مشاركتي لجيلي -على الأقل من حيث المنطلق- لما يقبله العقل السليم وحده في هذا الطور من العمر، والذي يكاد العقل يكون فيه مجرّدا. أقول "يكاد" لأنني علمت فيما بعد أنني كنت على فطرة قوية ونقية، يزخر تحتها بحر من المعارف التي وُلدت عليها، كما سبق لي أن أخبرت في صفحات خلت. كانت عقلانيتي الصادقة، تجعلني أرفض مجتمع الكبار الذين يبغون التحكم في مصائرنا على ما بهم من جهل باد، فحالهم كما يُقال: "فاقد الشيء لا يؤتيه!". كان أقراني يتمكنون بخلافي، من مجاراة عائلاتهم، وكأنهم قد تلقّوا عنها بذور نفاقها التي تعيش عليه في تناقضات تأباها المجتمعات التي كنّا نراها متقدّمة. أما أنا، فلم أكن أتقبل النفاق فيما بيني وبين نفسي، وكنت أعدّه خيانة للنفس. لم أكن أدرك بعد، مبلغ الأثمان التي سأؤدّيها من صحتي وراحتي بسبب رفضي للنفاق... لم يمض عليّ وقت طويل، إلا وأنا فاقد لكل المعايير العقلية، بعد أن انهارت منظومتي الهشّة التي تلقيتها عن مجتمعي في السنوات الماضية؛ وهنا صرت أعيش كورقة في مهبّ الرياح العاصفة. كنت أحيانا أبثّ إلى من أكون برفقتهم، وهم قلة قليلة، بعض ما أجد، كأن أسألهم: الناس يتكلمون عن الخير والشر، فكيف نميّز في مستوى الأفعال الخير من الشر؟... في البداية كانوا ينظرون إليّ باستغراب، لأن هذه التساؤلات لم تكن تعرف طريقها إليهم؛ ثم ما يلبثون أن يقدّم كل واحد منهم نموذجا عن خيره وشره، كأن يقول أحدهم مثلا: من أنقذ شخصا كان سيموت غرقا في البحر، بسبب عدم إحسانه للسباحة، فلا شك أن هذا خير؛ ومن سرق مالا من عجوز، كانت ربما ذاهبة به إلى السوق لتبتاع حاجيات لأحفادها الصغار الذين تركتهم في البيت، فهذا لا شك سيكون من الشرّ. فكنت أتدخّل لأقول فيما يخص المثل الأول، من ينقذ السابح في البحر الذي كان موشكا على الغرق، لن يبقى عمله ضمن تصنيف الخير، إن كان هذا الذي نجا، ينوي على قتل شخص آخر في ذلك المساء، كأن يكون ناويا على قتل زوجته بعد أن أثبت عليها جرم خيانته؛ أو ناويا على قتل شريكه في العمل الذي اختلس منه أموالا كثيرة، وحمّله بالاحتيال تبعات سداد الديون للشركة؛ أو ناويا على قتل نفسه بتكرار الفعل منه، بعد أن فشل في قتلها إغراقا لها، وبعد تدخّل منقذه (وإن كان هذا الصنف ألطف من غيره)... بعد مثل هذا الكلام، كان الرفقاء يبدّلون موضوع الكلام، ليعودوا إلى تفاهات تفاصيل يومهم، والتي يضحكون منها لأقل الأسباب، وكأنهم يعيشون جنة معجّلة، قد ضُمن لهم فيها تغييب كل المنغّصات... كنت أنا أغبطهم على غفلتهم وغرّتهم، من دون أن أقبل أن أكون عليهما. أمام هذه المواقف، كنت أقف عاجزا؛ لأن الأمر لو كان جنة معجّلة، مع تحقّق الضمان، فإنهم سيكونون حتما على طريق الصواب؛ وأما أنا فسأكون على خلاف طريقهم لا أعيش جنّة، بل كان يصدق عليّ بيت المتنبّي: ذو العَقلِ يَشْقى في النَّعيمِ بِعَقْلِهِ ... وَأَخو الْجَهالَةِ في الشَقاوَةِ يَنعَمُ خصوصا، وأنا أعيش آثار السمّ الساري في بدني: ينتشر كل مرة أكثر من السابق، لأتألّم أنا كل مرة ألما أكبر من كل ما تقدّمه. هذا من دون اعتبار للرفض الاجتماعي الذي أجده مـُحكما حولي، وأجد معه عيشي بين من يرفضونني، أمرا يزيد من الألم البدني، وكأنه زيادة أُخَصّ بها من دون أقراني، في نظري -حينئذ- من دون سبب يُدرَك؛ أقول هذا، لأنني كنت أَطْيَب الرفقاء جميعا، حريصا على معاملتهم معاملة تخلو بالتأكيد، من إضمار الشر لأحد، أو بالركوب على ضعف أحد، أو استغلال حاجته. كنت أعامل الناس بفطرتي، على أساس الأخوة، بمحبّة خالصة، وبرجاء نفعهم قدر ما أستطيع. لكنّني لم أكن أجد منطلقاتي، تحكم أفعال أصحابي وأقوالهم: فهم أحيانا، ما كانوا يقيمون وزنا لما سأجده وهم يواجهونني بما أكره من الكلام؛ حتى كنت من شدّة خيبة ظنّي، ومن ضعفي إزاء هذه المواقف، أسكت ولا أرد. أولا، لأنني لم أكن أفهم الباعث حقيقة، وثانيا لأنني كنت أستحيي أن أرد على أحد بلفظ غليظ، بالإضافة إلى أنني لم أُجرّب هذا الصنف من الردّ فيما قبل بما أنّني لم أُعدّ له. وهذا في النهاية كان يجعلني كالبنات، لا أتمكّن من الدفاع عن نفسي، كما يدافع الآخرون. فكنت عندما أنصرف، بعد موقف من هذه المواقف، أكره نفسي، وأُسائلها: لمَ كان أقراني على خشونة في معاملتهم؟... ولمَ أنا أكون دائما مهذَّبا، لا أرد على السيئة بمثلها؟... وشيئا فشيئا، صرت على وعي بأنني تلقّيت تربية أحدية الجانب، عندما لقّنت مبادئ الخير النظرية على يد والدتي وجدّتي، وعلى يد أساتذتي؛ من دون أن أُعَدّ لمواجهة ما أكره، بأي صنف من الإعداد... وفي غياب أستاذ للتربية بالمعنى التام، والذي علمت فيما بعد أنه ينطبق على التزكية الشرعية التي لم تكن قد طرقت سمعي بعد، لم يكن بإمكاني الشهادة لنفسي بأنني أفضل حالا من أقراني، من دون برهان متين في نظري، أنا من كان يريد معرفة حقيقة حاله. ومع بدء تسرّب الشعور بالحقارة في نفسي، مع اختلافي في المعاملة عن جلّ مجتمعي؛ وبعد تسرّب بعض المقولات إلى سمعي عن "علم النفس"، الذي صار من ركائز الحداثة التي أُسِّس لها في بلداننا بشتّى الوسائل؛ وعند سماعي ولو لمرات قليلة لأحد ما يصفني بأنني معقّد؛ بدأ الظن يقوى عندي بأنني مريض نفسي؛ ومع تفكري في الأسئلة الوجودية التي عرفتها الإنسانية عبر كل تاريخها، صرت أتهم نفسي بالسير حتما نحو الجنون... كان يشهد لي في أحكامي، مفارقتي لمجتمعي من حيث المبادئ وطريقة العيش؛ وسيزيد على هذا اقتناعي وحدي من دون أقراني بعدم جدوى الدراسة التي كنت أتابعها في إطلاعي على حقائق الأمور. كنت على يقين بوجود الحقيقة، من خلف كل هذه المظاهر الكونية المشتِّتة لإدراكي؛ كنت كمن يعلم بوجود شيء، من وراء الحائل؛ ولو خطر لي أن كثيرين من قبلي قد مروا من هذه الطريق، ربما لكنت استعنت بتجاربهم وعملت بخلاصاتهم، لعلي أخرج من جحيم الانفصال؛ ولكنّ الأمر كان كالبداية الجديدة للإنسانية كلها، من خلال ما دخلت فيه من تجارب بدنية وعقلية... كان الأمر شاقا جدا، إلى الحد الذي صارت فيه آلامي البدنية تخفّف بعض ما بي من الآلام النفسية... وزاد من اشتداد وطأة الحال عليّ، أن كل قراءاتي السابقة، لمختلف الأطروحات الفكرية، لم ترْقَ إلى الحد من معاناتي أو التقليل منها؛ بل إن تمثّلي لبعض قراءاتي، كان يزيد من إيغالي في غربتي، عندما أنتهي إلى تبيُّن ضحالة كل ما كنت أتمثّله...
***
بعد حوالي الشهريْن من انتقالنا إلى وجدة، كنت على موعد غريب مع القدر، سيكون له الأثر الكبير على حياتي كلها فيما بعدُ، بغيبها وبشهادتها. وذلك لأن الزميل الذي سبق أن ضربته في مستوى السلك الأول من الثانوي، والذي كان يجتنبني لسنوات، طيلة مدة دراستنا بجرادة، وطيلة الأسابيع الأولى من دراستنا بوجدة، قد وجد الفرصة سانحة وأنا أَعزل أمامه، ومن دون سند يخشاه (بحسب إدراكه). فعمل هو (ر. إ)، وصديقه (أ. ز) الذي ما زادته السنين إلا إخلاصا ووفاء وخدمة لـ "سيده"، مع قريبهما (ب. ق)، والذي كان يرافقني كثيرا في تجوالاتنا عبر المدينة، ربما تمهيدا لما سيشتركون في إنجازه من جريمة "الشروع في القتل". كنا ذات ليلة من ليالي الخريف كما أظن؛ خرجنا على عادتنا إلى ساحة الثانوية، نجلس قليلا على المقاعد هنا وهناك، قبل الذهاب إلى المهجع بقصد النوم. جلست على جانب كرسيّ حديدي انتظارا لموعد الصعود إلى الطابق الأول، فما لبث (ب. ق) أن أتى ليجلس بجانبي، وكأن الأمر على العادة؛ ثم ما لبث ذاك الذي يُعاديني ويحقد عليّ لأسباب عديدة، يأتي مع "وصيفه" أو (خادمه)، على غير العادة إلينا. كان الزميل الحقود، لا يتمكن من رفع نظره إليّ، رغم أنه أظهر حدا أدنى من التودّد، وكان الآخر الوصيف، يكثر من التبسم وإظهار تودّد غير معهود، يُصاحبه احمرار على وجنتيْه الممتلئتيْن البيضاوتيْن؛ أما كبير السن الذي كان أقرب الجميع إلي، فإنه كان منطويا على نفسه، وكأنه مـُقدِم على أمر خطير، أو ربما كان يتمنّى أن يكون الإخفاق حليف ما كان يُدبَّر لي في تلك الليلة... كان الحقود يحمل خبزة طويلة حُشيت بما ظننته مرقا ولحما، حسبت أنهما استبقياه من وجبة عشائهما؛ أو أن أحد العاملين بالمطبخ قد نحلهماه. وبعد تبادل النظرات بين الثلاثة، قسم المجرم الخبزة مناصفة، ومدّ النصفيْن إلى وصيفه، ليعطي (ق) نصفا، ويمدّ إليّ أنا النصف الآخر. وقد كان المراد من هذا، أن نبدو وكأننا أكلنا الطعام ذاته، بينما في الحقيقة كان النصف الذي قُدّم لي مسموما وحده. أنا لم أكن معتادا منهم إلا على التجاهل والإقصاء، فظننت أن الشابّيْن قد غيّرا رأيهما بخصوصي، فلم أُرد ردّ الهدية حتى لا أكون رادّا ليد تمتد إليّ بخير؛ وقلت في نفسي: ربما يصير هذا بداية لصداقة جديدة خالية من الترسبات النفسية السيّئة. فبدأ (ق) يلتهم النصف الأول من الخبزة، فتشجّعت وبدأت أنا أقضم من النصف الذي عندي؛ وهذا، لأن الزملاء كانوا يحرصون على أن آكل حصّتي أمام أعينهم. عندما شرعت في مضع اللُّقم، كنت أُحس وكأن ما كنت أحسبه لحما هو جلد خشن، يُشبه جلد الضفادع البرية؛ ولكنّ حيائي غلبني فأتممت النصف من الخبزة، كما أتم الآخر نصفه الذي لا شك كان خاليا مما أُطعِمْتُه أنا. حدث لي في تلك الليلة موعد مع القدر، كان هو موعد تسميمي الثاني. وقد وقع لي ما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به في حديثه الشريف: «إِذا أَرادَ اللهُ إِنْفاذَ قَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، سَلَبَ ذَوِي الْعُقولِ عُقُولَهُمْ، حَتَّى إِذا نَفَذَ قَضاؤُهُ وَقَدَرُهُ وَمَضَى أَمْرُهُ، أَعادَ إِلَيْهِمْ عُقولَهُمْ فَوَقَعَتِ النَّدامَةُ»[1]. أما أنا في حقيقة ما كنت عليه، ما كنت أحفل بشيء، ولا كان يختلف في نظري شيء عن شيء، فما كنت أعانيه في باطني كان يهون معه عليّ الموتُ نفسه. أما الآن، فأنا عندما أذكر من أساؤوا إليّ بشيء في حياتي، فإنني لا أحكم عليهم، كما تفعل العامة، ويدعون عليهم بشر ما يدعون به من عبارات الاقتصاص والانتقام. أنا أعلم أن الحاكم علينا جميعا هو الله، كما أعلم أن ما ابتليت به وقتئذ، كان تربية ربانية، ستُنتج لي ما لم يكن يخطر لي ببال من عظيم الخير؛ لهذا، فأنا عازم يوم القيامة أن أسكن تحت حكم الله رضى به، فإن أذن الله لي بالشفاعة، فإنني سأشفع في هؤلاء الذين آذوني، إن كانوا من أهل الشفاعة، ومنهم هؤلاء الذين سمموني...
***
ربما في صبيحة الغد تلك، كانت أعراض التسمم ما أبقت لي من خيار للبقاء حيث أنا، فتوجّهت على غير عادتي إلى الحافلة التي أقلتني إلى جرادة، حيث توجّهت إلى بيتنا متحاملا على نفسي، وموليا ظهري للدراسة. وبمجرّد أن هيأت لي أمي "سدّاريا" (مصطبة) أضطجع عليه، بلغت بي الحمّى قوة، ظننت أنني كنت أغيب بها عن وعيي المرة بعد الأخرى؛ وكنت أتعرّق تعرقا شديدا، كما لو أُهرِقت عليّ سطول من السوائل تباعا. بلغ الأمر بذلك العرق الكثير، أن أمّي عندما اطلعت على الإسفنج الذي كان تحت غطاء الفراش، وجدته يتفتت، كما لو صُبّ عليه حِمض من الأحماض. بقيت على هذه الحال، من دون أن أقوى حتى على الذهاب إلى المرحاض بمفردي، إِن لم أُحمل إليه حملا من قِبل والدي، بعد عودته من عمله. وبعد انقضاء أسبوعيْن متتالييْن، ألححت على والدي أن يرافقني إلى طبيب إسباني، كان حسن السمعة في وجدة، وعزمت على أن يُجري عليّ كل الاختبارات اللازمة والفحوصات، لأخرج من هذه الحال بخبر يقين... كل هذا، وأنا لا أربط بين الوجبة الليلية المسمومة، وما آل إليه أمري؛ بسبب سذاجتي وغلبة حسن الظن عليّ. فبقيت سنين طوالا، وأنا أعاني بالليل والنهار، ومشهد التسميم غائب عن ذهني، إلى وقت غير بعيد جدا، حينما شاء الله لي أن أعرف حقيقة الأمر، فأشهدني مشهد تلك الليلة بشهادته وغيبه؛ فعلمت من الله، ما وقع لي؛ وإلا كنت سأبقى على عدم الكلام في المسألة من غير شك... عرضت نفسي على الطبيب الإسباني، وطلبت منه أن يستعمل كل ما يتطلّبه الأمر، من دون حساب لارتفاع سعر الفاتورة؛ ففحصني عدة فحوصات، بمختلف الأجهزة، وسأل أسئلة كثيرة، أجبت عن كلها، إلا ما يتعلّق بهدية ذلك المساء المسمومة، والتي كانت كأنها قد مُسحت من ذاكرتي. وكم كانت دهشتي وضجري عندما طالع الطبيب نتائج الفحوصات، وتأملها طويلا؛ لكن وجهه كان يعكس حيرة، لم يجد لها في علمه الطبّي ما يُبدّدها، فخاطبني وكأنه يكذب عليّ متعمِّدا: - ليس بك شيء!... صحتك على ما يرام!... هممت بأن أصفعه -لو بقي في عضلاتي من قوة- لأنني أحسست بإهانة كبيرة، وكأنه يسخر منّي، مع معاينته لحالي معاينة. ولكن هذا، سيجعلني -بعد تكرار التجربة- أيأس من الأطباء كلهم فيما بعد، بخصوص حالات التسمم التي عرفت أنهم يجهلونها تماما. فكان من التصحيحات لمواقفي الفكرية، أن صرت لا أثق بالأطباء إلا في مستصغرات الأمور، إن هم وُفِّقوا لتبيُّنها. وهكذا، فإن الطبيب الذي كان يُصوَّر لنا على أنه ميكانيكي الأجسام، يُصلحها كما يُصلح الميكانيكيّ المعهود السيارة المعطوب محرّكها (!)، أصبح في نظري ميكانيكيّا غير ذي كفاءة. وفي الحقيقة، فقد كان ذلك انكساراً لأحد الأصنام التي علّمني مجتمعي أنها الآلهة المعبودة له، ضمن جماعة من الآلهة مختلفة التخصصات. وعلمت فيما بعد أننا لم نكن نختلف عن المجتمعات الوثنية، إلا في بعض التفاصيل من جهة اختلاف المظاهر الحديثة عن شبيهتها القديمة؛ وأما المبدأ الوثني فهو هو، من غير شك. ولعل الوثنية المنبثة في مجتمعاتنا، تجمع من كل وثنية قدْرا: فهي رغم أنها لم تكن على ظاهر الوثنية العربية، لم تخالف روحها، وهو قصد صورة من صور الأكوان بالدعاء والطلب. وأما من الجهة العقلية، فإن وثنيتنا كانت أقرب إلى الوثنية اليونانية والمصرية القديمة؛ خصوصا إنْ داخَلها ما هو في أصله من علم التنجيم، أو خالطها ما كان من الطقوس السحرية التي ما زالت تنتشر في بلداننا، وكأننا قبيلة من قبائل أدغال أفريقيا!... وعندما خرجت إلى والدي في غرفة الانتظار، وسألني عن النتيجة وأخبرته بما أخبرني الطبيب، ظهرت على وجهه الخيبة، وتهيّأ لأُسنِد عليه جسدي المنهك ونحن نخرج من العيادة؛ بقينا عند الرصيف القريب نترقّب مرور سيارة أجرة تأخذنا إلى محطة المسافرين، حيث اشترينا تذكرتيْن وركبنا الحافلة قافلين إلى جرادة، حيث كانت أمي تنتظر متلهّفة لتطمئنّ على ابنها البكر الذي تحمّله آمالا كبيرة ومصيريّة. خاب ظنّ أمي المسكينة عندما أخبرتها باستنتاج الطبيب، وألحت على أن نجرب أطباء غيره، وفي مدة قريبة. وفي أثناء الحديث، ذكر لنا الوالد أمر رجل كان معه في غرفة الجلوس، وفي الوقت الذي استُدعيت فيه أنا إلى غرفة الفحص، سأل الرجل والدي عني قائلا: - أهو ولدك؟... - نعم هو ابني، ويدرس في السنة النهائية للثانوي هنا في وجدة... - أنا تفحصت حالته بالنظر، وأقول لك: ابنك ليس به مرض من الأمراض العضويّة!...
***
كانت هذه العبارة كودا بين أفراد مجتمعنا، يُفهم منها: أن ابنك به سحر!... أما أنا، وتأثُّرا بما لُقِّنْتُه فيما قبل، فقد كنت أعتبر السحر خرافة، لا يليق بأمثالي من أصحاب العقول العلمية، أن يلتفتوا إليه؛ رغم أن بعض الأحداث كانت تدل عليه... فذات مساء، جاءتني والدتي وعلى ملامحها قد هيمن الجد واعتلى، فسألتني: ما شأن الكتابة التي أجدها على قميصك الداخلي؟... فأجبتها على الفور: ما لاحظت أنا كتابة، وأستبعد أن توجد كتابة في الموضع الذي أشرتِ إليه، وهو أعلى جهة اليسار. فلم يُثن ذلك والدتي عما في ذهنها، وقد حفظها الله من التعلّم في المدارس التي صرنا نسير فيها على أقدام المستعمر الكافر، على عمهٍ أكيد. وكان الاقتراح الذي سبقتُ إليه، ظنا منّي أننا بهذه الطريقة العلمية التجريبية، سنجعل للتأويل بالسحر حظوظا ضعيفة في احتمالية استمراره؛ هو أن نتأكّد من نقاء القميص اليوم قبل النوم، ثم نلتقي في الصباح لفحصه والتأكّد من بقائه على حاله. ففعلنا ما اتفقنا عليه، راقبنا النقاوة قُبيْل النوم، ثم راقبنا في الصباح الموضع المعلوم. وكم كانت دهشتي كبيرة، عندما وجدت على أعلى القميص سطريْن مكتوبيْن بـ "الصمغ" الذي يَكتُب به عادة معلمو القرآن والسحرة، بخط لم يكن مقروءاً لي: فلا هو عربي، ولا هو لاتيني!...
وعندما تأكدت أمي من تكرار الأمر، صارت أكثر وثوقا وأكثر إلحاحا؛ فما وجدت غير أبي الذي كان من بين أصدقائه سحرة معروفون. لا أقصد أنهم كانوا معروفين بتلك الصفة المستشنعة، وإنما كانوا ككثيرين من غيرهم يُعرفون بصفة "الطلبة"، التي هي رديفة لصفة "القرّاء" بين السلف. فلما سألهم عن الواقعة، قيل له -كما أخبر-: إن هذا الصنف من "العمل"، إنما يُراد منه تخويف الشخص أو تنبيهه إلى شخص يريد التقرّب منه. لم أفز أنا من هذه الواقعة، إلا بأن "علمية" أيّ طرح، لا تتوقف عند ما تلقيناه في المعاهد، ولكنها تتجاوزه إلى كل ما يقع في العالم، بطرائق أخرى لم يكن معلِّمونا في نيتهم أن ينظروا فيها بالعناية نفسها التي يولونها للمواد التي يدّعون تبجيلها؛ وهذا يُنقص من "علميتهم" في نظري، ولو بقدر ما، من غير شك!... ولا غرو أن كثيرين من الناس، ما يزالون يتساهلون في العلمية التي ينسبونها إلى عقولهم، من دون أن يبحثوا في الأدلة التي تُثبت الأمر أو تنفيه، من الجهة العلمية المعتبرة... وهذا جعلني أقف على أمر خطير يتعلق بالتعليم للعلم في بلداننا، وهو أننا نتلقّى ما يُسمّى لنا علما، على أنه قد صار مسلّمة، جاوزت مرحلة التمحيص، وهيهات!... ورغم أنني أنا قد بدأت أفيق، وبدأت أدخل في حوار مع نفسي، من أجل اتخاذ القرارات الصائبة فيما يخص الدراسة النظامية، فإن أقراني ما كان يُهمّهم شيء مما أحرص عليه أنا هذا الحرص كلّه. أما أعذارهم في سبيل تفضيل مذهب التقليد الأعمى، على غيره من المذاهب، فكان أمرا مرفوضا في نظري وفي نظرهم؛ لكن الفرق بيني وبينهم أنني أنا كنت مستعدا لأن أتنازل عن كل حظوظي الدنيوية، بخلافهم هم، الذين كانوا يرون أن الحظوظ من ظفر بالمناصب، واقتناء للبيوت الفاخرة، وعيش عيشة الرفاهة، كانت (الحظوظ) جديرة بأن تُقدّم لها قرابين الاستسلام والانقياد والامتثال، طمعا في القطع مع البؤس الذي ذاقته غالبيتهم في طفولتهم وبداية شبابهم. لقد كانوا مستعدّين لركوب الطريق الغلط، والمسألة عندهم لا تقبل التردّد زمنا واحدا، بخلافي أنا المتصلّب العنيد!...
***
ها قد بدأت الأحداث تفرض عليّ اتخاذ قرارات مصيرية، سيكون لها الأثر الكبير على حياتي الدنيوية؛ كما من غير شك، سيكون لها الأثر الأكبر على حياتي الأخروية. مع أنني ما كنت أفكّر في الآخرة في البدء، وإنما كنت عمليّا جدّا، أتناول ما يعرض لي في عيشي اليومي؛ وأما ما كان يخرج عنه، فقد كنت أعتبره صنفا من الفضول أنزّه نفسي عنه. غير أن القارئ -لا شك- سيعلم أن المسائل المؤجّل النظر فيها، كانت مرهونة بالوقت فحسب؛ ففي أي يوم يعرض لي ما كنت أرفض النظر فيه في اليوم الذي قبله، سأكون مضطرا إلى إعادة النظر، من باب الوفاء لمبادئي بيني وبين نفسي. وقد تكون إعادة النظر تلك، سببا في تغييري لمساري كله فجأة؛ وهكذا، لن يُفاجأ القارئ، إن رآني أتناول ما لم يكن هو يراه جديرا بذلك الموضع من حيث الترتيب العام بين جميع ما يُنظر فيه، ومن حيث درجة الأهمية، التي ربما لن يقبل أقراني (بله من يكبرونهم) بالجدية التي كنت أتحلّى بها حيال كل السياقات وكل عناصرها...
***
ما لم أكن أعلمه، هو أن السمّ بعد المرحلة الأولى التي يكون فيها ما يزال لم يُغادر المعدة والأمعاء، سيبدأ بالتسرّب مع الدورة الدموية إلى جميع أعضاء جسمي، وسيصل إلى كل خلية من كل نسيج. وهكذا فإن العضلات والأعصاب والعظام والدماغ والدم ذاته، ما سلم واحد منها من آثاره. هذا ما عرفته بعد سنين طويلة من المعاناة الشديدة، لا ما كشفه لي طبيب من الأطباء. ومن هنا، عرفت أن علم السموم تخصص، وأن ذلك التخصص لم يكن متاحا في بلداتنا ومدننا في ذلك الزمان، ولا حتى في زماننا هذا بخصوص هذا الصنف الشائع بيننا والذي يكون في أصله سمّا عضويا يخلط مع سموم أخرى كيميائية تزيد من تعقيده وقوة أثره، مع قابليته للنمو داخل الجسم مع مرور الزمن؛ وعلمت أن الأطباء من ذوي التخصص العام، والأطباء من ذوي التخصصات الأخرى، لا يعلمون شيئا خارج ما درسوه في كلياتهم. فوجدتهم، كالميكانيكي، الذي لا يتمكن من إصلاح سيارة حديثة، استقدمها أحدهم من الخارج مثلا...
وبعد مرور الأسبوعيْن الحرجيْن، عدت إلى وجدة لأكمل دراستي، ولكن السم هذه المرة، المتنامي داخل جسمي، مع الحمى الشديدة المصاحبة له ليلا ونهارا، وما ينتج عن ذلك من آلام في الرأس لا تنتهي، كان قد ذهب بكل قدرة لي على التركيز. وإذا زدنا على هذا الألم الظاهر كل الآلام النفسية التي كنت أكابدها منذ الطفولة الأولى، والتي كانت ناتجة عن سوء التربية في البيت، وعن عداء المحيطين بي لي من دون سبب ظاهر، والذين كانوا يُعاملونني وكأنني أخذت منهم شيئا هو لهم بالأصالة؛ بحيث قليل من الناس من كان يمعن النظر في وجهي، وقليل منهم من كان يحيّيني بغير تحيّة جافة، ومصافحة لا تكاد يدانا فيها تتلامسان؛ هذا كله، كان يجعلني أشعر بالنقص، وبالضعف أمام المجتمع؛ وكان هذا الاحتكاك متزايدا مع الأيام، وكانت نتائجه متفاقمة باطّراد... لكن على الرغم من ضعفي، فإنني ما كنت لأغير من سلوكياتي من دون برهان علمي وأساس عقليّ متين... أريد أن أقول هنا، أن الأمر مهما بلغ من صعوبة، فإنه ما نال من عزيمتي، ومن إصراري على مجاوزة كل الصعوبات التي تعترض طريقي... طريقي أنا، لا الطريق "الافتراضي" الذي يسير فيه القطيع... [1] . حديثٌ رواه الديلمي في مسند الفردوس من حديث عليّ وأنس بن مالك رضي الله عنهما مرفوعاً. ومعنى الحديث يعضّده الواقع من أحوال الناس. وهذا الصنف من الأحاديث، هو من أصحّها... |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.