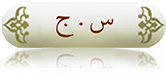اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 | 
2026/01/02 معنى السياسة وما يتفرع عنه
كنت أستمع لبضعة نفر من وجوه اليسار (الشِّمال) في المغرب، وصرت مع مرور المدة أتعجّب من تحجّر عقول أولئك المساكين على معان لُقّنوها في طراوة أعمارهم بلا شك، وزادهم مرور الزمان عليهم وعليها توهّما لوثوقيتها من غير شك أيضا... زاد من عيش هذا الصنف من الناس لأوهامهم، أن شطرا منهم "أساتذة جامعيّون"، قد أصابهم زهو المنصب في بيئة متخلّفة تعيش صنوفا من التناقضات وتُعايِشها، قناعة منهم بأنهم الطليعة العلمية التي لن يكون إلا إليها انتشال أقوامهم مما هم فيه من انقلاب الأوضاع وتفاقمها؛ على الأقل من الناحيتيْن: السياسة والاقتصادية، بحسب الزعم... سمعتهم يكررون الكلام ذاته للمرة الـ...، وهم لا يملون منه، ولا يتصورون أن لأحد من السامعين الحق في التبرم والملل، مما يُعيدونه ويكررونه. هذا يعني أن الوثوقية لديهم قد بلغت مداها، الذي لا يزاحمهم عليه إلا من تحقّق حمقُه، وظهرت بين الناس علة عقله، لو أن الصحة العقلية في مجتمعاتنا كانت تسترعي عناية العقلاء حقيقة... صار المساكين في معرض انتقادهم لنظام الحكم في بلادهم، يذكرون الديمقراطية جيئة وذهابا، وهم يستطعمون مذاقها في أفواههم، كحال المصاب بالاضطرابات السلوكية القهرية، مع أنه يخالف في ذلك منطق الناس، ويثير حفيظة كل ناظر إليه حيثما كان. كل هذا، وهؤلاء الديمقراطيون يساريّون، أو سليلو اليسار المتلاشي؛ من دون تحقيق منهم للمواءمة بين الأمرين: الديمقراطية واليسار. فهل يُبنى فكر يساري معتبر على أصول ديمقراطية حقا؟... أم هل تقبل الديمقراطية أن يدخل عليها اليسار من جهة التنظير؟... أم إن ذلك لا يجوز إلا في بيئتنا المتخلّفة، التي تكاد تتبرأ فيها العقليات من كل ملة ونحلة، مع عدم قبولها بالانسلاخ عن واحدة منها حقيقة، ولو عندما تدعو الضرورة النفسية والاجتماعية إلى الاصطفاف "النافع"، في الأوقات المعلومة؟!... وحتى نعين هؤلاء المتصدّين لمهام الإمامة من دون تصدير أحد لهم، سنتناول بما يسمح به الوقت، بعض الأصول التي كان ينبغي لهم أن يُقدّموها في النظر:
وهذا لأن الجامعات في زماننا -بسبب ضعف الأساتذة المنهجي- تقبل كل بناء فكري، تُسوّغه المبادئ الشرقية أو الغربية، في أدنى لبوس لغوي يكاد يخرج عن أصول كل لغة أصيلة؛ فهو يميع بين الاصطلاحات المترجَمة، والقوالب العامية المتفاصحة؛ وهو ما يشهد لصاحبه بقليل من الإبداع الفردي، فيما لم يُسبق في الجهل إليه. بل لعل ذلك يكون في نظر أعين عشواء، مستوجبا لنيل درجة الشرف بعد أن تجرّد منه المتجرّدون عند مظانّه الأولى. ويكفي تحذيرا من الشطر المذموم من الفكر، قول الله تعالى: {إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ . فَقُتِلَ كَیۡفَ قَدَّرَ . ثُمَّ قُتِلَ كَیۡفَ قَدَّرَ . ثُمَّ نَظَرَ . ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ . ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ . فَقَالَ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرٌ یُؤۡثَرُ . إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ} [المدّثّر: 18-25]. وقد جاءت هذه الآيات المباركات في معرض الوعيد للعبد المستكبر عن عبادة ربه، الذي قدم له الله بوصفه في قوله سبحانه: {إِنَّهُۥ كَانَ لِـَٔایَـٰتِنَا عَنِیدًا . سَأُرۡهِقُهُۥ صَعُودًا} [المدثر: 16-17]؛ وهذا وصف للكافر الذي يعتمد في كفره فكره السقيم، حتى صار يعاند الوحي الإلهي ويُنكر المعجزات النبوية، بدعوى العقلانية؛ وحتى استحق من الله في البداية أن يُرهقه إرهاقا متزايدا، في سبيل إثبات فكره، الذي لا يلبث أن يتهاوى بين يديه، فيجد نفسه -خصوصا مع أترابه- مضطرا لإعادة البناء في كل مرة؛ وهذا من العقوبة الدنيوية المعجّلة بلا شك. أما العقاب الأخروي، فقد أجمله الله في قوله سبحانه: {سَأُصۡلِیهِ سَقَرَ . وَمَاۤ أَدۡرَىٰكَ مَا سَقَرُ . لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ . لَوَّاحَةٌ لِّلۡبَشَرِ . عَلَیۡهَا تِسۡعَةَ عَشَرَ} [المدثر: 26-30]. وسقر، هي المحل المتجمّد الذي يكون محل عذاب الجن خاصة. فإذا توعد الله صنفا من البشر بها، فلحِكَم منها: ا. أن المفكرين من البشر الضالين، يستعينون في فكرهم بالجن الذين هم أبرع منهم فيه. وفي هذا المعنى، جاء قول الله تعالى: {وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلۡإِنسِ یَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلۡجِنِّ فَزَادُوهُمۡ رَهَقًا} [الجن: 6]؛ وليلاحظ القارئ ورود لفظ "رهقا" مرة أخرى، للدلالة على صفة ناتجة عن هذا التعاون الخاص، بين الجن والإنس. ب. لأن عتاة الإنس يجاوزون في كفرهم، ما يكون عليه الكفار في العادة؛ فلهذا استحقوا عذابا، يكون في العادة للجن لا لهم؛ وهذا من باب التنكيل بهم، وإراءتهم عاقبة ما كانوا يظنونه تميّزا إيجابيا في الدنيا، وهو انمياز في العذاب لا غير... ولنعد الآن إلى الآيات التي يصف فيها الله المفكّرَ الضال: - يقول الله تعالى: {إِنَّهُۥ فَكَّرَ وَقَدَّرَ} [المدثر: 18]: ومعنى فكّر: أعمل فكره، بحسب كل منطق وكل نسق؛ وهذا على قدر حذق الناظر المسمّى ذكاءً. وهذا يعني أن من الذكاء ما يكون موصلا إلى الخير، ومنه ما يكون موصلا إلى الشر؛ على خلاف المظنون لدى العامة، من أن الذكاء محمود حيث كان. ولا يُعرف خير الفكر من شرّه بالفكر ذاته، لأن الشيء لا يُحال على نفسه؛ بل بمعيار أسمى منه وخارج عن دائرته، وليس إلا الوحي الإلهي. وأما "قدّر": فهو من التقدير الذي هو وزن المعاني بعضها إلى بعض، وقياس الفروع منها إلى كل أصل. ويُستعمل الفعل ذاته، في التقديرات التي تكون مآلاتها في الحس المعتاد، كما هو شأن عمل المهندسين والمصمّمين. ومن فهم كلامنا عن الذكاء، فإنه لن يفوته أنه سيكون من الصفات الملازمة لأئمة الضلال من كل عصر. ولو أردنا أن ندلل على ذلك من تاريخ أمتنا، فإنه تكفينا الإشارة إلى ابن تيمية وقبله إلى معاوية. وأما أهل عصرنا، فإننا سنترك تعرّفهم، لمن ظنّ أنه قد أدرك مرادنا... - ثم يقول سبحانه: {فَقُتِلَ كَیۡفَ قَدَّرَ} [المدثر: 19]، و"قُتِل" هنا فعل ذمّ، كفعل تعس وهلك؛ والمعنى أن ذلك المفكر الذي سيعوجّ به فكره، قُتل حال تقديره؛ لأنه لو كان يُحسن التقدير، لبان له ما هو عليه من اعوجاج؛ ولكن الله لم يأذن له في ذلك، فثبت في النظر السليم اعوجاجه، وإن كان هو يراه بخلاف كل ناظر. نعوذ بالله من سوء المـُنْقلَب... وكم من مطموسي البصائر القائلين بالديمقراطية وسواها من الآفات، من يرى ذلك علامة على اهتدائه، ويراه عملا بما اتضح في عينه من براهينه؛ وحاله في ذلك كحال الناظر إلى السراب الذي أخبر الله تعالى عنه بقوله تعالى: {وَٱلَّذِینَ كَفَرُوۤا۟ أَعۡمَـٰلُهُمۡ كَسَرَابِۭ بِقِیعَةٍ یَحۡسَبُهُ ٱلظَّمۡـَٔانُ مَاۤءً حَتَّىٰۤ إِذَا جَاۤءَهُۥ لَمۡ یَجِدۡهُ شَیۡـًٔا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُۥ فَوَفَّىٰهُ حِسَابَهُۥۗ وَٱللَّهُ سَرِیعُ ٱلۡحِسَابِ} [النور: 39]. ولا شك أن العمل العقلي للكافر، داخل في عموم مسمَّى عمله. نقول هذا، حتى لا ينحجب القاصرون بلفظ العمل، عن معناه الواسع المتجاوز للمحسوسات إلى عالم المعاني... - ثم يقول سبحانه: {ثُمَّ قُتِلَ كَیۡفَ قَدَّرَ} [المدثر: 20]. وتكرار اللفظ هو من جهةٍ، للتأكيد؛ والتأكيد من جهة أخرى، وسيلة إلى المبالغة في وصف سوء الحال؛ لعل سمع الكافر عندما يُقرع، يتنبّه لتقريعه القلب، فيعود صاحبه عن السقوط في قعر الهلاك... - ثم يقول سبحانه: {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: 21]؛ والمقصود بالنظر هنا ما يعرفه العقلاء من النظر العقلي، لا نظر البصر. وهذا، لأن الأبصار لا تكذب صاحبها عند نقلها للصور؛ بخلاف النظر العقلي الناشئ عن الفكر الظلماني، فإنه يَكْذِبه؛ فإذا صدّقه فيما كذبه فيه، ضلَّ: أي خرج عن سواء السبيل، إلى سبيل منحرف مما تقوم عليه الشياطين المتخصّصة بصنوف الإضلال... - ثم يقول سبحانه: {ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ} [المدثر: 22]: "عبس": لأنه استاء مما لاح له من أصل المعنى؛ و"بسر": تعجّل التحوّل عن المعنى الذي لاح له ولم يُعجبه، إلى ما يوافق هواه، فضلّ. وهذا يعني أن الله يقيم الحجة على عباده، في نظرهم العقلي، بإشهادهم لنتائج المعاني كما هي في أصلها، وهذا حتى لا يقول الكافر يوم القيامة: يا رب، أنا أعملت عقلي الذي وهبتَنيه، فإن كان لي من زلل فهو منه لا مني!... هناك ينطق العقل بإذن ربه من حقائقه، ويُخبره بأنه قد أبان له السبيليْن، ولكن الترجيح كان من هواه لا من العقل. ومن هنا، كان المخالف لهواه، معدودا من العقلاء عند العقلاء. وأما ما صرنا نراه في زماننا من تقمص للعقل من قِبَل السفهاء، فهو مخصوص بأحوال آخر الزمان، حيث تختل المعايير وتنقلب الموازين، إيذانا بامتلاء الأرض ظلما وجورا. وهذا، لأن الظلم والجور لا يكونان عن تعقل، وإنما عن خفّة في العقل وعن نزق... - ثم يقول سبحانه: {ثُمَّ أَدۡبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ} [المدثر: 23]. "أدبر" عن الحق بعد أن لاح له، وإدباره ذاك جعله مستكبرا؛ ولولا أنه شهد الحق بداية، ما صحت له هذه الصفة ولا صح له هذا الحال. ومن شاء أن يرى ذلك فيمن ذكرنا من الضالين، فليتتبع صفة الاستكبار التي تغشاهم عندما يُذكَّرون بالحق الذي منه فرّوا؛ حتى إن بعضهم قد يلجأ إلى العنف المادي بعد استنفاده للعنف اللفظي. وأما مراوغاتهم السافرة التي يركبونها في سبيل الحفاظ على باطلهم، فإنها تجعلهم مسخرة لكل ناظر حصيف... - ثم يقول سبحانه: {فَقَالَ إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا سِحۡرٌ یُؤۡثَرُ} [المدثر: 24]. وأما قوله "إن هذا إلا سحر"، فالمقصود منه السحر بالمعنى الفلسفي، الذي يجعله الفلاسفة في مقابل العقل الفلسفي؛ وليس المقصود منه السحر الذي يقع فيه تحريف الرسائل العصبية الحسيّة، أو بتّها. ويؤكّد هذا المعنى الفلسفي قوله "يؤثر": أي يُتناقل عبر الأجيال؛ والمراد منه، عدم التمحيص للموروث؛ وأما السحر الآخر، فيؤثر علمه لا عينه. والكافر يسعى دائما إلى أن يصف الوحي الإلهي بالصفات التي تنفر منها العقول المعتبرة؛ ولكنه في الحقيقة يزيد من تثبيت ضلاله في نفسه، وفي أنفس سامعيه فحسب. ولو أن الكافرين كانوا على علم صحيح بما يفعله بعضهم ببعض، لصاروا يتراجمون ويتنابزون من شدة سوء ما يفعلون. ولكن الله قد حجب بعض العقول، عما كشفه لغيرها، عندما لم يعلم منها إلا سوء الحال وقبح الفعال. وهو العليم بعباده، الحكيم في معاملته لهم سبحانه؛ {لَا یُسۡـَٔلُ عَمَّا یَفۡعَلُ وَهُمۡ یُسۡـَٔلُونَ} [الأنبياء: 23]... - ثم يقول سبحانه: {إِنۡ هَـٰذَاۤ إِلَّا قَوۡلُ ٱلۡبَشَرِ} [المدثر: 25]: يريد الكافر أن يخلص في نظره إلى الوحي الإلهي، إلى أنه قول البشر فحسب؛ بحيث لا يختلف عن أي قول لأي بشر عندئذ. وكأنه يبغي الخلوص من عذاب الآخرة المترتّب على حال كفره، ولكنه من شؤمه على نفسه، لا يزيد إلا في تمتين كفره في نفسه، ومن إقامة الحجة عليه. ولو كان الكافر على بعض العقل، ما عامل نفسه كما يُعامل العدو عدوه!... فسبحان من له في كل فعل آية، يزداد بها المؤمن إيمانا، ويزداد بها الكافر كفرا!... ولقد خرج من بني جلدتنا الذين ينطقون بألسنتنا، من يكفرون بالقرآن بين أظهرنا، ويقولون عنه: [إنه كتاب تاريخي، وليد ظروفه؛ وحتى إن كان يصلح للزمن الأول، فإنه حتما لا يصلح لكل زمان.]، سبحان الله!... {سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا یَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِیرًا} [الإسراء: 43]. وما يزال يخرج من هذا الصنف من يبغي تثبيت هذا الباطل، ولو من طرق ملتوية، يتظاهر فيها أنه ذابّ عن الحق العقلي، وأنه منصف في تناوله؛ وكأنه يريد أن يُقنع سامعيه بأنه لو وجد طريقا إلى تثبيت الحق الذي لديهم لفعل، ولكن عقله المحكَم بحسب زعمه، يأبى عليه ذلك. ولو شئنا أن نذكر بعض الأفراد من هذا الصنف في زماننا لفعلنا، ولكننا نستحيي من الله، ونرجو أن يعود أولئك المبطلون (أو بعضهم) إلى الحق بعد الضلال. والله غفور رحيم...
إن ما شاع في الأزمنة المتأخرة من اشتغال العوام من الناس بالسياسة، هو أمر مخالف لمنطق الأشياء، وحال طارئ لم يكن معهودا في الأقوام السابقين. ولا شك أن طروء ما يُخالف المنطق على الناس، لن يكون إلا سببا مباشرا إلى خلخلة الأوضاع، وإلى انقلاب الأحوال، لتحل الفوضى محل النظام، وتعقب الفتنة ما عرفه الناس من طمأنينة وانتظام... ولا شك أن الشريعة الإلهية، جاءت لتهدي الناس إلى ما تنصلح به أحوالهم، وتستقيم به أمورهم؛ من غير اشتراط لفهم أسباب ذلك على وجه التفصيل، ولا إدراك لأبعاده بحسب ما يؤول إليه من كل جهة، إما فيما يتعلّق بالدنيا أو فيما يكون من مناطات الآخرة. ونحن عندما نقول هذا، لا نقصد إلى الزهد في تحصيل ما يتعلق بالأمر من علوم ينبغي على فقهاء الدين أن يتبيّنوها، حتى يتمكنوا من تبيينها فيما بعد؛ وإنما نبغي التأكيد على الأصل في هذه المعاملة بين العباد وربهم، والذي ليس إلا الاتباع. ونعني من هذا، أن الاتباع وحده يضمن للناس بإذن ربهم، أن يبلغوا خيْرَيِ الدنيا والآخرة، بخلاف ما يذهب إليه أهل التنظير العقلاني من فقهاء وغيرهم. ولقد دخلَتْ على الفقهاء الذين كان ينبغي أن يبقَوا على الأصل، مختلِف التأسيسات العقلية، عندما غلب عليهم الفهم العقلي للدين، بدل الكشف الإيماني. وتأكّد هذا الانحراف منذ القرن الأول، ومع مرور الزمان، إلى أن صار النظر إلى الدين يكاد ينحصر فيما هو من قبيل التفلسف؛ خصوصا بعد ظهور علوم مستحدثة كعلم "أصول الفقه"، أو "علم الكلام". وبما أن الناس قد انفصلوا عن الأصل الذي كان عليه خواص الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووقعوا فيما ينشأ عن حجابية الزمان العقلية، فإنهم لم يتمكنوا من بناء المقارنات بين ما انتهى أمرهم إليه، وما كان ينبغي أن يكونوا عليه؛ فتفلت منهم ما كان يُرجى لهم أن يحصلوه من العلم الضروري بالدين، والذي هو وحده ما يمكّنهم بعد إذن الله من الترقي في المراتب الدينية المندرسة معالمها، وبالتالي من ولوج دوائر عقلية ما كان لهم أن يتصوروها وهم على تديّن منحرف... وإن من الأغلاط التي وقع فيها المتأخرون، والتي انبنت على سابقاتها من أغلاط أسلافهم، منح حق إبداء الرأي في كل شيء لكل أحد؛ من دون اعتبار للمكانة العلمية (بمعناها الأصلي)، ولا اعتبار للأهلية الشخصية للفرد المراد له أن يكون ذا رأي. وما نومئ إليه من شروط متأخرّة، قد انضافت إلى الشروط الأولى التاريخية، هو ما سيُعرَف في أزمنة انهيار المنظومة العقلية، بحرية التعبير عن الرأي؛ وكأن لكل فرد من الناس رأي ينبغي أن يُعتبر. ونحن هنا نحصر الكلام فيما هو عام، ومما ينعكس على العيش المشترك للجماعة، ولا نتجاوز إلى الدائرة الشخصية الفردية، التي لا شك أن لصاحبها الرأي فيما يعود إلى ما لا يتعدّى أموره الخاصة. ولكن المنظرين من مـُغرضي الأزمنة المتأخرة، والذين كانوا يبغون في البداية التنكر للدين، قد تعمدوا عدم التمييز في مجال إبداء الرأي، بين ما هو خاص وما هو عام؛ وبين ما هو معتبر وما هو غير معتبر؛ وذلك حتى يجعلوا كلمة المجتمع منقسمة، بدءًا من هذا المستوى الأوّلي. ولا شك أن كثيرا من الفتن ومن الحروب الأهلية التي عرفتها المجتمعات الإنسانية، بدعوى ما من الدعوات المختلفة، كانت تتأسس على هذا الخلط المتعمّد، وعلى عدم التمحيص العقلي الحق... وفي الوقت الذي كان يُرجى لفقهاء الإسلام تثبيت أصول الدين في مسألة إبداء الرأي، بحسب ما يُنتظر منهم أن يفعلوا، إن اعتبرنا وظائفهم الاجتماعية؛ فإنهم بدل ذلك قد ساروا على درب من لا دين لهم في المسألة، أو على الأقل صمتوا عن الكلام، عندما صارت المقولات والسياسات مجهولة المصدر والمنطلق، تقود مجتمعاتهم إلى الجاهلية الكبرى: جاهلية القرون المتأخرة. وهكذا مثلا، صار الناس في المغرب الإسلامي السنّي (بالمعنى الصحيح التام) يؤسسون آراءهم على مبادئ العلمانية كما غرستها فرنسا في تربة بلداننا المغاربية، أو على مبادئ الشيوعية الرافضة لكل تديّن من أصلها. ورغم هذه التناقضات السافرة، فإن أنظمة الحكم في بلداننا، قد أعطت لكل فريق الحق في عيش أيديولوجيته بكامل متطلّباتها؛ وضمنت (الأنظمة) لكل ناطق من كل فريق، أن ينطق بما يشاء بشرط المحافظة على ثوابت نظام الحكم؛ وكأن الغاية ليست هي المحافظة على الدين بداية ومن حيث الأصل. وذلك لأنه بالمحافظة على الدين، تتم المحافظة على كل مصالح العباد؛ من دون حاجة إلى التفريق، كما فعل بعض الأصوليّين (الكليات الخمس). ونحن، وبحسب المنطق الاحتلالي، كان يُراد لنا أن نسير على خطى بلدنا الأم (فرنسا)، ولو مع التأخر عن واقعها خطوة في التاريخ؛ في الحين الذي صار يُمنع علينا منعا كلّيّا، وبجميع الوسائل، أن نعود إلى خصوصياتنا كما هي عندنا، وكما عاشها أسلافنا. وهو من غير شك، إبقاء على القيد الاستعماري في أيدينا وأرجلنا، وإن تغنّى أقوامنا بالاستقلال في كل مناسبة من مناسباتهم. والأمر في هذا، بخلاف ما قد يفهمه بعض القاصرين منا، لا خيار لنا فيه؛ بل هو تبعية للنظام العالمي، قبل تبلور معالمه وبعد تبلورها، يُراد منها الكون على دجّالية عامة فضفاضة المعالم، في انتظار ظهور الدجال الأعور، الذي يُراد له أن يجد المجتمعات مـُعَدّة إعدادا متكاملا لأن تتبعه بمجرد الإعلان عن نفسه. ومن غير الخفي، أن العوام الذين أُقنعوا بأحقيتهم في إبداء الرأي فيما هو من الشؤون العامة، سيكونون أوثق الأركان التي سيقوم عليها نظامه. ومما سيعمل على سير المجتمعات في النفق المرسوم لها، تمسّك أولئك العوام بـ "حقوقهم" في إبداء آرائهم التي أُشربوها من قِبل المضلّلين إشرابا. وإنه من العبث مناقشة هذه المسألة مع العوام في هذه المرحلة، لأنهم لن يعوا ما يُلقى به إليهم، مع التأكيد على أن تعليمهم ما كان لينفعهم، وقد فات أوانه، منذ اللحظة التي وطئ المستعمر فيها بلداننا. وقد تأكّد الأمر بعد ذلك، مع نيل شعوبنا استقلالا صوريا، صارت معه هي المتبنّية لما يهدم دينها ويطمس حضارتها. فما أشدّه من انتكاس، وما أعظمها من مصيبة!... ولقد نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى خطر الاستماع لمن لا أهلية له، وبالتالي إلى خطر ما سينتج عن ذلك، في الحديث الشريف: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَواتٌ خَدَّاعاتٌ، يُصَدَّقُ فيها الْكاذِبُ وَيُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فيها الْخائِنُ وَيُخَوَّنُ فيها الْأَمينُ، وَيَنْطِقُ فيها الرُّوَيْبِضَةُ. قِيلَ: وَما الرُّوَيْبِضَةُ؟ قالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ (يتكلم) فِي أَمْرِ الْعامَّةِ.»[1]. ويظهر من ترتيب ألفاظ الحديث، أن الرويبضة لن يتكلم إلا بعد تهيئة الظروف له، وليست التهيئة إلا انقلاب المعايير في المجتمع: فبدل الصعود يحل النزول، وبدل التيامن في السلوكات الاجتماعية يحل التشامل؛ ولا أدل في اللفظ على التشامل في مجتمعاتنا، من لفظ اليسار الذي بدل أن يكون منبها للشعوب بحسب الزعم، قصد التساؤل عن المنطلقات والمآلات، فإنه قد صار لدى شطر منها دليلا على "التقدّميّة"، من دون تمحيص للمُتقدَّم إليه أو للمـُتَقدَّم فيه. وهكذا، صار يُنطق بين المسلمين بأشنع عبارات الكفر بالمقارنة إلى كل ما مر في التاريخ من عبارات؛ بل صار يُدعى إليها، ولا أحد يجرؤ على مواجهتها أو القيام لها؛ بدعوى حرية التعبير، التي ما هي في الحقيقة إلا حرية الرويبضة في العبث بدين الأمة وإيمانها... وإن الرويبضة الذي فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرجل التافه، لا يجهل الدين وحده؛ حتى يقول القائل: نُعلّمه أصول الدين، ثم نتركه يُكمل ما نذر نفسه له!... ولكنه يجهل الأصول العقلية أيضا؛ وذلك لأن مرتبته العقلية لا تكون إلا أسفل مرتبة، والتي هي مرتبة العقل الغرَزي المناسب لحيوانية الإنسان، لا لإنسانيته. لذلك فإن الرويبضة إن نطق، فلن يدل إلا على السفل، من دون تكلّف منه؛ وكأنها الجاذبية تفعل فيه فعلها. فإن سكت له من كانت له مـُسكة دين أو إيمان أو عقل، فإنه يكون كمن يسكت من بين المسافرين عبر البحر، لسفيه عنّ له أن يخرق السفينة التي يركبها معه. وهذا يعني أن النتيجة السيّئة لنُطق الرويبضة الذي سيكون متبوعا بالعمل في كثير من الأحيان، لن يوصل الناس إلا إلى قاع التسافل الذي لم يكن أسلافهم قد بلغوه بمجرد الابتداع في الدين، وبمجرد اتباع الأهواء فُرادى أو جماعات. وهذا القاع، هو ما يُطنطن الجاهلون بتوصيف أسبابه في برلماناتنا، وعلى صفحات جرائدنا ومواقعنا الإلكترونية؛ من دون أن يتنادى أشباه المؤمنين وأشباه العقلاء إلى إثبات الأصول التي لا يجوز التراجع عنها، وإلى تبيين المعالم التي لا ينبغي طمسها. وأما نتيجة هذا التسافل، فقد بدأنا بعيشها من الآن، في صور منها: - اعتبار الدين دلالة على التخلف لا على الترقي لدى المجتمعات، وهو أمر مخالف للبدَهيات!... - الدخول في البهيمية الصريحة، عند الدعوة إلى مجاوزة التفريق النوعي بين الذكور والإناث، وإلى فعل الشناعات من غير استقباح لها أو مجّ... - عبادة الشيطان إما بكيفية مباشرة، كما هي عليه الجماعات المعروفة بذلك؛ أو بكيفية غير مباشرة كما هي حال جلّ المجتمعات... - إلغاء الآخرة من الاعتبارات، إلى الحد الذي يبلغ السخرية من كل مَن يجرؤ على ذكرها، ولو في دائرة ضيّقة من الناس... وقد يختلط على بعض القاصرين ما نريده من وراء عباراتنا، فيتظاهر بموافقتنا، في مستوى يراه مؤيّدا لما هو عليه من انحطاط، فيقول: نعم نحن لسنا مع تعبير السفهاء عن آرائهم؛ بل نحن على العكس من ذلك نتبنّى العمل السياسي الحزبي أو شبه الحزبي، الذي يُؤطّر العمل السياسي، ويمنعه من عبث العابثين!... وقد يشتبه هذا القول على من لا أهلية له، فيعود إلى ما كان عليه من انحطاط، بطريقة أخرى فحسب؛ وأما القول الفصل في المسألة، فهو: ا. إن الأحزاب في نفسها مخالفة لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع السليم... ب. إن المنظرين للأحزاب، أو المترئّسين لعملها، لن يكونوا إلا من صنف السفهاء والمتسافلين بالنظر إلى المعايير العقلية المعتبرة؛ ولا فرق من هذا الوجه بين رئيس ومرؤوس، ولا بين تابع ومتبوع، ولا بين إسلاميّ وغير إسلامي... ج. إن الانقسام الحزبي، لن يبقى في مستواه الأول قط؛ بل لا بد أن يبلغ مزيدا من الانقسام، بحسب ما يُراد له من قِبل النخبة الحاكمة، وبالنظر إلى الخروج عن المبادئ عينها التي أسس لها الحزب جزئيّا. وهكذا، فإن النتيجة واحدة، وهي بلوغ المجتمع برمته إلى الدرك الأسفل من كل واجهاته المعدودة: والتي منها الواجهة التعليمية، والاقتصادية، والاجتماعية. ومع انهيار المجتمع بصورة شاملة، فليس لأحد الكلام عن مستقبل سياسي بله غيره؛ لأن الأمر سيصير وجوديّا بالنظر إلى ذلك المجتمع، ونعني بهذا: فإما أن يبقى ذلك المجتمع، وإما أن يزول؛ بحسب الشروط التاريخية التي هي من سنة الله في خلقه... وإنّ دعوتنا نحن إلى قطع الطريق على كل رويبضة في مجتمعه، لن يكون عملا على الحدّ من تعبير مَن له شيء يستحق أن يُقال؛ ولكن هي دعوة إلى الحد من النزْف الاجتماعي من جهة المعايير والقيم، قبل أي شيء آخر بعدها، كالخير والأخلاق وما يندرج تحت كل ذلك من أقوال وأفعال. وهذا كله -علم الناس أم لم يعلموا- هو من القيام للدعوة الدجّالية الحالقة في مجتمعاتنا، والتي تبغي القضاء على كل ذرة خير، وكل نية له؛ وهذا قبل أن يعم الله الناس بعذاب من عنده، يأتي على الغالبية الغالبة من أصحاب هذه النشأة الإنسانية...
ولسنا نعني بالمرجعية، إلا النموذج المقيس عليه في النظر السياسي، وهما نموذجان أصلهما واحد. فالنموذج الأول هو النموذج الإلهي الذي أسس له الوحي، والنموذج الثاني هو النظر العقلي المنفلت (لا المتحرر). ونعني من كلامنا هذا، أن السياسة في نطاقها الضيق، والمتعلق بالدولة حيثما كانت، ينبغي أن تكون مطابقة للنظام الإلهي الذي يسير عليه الكون عينه. وهذه المطابقة هي ما لم يهتدِ إليه إلا الخلفاء الربانيون الذين يأتي في مقدمتهم خلفاء الأنبياء وعلى رأسهم الخليفة الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم داود وسليمان. وأما آدم عليه السلام الذي كان أول مظهر للخلافة في الأرض، فإنه لم ينل إلا الخلافة الغيبية التي تكون للأغواث من هذه الأمة، ما دام مفهوم الدولة كان ما يزال بعد في رحم القدر؛ وذلك بخلاف داود وسليمان عليهما السلام اللذين حازا الخلافة الغيبية على الكون، ورئاسة الدولة المسماة اصطلاحا ملكا. يقول الله تعالى عن خلافة آدم عليه السلام: {وَإِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَـٰۤىِٕكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی ٱلۡأَرۡضِ خَلِیفَةً} [البقرة: 30]، ويقول سبحانه عن خلافة داود وسليمان: {یَـٰدَاوُۥدُ إِنَّا جَعَلۡنَـٰكَ خَلِیفَةً فِی ٱلۡأَرۡضِ فَٱحۡكُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلۡهَوَىٰ فَیُضِلَّكَ عَن سَبِیلِ ٱللَّهِۚ} [ص: 26]، ومعنى التكليف في الآية، الذي يتعلق به الأمر والنهي، عائد إلى رئاسة الدولة لا إلى الخلافة الغيبية؛ لأن رئاسة الدولة قد يكون الحكم فيها بالعدل الموافق للشريعة الإلهية، وقد يكون بالظلم الموافق للهوى. أما الخلافة الغيبية، فإن الخليفة فيها معصوم ومطلق اليد. وأما في حق سليمان عليه السلام، فقد قال الله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَیۡمَـٰنُ دَاوُۥدَۖ} [النمل: 16]؛ أي ورثه في الخلافتيْن. وأما الخلافة المحمدية العظمى، فهي ثابتة بثبوت كل خلافة، لأن الخليفة الغيبي لا يكون خليفة إلا عن الحقيقة المحمدية المتجلي بها الاسم "الله". ومن لم يفهم الخلافة على المعنى الذي نذكر، فإنه لم يشم لها رائحة، لا من الحقيقة ولا من الشريعة... ويأتي بعد الخلفاء من الأنبياء، الخلفاء من الورثة، الذين يأتي في مقدمتهم الخلفاء الخمسة المعروفون للمسلمين، ممن جمع الله لهم بين الخلافتيْن، إلى تمام الاثني عشر رجلا الذين جاء فيهم على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً.»[2]. وأما الخلفاء الغيبيون المنوطة بهم الخلافة الغيبية وحدها، فعددهم أكبر؛ لأنهم لا يخلو منهم زمان من الأزمنة التي يكون فيها الملك (خلافة الظاهر النصفية) للسلاطين والملوك في مقابلهم. وفي حال افتراق الخلافتيْن، فإن خلافة الظاهر تكون تحت حكم خلافة الغيب، ما دام التكليف مندرجا في المعنى القدري الشامل والمطلق. وعلى خلاف ما يتوهّم العامة من الفقهاء، فإن الخلافة الغيبية ليس من شرطها أن تُعلم، لا في حال جمع الخليفة بين الخلافتيْن، ولا في حال افتراقهما. فعموم الناس -مثلا- لم يكونوا يعلمون من خلافة أبي بكر عليه السلام إلا معنى الملك، وأما معنى الخلافة الغيبية فلم يكن يعلمه إلا خواص الأمة من ذلك الزمان وإلى الآن. ولو كان "علماء" الشيعة -مثلا- يعلمون معنى الخلافة الغيبية، ما أنكروا خلافة أبي بكر التي هي بمعنى الملك؛ لأن هذه من تلك في حقه، وحق أمثاله من الخلفاء الجامعين عليهم السلام أجمعين. فهذا النموذج من الخلافة، هو ما ذكرنا عنه أنه يكون على النموذج الإلهي الأول. ومعنى أن يكون هكذا في الحقيقة، هو أن تدبير الكون من جهة إجماله ومن جهة تفصيله، يكون لله وحده، وإن كانت المظاهر الإلهية تختلف من واحد إلى آخر. وإلى هذا المعنى الجامع، يعود معنى خلافة الظاهر التكليفية؛ لأنه يكون مطابقا للتدبير الإلهي من جهة التكليف التشريعي. وهذا، لا يعني أن خليفة الظاهر، يكون حكمه مطابقا لأحكام الشريعة دائما؛ وإنما يعني أنه مسؤول في حكمه من قِبل الله عمّا حكم به. وأما عند مخالفة الحاكم للشريعة، فإنه حتما يكون موافقا للحكم القدري الذي يحكم الخليفة الغيبي به، والذي لا يُسأل فيه عمّا يفعل. وحكم الحاكم إن كان خليفة بمعنى ما (وإن كان عاصيا وظالما)، فإنه كله يندرج تحت النموذج الأول من نماذج الحكم. وأما النموذج الثاني، فهو كل حكم لكل حاكم، مما خولفت فيه أحكام الشريعة، بغض النظر عن كون الحاكم مؤمنا أم كافرا. وهذا النموذج من الحكم جعلناه ثانيا، لأن صاحبه يتوهّم أنه يحكم بحسب مشيئته، لا بحسب قدر الله ولا شريعته. وقد دلّنا الله في كلامه على هذا الصنف من الحكم، عندما كشف لنا عن حال بعض المتجبرين من الحكام، كما في قوله تعالى: {وَنَادَىٰ فِرۡعَوۡنُ فِی قَوۡمِهِۦ قَالَ یَـٰقَوۡمِ أَلَیۡسَ لِی مُلۡكُ مِصۡرَ وَهَـٰذِهِ ٱلۡأَنۡهَـٰرُ تَجۡرِی مِن تَحۡتِیۤۚ أَفَلَا تُبۡصِرُونَ} [الزخرف: 51]، أو في قوله سبحانه على لسان النمرود: {قَالَ أَنَا۠ أُحۡیِۦ وَأُمِیتُۖ} [البقرة: 258]، وهو المعنى الذي قصده فرعون بعبارة "ملك مصر" ذاته. وما أنكر الله على المتجبّرين كونهم يملكون أو كونهم يحيون ويميتون، كما قد يفهم أهل الشرك من الفقهاء ومن العامة، وإنما أنكر عليهم نسبة ذلك الفعل منهم إلى أنفسهم على وجه الاستقلال. وهذا المعنى الكفري، هو ما ينصرف إليه فهم جل الحكام وجل المحكومين في الأزمنة المتأخرة، بسبب طغيان الظلمة وعموم الحجاب الطبيعي؛ وهذا فيما يعود إلى أحوال المسلمين أنفسهم، حتى لو عدنا إلى تعريف الحكم عند المتسلّفة وعند الجماعات الإخوانية مثلا، لوجدناه يعود إلى ذلك المعنى الكفري (الشركي) الذي أنكره الله تعالى في كلامه العزيز. وهذا يعني أن النموذج الثاني من الحكم، هو أقصى ما يُدرَك للعقول في هذه الأزمنة؛ ولن يعود الناس إلى المعنى الصحيح (النموذج الأول) من الحكم، إلا مع المهدي عليه السلام، الذي سيجمع الله له بين خلافتَي الغيب والشهادة، على أعلى ما يكون الجمع... وإن عدم التفريق بين مختلف معاني الحكم، أو تعمّد قصر معناه على ما تُعطيه التنظيرات السياسية مختلفة المشارب، لا يكون إلا من جملة التلبيس الذي تعتمده شياطين الجن والإنس. ولقد بلغ الأمر من السوء مبلغا، لم يعد علماء المسلمين يقوَوْن معه على مخالفة الكفر الجلي الذي تطفح به التعريفات والمصطلحات السياسية المفروضة على مستضعفي العالم فرضا بقوة الحديد والنار. ومن أصول الكفر فيما يتعلّق بأمور الحكم في أزمنتنا: ا. فصل كل شؤون الحكم، عن أي معنى ديني؛ سواء تعلّق الأمر بجانب الحقيقة أم بجانب الشريعة. وهذا من ضرورات التمهيد لحكم الدجّال بحسب ما يتمناه هو أو أتباعه... ب. القول في الحكم بالتعدّدية: في أصل التنظيرات السياسية المختلفة التي هي من الواقع الذي لا يمكن لأي عاقل إنكاره؛ أو تحت نظام الحكم الواحد الذي لا بد أن يكون ديمقراطيا في هذه الحال. وتحت النظام الديمقراطي، يكون اختلاف الآراء السياسية مقبولا من جهة التنظير، وإن لم يتسع له العمل في الحكم، ما دام الفعل السياسي في الوقت ومن الوجه نفسه، لا بد أن يكون واحدا وغير متعدّد. ورغم أنه كان ينبغي التأسيس للحكم بحسب النموذج الثاني، من جهة الفكر السياسي والفلسفي عموما، فإنه قُفز على ذلك كله، وكأن القول به هو من البدهيات العقلية، وهيهات!... وإن التعدد الذي يتمسك به المنظّرون، ليس من باب إيتاء كل ذي حق حقه كما قد يتوهم القُصَّر؛ لأن هذا المعنى تحفظه الشريعة الإلهية قبل سواها؛ ولكنه من باب التأسيس للشرك، عند إعادة كل قول إلى قائل منفصل انفصالا تاما، عن غيره من القائلين. ونعني من هذا، أن القائلين سيكونون آلهة بالمعنى القديم للوثنية التي عرف التاريخ نماذج لها لا تُنكر... وأما التعدد تحت مظلّة الشريعة الإلهية، فهو مؤكِّد لمعنى التوحيد الأصلي؛ وهو شرط الفعل الشورَوِيّ المؤسَّس له في ديننا، بخلاف ما يفهمه المغرضون من الحكم الشرعي، أو ما يجعلونه أساسا لتنفير الناس من الدين. وقد قال الله تعالى في معنى الشورى: {فَبِمَا رَحۡمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمۡۖ وَلَوۡ كُنتَ فَظًّا غَلِیظَ ٱلۡقَلۡبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنۡ حَوۡلِكَۖ فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ وَشَاوِرۡهُمۡ فِی ٱلۡأَمۡرِۖ} [آل عمران: 159]، وهذا الخطاب متوجِّه إلى كل حاكم من حكام المسلمين، خليفة كان أم سلطانا ملِكا. ويقول سبحانه أيضا: {وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَیۡنَهُمۡ} [الشورى: 38]، وجعل هذه الشورى وصفا لازما للمؤمنين المقيمين للصلاة والمؤتين للزكاة؛ وهو خطاب أعم من الخطاب الأول الواردة به الآية من سورة آل عمران. ولا تعددية أعم من تعددية منوطة بعموم الناس من المحكومين، لكنها مقيّدة باندراجها تحت الأصول الشرعية العامة؛ لا بالمعنى الذي يجعلها تقبل المقولات الكفرية والشركية المنحطّة ضمنها. وكل تعددية يُراد منها الانفتاح على الكفر، فإنها تعددية مغشوشة مفضية إلى الحكم بحسب أصول الكفر فحسب. وهذا، لأن الحكم بالشريعة يلتغي تلقائيا، بمجرد دخول بعض أحكام الكفر عليه. والأمر في هذا عائد بالضرورة بحكم الله على مختلف الأمور، والذي قال فيه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنا أَغْنَى الشُّرَكاءِ عَنِ الشِّرْكِ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أشْرَكَ فيه مَعِي غيرِي، تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ!...»[3]. وهذا الأصل الأصيل في الأحكام الشرعية، قد أُهمل من قبل الفقهاء القاصرين، فدخلت الأمة بإهماله في دائرة الشرك ولو جزئيا ووقتيّا، وقبلت بذلك المقولات الشركية الدخيلة، إن انبرى أشباه المفكرين للانتصار لها، من باب التقليد الأعمى للأيديولوجيات الشرقية أو الغربية... وكما قد عجز المنظّرون للحكم، بمختلف صنوفهم، عن التأسيس النظري المتين، الذي يُمكن أن يُتّخذ أساسا لأي حكم عند النظر إليه وتقييمه؛ فكذلك عجز مفسّرو التاريخ عن قراءة مختلف الأحداث التاريخية العائدة بالضرورة إلى حكم الحكام في جميع الحقب والأعصار، وعن التفسير المثبت لأي نموذج من نموذجَيِ الحكم اللذيْن أثبتناهما في سابق كلامنا؛ باستثناء ما يكون من التفسير الديني الذي يكون لليهود والمسلمين خاصة، وعلى قصور غير قليل، في إبراز معالم أحد النموذجيْن، بإحدى صورتَيْه: الحقيقية أو الشرعية. وهكذا بقي التاريخ في نظر أهل الأهواء، قابلا للتفسير بحسب تلك الأهواء؛ من دون أن يتصدّى لتلك الصور الباهتة علماء بالتاريخ، يجدر بنا أن ننصت إليهم، ويجدر بهم أن يتبيّنوا معالم الربط بين الأحداث والأقدار من جهة، أو بين الأحداث والتشريعات الإلهية من جهة أخرى؛ أي لإبراز الجانب المعرفيّ من التاريخ. وبسبب ضعف العلم بالتاريخ، المنضاف إلى الجهل بأحكام الحكم، توهّم الجاهلون من أبناء المسلمين -بله سواهم من الأمم الأخرى- أن مجال الحكم يعود إلى ما يتوصل إليه الناظرون بنظرهم، وإن كانوا من قاصري العقول وسفهاء الأحلام؛ وذلك كما هو شأن الساسة في أمتنا اليوم، من متحزبين وبرلمانيّين مستقلّين وغيرهم. فحق علينا قول الله تعالى الذي ذكره لنا عن حال الكتابيّين قبلنا: {قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِی هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِی هُوَ خَیۡرٌۚ ٱهۡبِطُوا۟ مِصۡرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡتُمۡۗ وَضُرِبَتۡ عَلَیۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَاۤءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِۗ ذَ ٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُوا۟ یَكۡفُرُونَ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ وَیَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِیِّـۧنَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّۗ ذَ ٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ یَعۡتَدُونَ} [البقرة: 61]. ولنتوقف قليلا عند هذه العبارات الإلهية الحاكمة على كل الأزمان: - قول الله تعالى: {قَالَ أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِی هُوَ أَدۡنَىٰ بِٱلَّذِی هُوَ خَیۡرٌۚ}: واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، يقع عندما ينسلخ العباد عن النسبة الإلهية، ويعودون بدلها إلى النسبة البشرية. ولو أنهم تأملوا قليلا، لعرفوا أن النسبة البشرية لا تثبت بنفسها، وإنما تثبت بإثبات الله؛ أي بثبوت النسبة الإلهية قبلها. والمثل في ذلك، كمن يُنكر وجود الله، ويُثبت وجود العالم الذي تكون نفسه من بين أفراده: فهو لا يعلم أن العالم لا يثبت بنفسه، وإنما باستناده إلى وجود الحق قبله. والعمل على الأصل في الأمور يكون أعلى في الاعتبار دائما... - وقوله سبحانه: {ٱهۡبِطُوا۟ مِصۡرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلۡتُمۡۗ}: المقصود هنا: اهبطوا إلى النسبة العدمية التي اخترتم لأنفسكم، جهلا منكم بالحقائق، فإن لكم ما سألتم مما يُناسب ضعف إدراككم. ولكن فلتعلموا أن تلك النسبة ستجر عليكم تبعاتها العدمية المناسبة لها. وهي ما يذكره الله تعالى فيما يأتي: - وهو قوله سبحانه: {وَضُرِبَتۡ عَلَیۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلۡمَسۡكَنَةُ وَبَاۤءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِۗ}: أي ضربت عليهم الذلة، لأنهم نزلوا إلى الأرض، والأرض محل الذلة؛ وضربت عليهم المسكنة التي هي أقصى الفقر، لكون البشرية فقيرة من جميع جهاتها ولا قدم لها في الغنى البتة من حيث أصلها. وأما الاغتناء الذي يهبه الله لمن عاد إلى ربه وتوكّل عليه، فهو بإغناء الله لعباده من باب المنة العامة، أو من باب الجزاء؛ ولا يثبت لحظة من غير ذلك، وإن توهّم المتوهِّمون. وأما قول الله تعالى: "وباءوا بغضب من الله"، وهو إجمال لوصف حالهم، فلأنهم عكسوا الأمر عندما فضلوا السفل على العلو. ومِن تفضيل السفل على العلو في أزمنتنا: تفضيل الفكر البشري على التشريع الإلهي؛ وحيث كان هذا التفضيل المعكوس، يجلب غضب الله تعالى، بسبب الارتباط الجدلي بين الأمريْن. ومن تأمل أحوال الناس، عرف ذلك بأقل نظر... - وقوله سبحانه: {ذَ ٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُوا۟ یَكۡفُرُونَ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ وَیَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِیِّـۧنَ بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّۗ}: أي ذلك العقاب كله، حل بهم، لأنهم بفعلهم ذاك قد وقعوا في فعل الكفر الذي هو ستر الألوهية بما هو من أوصاف البشرية. والآيات، هي كل الأفعال الإلهية التفصيلية، الدالة على عودتها إلى الألوهية الجامعة حتما. وأما قتلهم للنبيئين بغير الحق، فهو من المبالغة في كفرهم؛ لأن الأنبياء لم يزيدوا على تذكيرهم بحقيقة الأمور، بالإضافة إلى أنهم أقروا ببشريتهم ولم يدّعوا ربوبية لأنفسهم. فلو أن أولئك المنكوسين كانوا منصفين، لعلموا أن الأنبياء لم يستحق فعلهم الحكم عليهم بالقتل؛ ولكن المجاوزة الأولى التي أعطتهم الكفر، قد تولّدت عنها مجاوزة أخرى وهي قتل البرآء الأطهار من هذا الجنس البشري. وإن نحن تأملنا أحوال الكافرين بحسب هذا المعنى العام الذي للكفر، واعتبرنا قبولهم لعبادة العباد المتجبّرين من أمثالهم في العبودية القهرية، مع ثبوت فرار الأنبياء الأطهار عليهم السلام منها في كل شؤونهم وأحوالهم، لعلمنا أن الكافرين يأبَوْن الخضوع لجلال الله، استكبارا من أنفسهم، المستند إلى ربوبية أنفسهم المضمرة فيها؛ لا من إباية الترفع عن الذّلّة كلها؛ وهذا لأن تذللهم للمتجبّرين المستعبدين لهم بالباطل، ثابت من أحوالهم وأقوالهم. ومن أراد أن يتبيّن أحوال المتربِّبين من العباد، وأحوال المستعبَدين، فما عليه إلا أن يعود إلى وصف الله للفريقيْن في كتابه الكريم، لأنه لا أبلغ منه في وصفهم. وأما هذا المقال، فإنه لا يتسع لذلك التفصيل كله... - ثم قوله سبحانه: {ذَ ٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ یَعۡتَدُونَ}: وهو تلخيص مجمل أمرهم فيما ذكرنا من أصل الكفر، وفيما تفرع عنه من ظلم وعدوان من جهة الفعل. والربط بين الأصول والفروع في المسائل العلمية، ضروري لتبيّن العلاقات، ومن بعدها لتبيّن الأحكام المبينة لمرتبة تلك العلاقات، ولمكانة كل واحدة منها ضمن المجموع. ولسنا نعني بالربط هنا، ما يتوهمه أهل النظر من ذلك؛ وإنما نعني ما يكون عن كشف إلهي، لينجلي على ضوئه الوحي الإلهي كما هو في نفسه. وهذا علم لا يكون على التحقيق إلا للأنبياء عليهم السلام ثم للورثة!... ج. مرتبة الفكر السياسي البشري: هذا السؤال: ما مرتبة الفكر السياسي البشري في العلم؟ هو مما يُغفله المؤمنون والكافرون جميعا. ونحن نقول في الجواب عنه: إن التنظير البشري السياسي ذاته، هو من فعل الله القدري، ما دام كل فعل في الوجود هو لله بالأصالة. لكن هذا الفعل لا يُنسب إلى الله بظاهر القول، حتى لا يختلط حكمه بالحكم الشرعي المأمور به؛ وذلك لأن بعض الناس تختلط عليهم الأمور، إن اختلطت عليهم النِّسب. ولهذا وجب التفريق، مع الإبقاء على الأصل العلمي حاضرا في القلب... وأما ذكر الله تعالى لكونه الفاعل الأوحد في العالم (الكون)، فقد ورد في مثل قوله سبحانه: {وَمَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِیعًا قَبۡضَتُهُۥ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ وَٱلسَّمَـٰوَ ٰتُ مَطۡوِیَّـٰتُۢ بِیَمِینِهِۦۚ سُبۡحَـٰنَهُۥ وَتَعَـٰلَىٰ عَمَّا یُشۡرِكُونَ} [الزمر: 67]؛ والمعنى أنه هو الفاعل وحده في السموات والأرض، لكل فعل يُنسب إليه؛ مما لا يجوز نسبته إلى العباد، كالخلق، والإحياء، والإماتة، والرزق، وغير ذلك... ولكل فعل من كل مظهر لكل فاعل من المخلوقين، مما يُنسب في العادة إليهم؛ وذلك كالأكل، والشرب، والتناسل وغير ذلك... وتحت هذه العبارات أسرار أُخرى، لا تجوز إماطة اللثام عنها لغير أهلها... ويظهر من هذا الذي ذكرناه كله، أن كل أنظمة الحكم، وإن كانت مختلفة فيما بينها، هي من قدر الله وحُكْمه؛ وهي إن كانت كذلك، فإنها لا تخلو من حِكم في طيّها، يمتنع على المخلوقين الإحاطة بها، مهما بلغت مكانتهم في العلم. ولولا مخافة التشويش على عقائد المسلمين، لأبدينا بعضا من الأسرار الإلهية المـُضمَّنة في أشد الأنظمة كفرا في ظاهر الأمر، بما يُعيدها توحيدا خالصا، كما هو الأمر في أصله. وهذا الذي ننبه إليه، هو من أدلة التوحيد المبثوثة في كل تفاصيل العالم، وإن غابت عن العقول المحجوبة المسمّى أصحابها اصطلاحا: كافرين ومشركين. وليحذر القارئ من التسوية بين أنظمة الكفر والنظام الإسلامي الشرعي، لأن التفريق في الآخرة الذي يكون بين أهل السعادة وأهل الشقاء، ينبني على التفريق في ذلك بحسب ما تُعطي الشريعة. ولعلنا سنعود إلى تفصيل بعض ما أجملناه في هذا الفصل، في كل مرة من وجه مخصوص في الفصول الأخرى؛ حتى يزداد المؤمنون إيمانا مع إيمانهم، كما أخبر الله في قوله تعالى: {لِیَزۡدَادُوۤا۟ إِیمَـٰنًا مَّعَ إِیمَـٰنِهِمۡۗ} [الفتح: 4]... والحمد لله رب العالمين... [1] . أخرجه ابن ماجة وأحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه. [2] . متفق عليه، عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. [3] . متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.