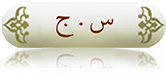اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 |  «السابقالتالي»
2025/12/02 رحلتي إليّ (إلى التسميم الثاني) -8- إلى التسميم الثاني
بعد أيام قليلة من شروعي في الذكر المأذون، أكرمني الله بمشاهدة شيخي حمزة بن العباس، يقظة؛ وذلك قبل أن ألتقيه في أول زيارة. شاهدت غرفة لها بابان متقابلان: أحدهما دخلت منه أنا، والآخر دخل منه الشيخ رضي الله عنه؛ وكانت جدران الغرفة بلون بنّيّ. لم تكن تلك الغرفة إلا ما كان يُسمّى في الزاوية "صالة النقش"، التي عرفتها فيما بعد من الأيام، وعندما صرت أزور شيخي زيارة "شبحية"، بعبارة الصوفية... عندما دخل الشيخ من الباب الذي يخصه، كان برفقته جماعة من الفقراء، حوالي السبعة من جهة العدد. وبمجرّد أن وقع بصر الشيخ عليّ، وأنا داخل من الجهة المقابلة، أشار بنظره إلى أحد مرافقيه، من دون كلام لفظي؛ ففهم ذلك الشخص أنه مطالب بإحضار السكّين، وفهمت أنا بأن الشيخ عازم على ذبحي، فأسرعت إلى الاستلقاء بين يديه مستسلما، وأنا أمد عنقي، كما تكون الشاة. وعندما حضر الفقير بالسكّين، تناولها الشيخ بيده الشريفة، ووضع أصبعَيْه الشريفتيْن من اليد الأخرى: السبابة والإبهام، على عنقي؛ ومرّر السكين عليها بحركة واحدة. فوجدت لموضع أُصبعيْه الشريفتيْن على عنقي، لذّة حسيّة، لا أتمكّن من وصفها؛ غير أنني أشبهها في الذوق اللساني بحلاوة العسل. فعجبت من لذة أجدها على جلدي، لم أعهدها منه طيلة ما سبق من عمري... عدت إلى إحساسي، وأنا فرح مسرور بما عرّفَنيه ربي من دلائل النبوة، التي زادتني يقينا بأنني على الصراط المستقيم الذي لا شبُهة فيه. وهذا لأنني ما كنت أقصد باتباع الشيخ في الطريق، إلا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ وقد كان هذا مما خصّني الله به من فهم، كان كثير من الفقراء بحسب الظاهر، على خلافه. وبما أنني كنت حديث العهد بالطريق من جهة النسبة إلى الشيخ، فقد ظننت أنا، أن كل من سبقني من الفقراء، كان قد شاهد أضعاف ما شاهدته أنا، فداخلني تعظيم لهم، من قبل أن يُؤذن لي بمجالستهم. وهذا، لأنني قد عرفت من صاحبي (م. ز) فيما بعد، بأن مقدَّم الطريقة (النقيب)، كان ما يزال يخشى على الفقراء منّي، وأنا الآتي من جماعة إخوانية... وصل خبر مشاهدتي، إلى النقيب، وإلى بعض المقرّبين منه؛ لأنني علمت في أثناء أوّل زيارة لي إلى مداغ، القرية التي كان يقطنها شيخي ويتخذها مقرّا لزاويته العامرة، أن الشيخ قد أُخبر بما وقع لي من الحال ومن المشاهدة، فنُقِل إليّ أنه قال لمن أخبره: - قولوا له: هنيئا لك!... سمعت أنا رسالة الشيخ إلي، فازددت تعظيما للفقراء الذين ظننتهم يسكتون عمّا لم أبلغه أنا بعد. وقد نفعني ذلك التعظيم في كل المدة التي أتت فيما بعد من طور تربيتي ذاك. وكان قد وقع لي أيضا في بداية أمري، أنني كنت جالسا وأنا أذكر، فصرت أعلم تقابل الصفات الإلهية، وأعلم أن ذلك التقابل، يُشير إلى فنائها في الذات. فظننت أن هذه العلوم أيضا، هي مما يشيع بين الفقراء، فذكرت ذلك لصاحبي الذي كان ما يزال هو صلتي الوحيدة بجماعة الفقراء بجرادة. ذكرتها له وأنا عنده في بيته، حيث كان قد قدّم لي الكرسي الوحيد الذي بإحدى غرف بيته، وبقي هو جالسا قبالتي على الأرض. كان يُنصت إليّ باهتمام شديد وأنا أحدثه عن الصفات والأسماء والذات؛ وقد كنت أتحرّى الضبط في عباراتي، مخافة أن أُخطئ أمام من هو أسبق منّي في الطريق، وبالتالي من لا أشك في أنه يعلم من علوم الطريق ما لا أعلم؛ ولكنه فاجأني بعد انتهائي من الكلام، وأنا أنتظر ردّه، بقوله: - لم أفهم شيئا مما قلت!... رأيت الصدق على وجهه، لذلك سكتّ، وعلمت أن الأمر على غير ما كنت أظنّ، يخصّني أنا وحدي. وهو الأمر الذي تأكّد لي مع مرور الأيّام والأعوام تحت نظر شيخي، بل وهو ما أعلم الآن أنه كان سيرا خاصّا، لم يُشاركني فيه أحد من إخواني في الطريق. عندما علمت ذلك وقتها، بدأت أكتم ما أجده عن كل من حولي، خصوصا عندما عاملني الشيخ رضي الله عنه في زياراتي الأولى له، معاملة لم يكن بها أي تمييز لي...
***
في العطلة الصيفية من سنتي الأولى في الطريق، ذهبت في سياحة دينية رفقة زميلي في الدراسة (م. أبـ...) الذي كان ما يزال يعمل أستاذا في المرحلة الإعدادية من التعليم بمدينة العيون الشرقية، والذي كان قد التحق قريبا بجماعة العدل والإحسان. لا أذكر الآن تفاصيل ما حدث، غير أنني كنت قد التقيت به وأخبرته بالتحاقي بالزاوية البودشيشية، فاقترح عليّ بعد أن علم رغبتي في زيارة بعض المتصدّرين للتربية بالمغرب، أن أزور معه الأستاذ عبد السلام ياسين، وأن يزور هو معي شيخي عند عودتنا، حتى يتبع كلانا أجدر واحد نُجمِع على أهليته للتربية، بحسب ما سيظهر لنا مما يسوقه إلينا ربّنا من آيات؛ فإنه سبحانه لا يبخل (تعالى وحاشاه) عن مدّ عباده بما يُعينهم على تبيّن طريقهم، ما لم يكونوا غاشّين لأنفسهم... كنت أنا بعد أن رأيت العجب مع شيخنا حمزة رضي الله عنه، أتطلّع لأن أعرف ما الذي يحوزه غيره من المتشيّخين في المغرب؛ فلربّما كانوا جميعا على القدر نفسه من المكانة، أو على قدر متقارب: فإما سأنصرف عن شيخي عندئذ إلى مَن يظهر لي أنه أعلى منه قدما في الطريق، على بيّنة ونور؛ وإما سأعود إليه متوجّها إليه بكلّيّتي، ملتصقا بنعله في دنياي وآخرتي. لم يكن من عادتي هذا التمحيص للأمور، لأنني في معاملتي أكون أقرب إلى السذاجة والتصديق؛ ولكنني كنت أعلم أن الأمر يتطلب إلقاء بنفسي إلقاء تاما إلى شيخي، لا عودة عنه أبدا، فأحببت أن يطمئن قلبي على مذهب إمامنا إبراهيم عليه السلام. أقول هذا، لأنني علمت بعد سنين طويلة من وقت بدايتي، بأنّ الله قد رزقني السلوك على قدم جميع الأنبياء عليهم السلام، من ذات نبيّنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشريفة؛ وعلمت أن ذلك كان منذ دخولي في صحبة شيخي رضي الله عنه، وبكيفية لم أكن أتبيّنها آنئذ ولا خطرت ببال العبد الفقير... ذهبت أنا ورفيقي في الرحلة، إلى مدينة فاس أولا، حيث بتنا ليلة عند جماعة عبد السلام ياسين، في بيت أظنه كان لأحد القيّاديّين. كان ممن التقينا بعد العصر (ع. العـ)، و(م. الر)؛ ولكنه لم يبق معنا للمبيت إلا (م. الر) وزمرة من إخوانه. فصلّينا ما شاء الله لنا معهم، من التهجّد، وبقيت أنا و"الأمير" صاحييْن إلى أن حلّ وقت الفجر. أما أنا، فكان ما أعانيه من أوجاع تعم جسمي كلّه، يحول دون نومي؛ وأما الأمير الذي كان بجانبي، فقد اضطجع على شقّه الأيمن، وهو يغفو تارة ويصحو تارة. وفي الصباح، انطلقت مع رفيق رحلتي إلى مدينة طنجة... في مدينة طنجة، قصدنا توّاً إلى زيارة شيخ الطريقة الدرقاوية وأحد أبرز علماء المغرب العاملين: الشيخ عبد الله التليدي رحمه الله، الذي كنت قد سمعت عنه وأنا بعد في جماعة الطلائع. وجدنا الرجل عالماً جليلا، يشع وجهه الشريف نورا، ويسبق تواضعه إلى كلّ من يأتي إليه... كان الشيخ التليدي رحمه الله، لا يجلس إلى طعام من ليل أو نهار إلا ونحن معه؛ يؤاكلنا على مائدته المتواضعة النيّرة. غير أنني لاحظت أنه لم ينظر إليّ قطّ ونحن على المائدة، فقد كان يوجّه الكلام إلى صديقي؛ إلا عندما أخبرته -بعد سؤاله لنا- بأنني أنتسب إلى الشيخ حمزة، فاختطف نظرة عابرة إليّ. وقد كنت أنا أتعجّب لذلك بعض التعجّب، لكنّني كنت أفهم من جهة غيبي، أن إحاطة شيخي، كانت تمنعه من أن يملأ عينه منّي... كنّا نصلي خلف الشيخ جميع الصلوات، مع ثلّة من طلبة العلم الشرعي الذي كان يُدرّسه بزاويته العامرة، مع جماعة من الفقراء الدرقاويّين أيضا، الذين صادفنا مجيئهم إلى الشيخ بقصد الزيارة. وكنت أنا على عادتي رادارا، ألتقط ما يجود به عليّ الحسّ وما يتنزّل به المعنى من كل أحد أو شيء. لم يكن صاحبي الذي يرافقني، على علم بالخاصية التي وهَبَنيها الله؛ وأنا على عادتي مع كل من أرافق، كنت أقدّمه وأتواضع له حقيقة لا تصنّعا. ومن فضل الله عليّ، أن كل من كنت أخالطهم، كانوا لا يرونني إلا أقل شأنا منهم؛ وكنت أنا أجد لذلك لذّة ما كنت أتوقّف عندها كثيرا...
***
مِن عجيب الأمر الذي وجدنا بزاوية الشيخ التليدي، أننا عندما كلّمْنا بعض تلاميذه في العلم، ممن يقيمون في الزاوية، وجدناهم لا يُصدّقون بجانبه الصوفي؛ وأذكر أن واحدا من أولئك الطلبة (وكان من الأنجرة)، ردّ علينا باستهزاء عندما سألناه عن أذكار الشيخ التي يدلّ عليها تلاميذه. فسألت نفسي، فيما بيني وبينها متعجّبا: كيف يكون المقيمون في زاوية الشيخ، على العقيدة الوهابية؟!... ألم يتمكّن مع غزارة علمه، وتصدّره للتشيّخ بالمعنى الصوفي، من أن يغيّر من تلك السطحيّة التي وجدنا طلبته عليها؟!... لم يطل استغرابي كثيرا، فقد حضر إلينا ابن الشيخ "بـ" نفسه في الغد أو بعده، وهو يضع المائدة خدمة لنا، وعرّفنا الشيخ به وهو يُخبرنا بلهجة لا تخلو من فخر عن ابنه قائلا: - إنه يدرُس العلم الشرعي في جامعة المدينة المنوّرة!... سمعت عبارات الشيخ، وأخذتها بعين الاعتبار، وأنا أُسكِت نفسي من باب الأدب عن الأسئلة التي كانت تتزاحم في ذهني... كنّا نحضر مجالس العلم للشيخ، وكنت أعدّ ذلك كرامة لي من الله وأنا الآتي من عالم الموسيقى... كنت أستمع إلى الشيخ باهتمام وبتعظيم، موقناً بأنني أستمع إلى أحد أفراد شيوخ المغرب في العلم الشرعيّ؛ بل في شُعبه المختلفة، إلى جانب علوم اللغة. فكنت أحمد الله في باطني على نعمة حضور تلك المجالس وأنوي التبرك بها من ظاهر قلبي، لا من باطنه... وأما جماعة الفقراء الذين صادفونا هناك، فقد سألناهم عن بعض أمور السلوك التي كنت أنا وصاحبي قد أخذناها عن بعض الكتب، أو التي كنت أنا قد ذقتها في بداية سلوكي على يد شيخي. أذكر أنني وأنا عند صاحبي في بيته بالعيون، كنت قد رأيت رزمة من الكتب على الأرض، يعلوها كتاب ابن القيّم "مدارج السالكين"، هذا إلى جانب كونه يذكر أذكارا أخذها عن الأستاذ عبد السلام ياسين، بنية تحقيق التزكّي على يده. فوجدنا فقراء الشيخ من جملة العوام، الذين يتكلمون عن بعض الكرامات بالتعظيم الذي يكون عليه العوام في العادة. لكن كان من بين الفقراء شخص مجذوب، يظهر عليه حال الاصطلام، وعيناه حمراوتان كالجمر؛ وكان لا يتمكن من مواصلة الجلوس معنا، فيقوم وهو يزفر ويدور على جدران الزاوية، قبل أن يجالسنا مجدّدا. ومما سمعته منه من طرائف، وهو يُدير سبحة بين أصابعه، أنه صعد يوما إلى الحافلة التي تقلّه من مدينته (ربما تطوان) إلى طنجة؛ فأخذ يذكر وهو ماسك سبحته في يده، وإذ بشخص من المـُنكرين يجلس بجانبه يسأله بعد إطالة نظر: - ما الذي تقوله بهذه السبحة؟... فأجابه على الفور: - أنا أعُدّ عليها المنافقين من أمثالك!... فصرنا نضحك من إجابته تلك، ونتصوّر كيف تلقّاها ذلك المسكين منه...
***
ومما سمعناه من الشيخ التليدي في أيام إقامتنا عنده، حكايته لنا عن إلقاء السلطات الأمنية بطنجة القبض عليه بعد نجاح ثورة الخميني في إيران (ونحن هنا لا نبغي الدخول في التفاصيل السياسية لذلك) عام 1979م، رفقة كل علماء طنجة، وإباتتهم في مركز الأمن، إلى أن تُستكمل التحقيقات معهم. يقول الشيخ الذي كان في ذلك الوقت ما يزال في مستهلّ كهولته: وكان معنا عالم في حوالي الثمانين من عمره، فشق علينا أن نراه يذوق معنا عذاب السَّجن، فخاطبنا فيه رئيس المركز، وقلنا له: - أما نحن، فإننا طوع أمركم، نبيت هنا ونظل، لا يضيرنا ذلك لأننا نقوى عليه؛ وأما هذا الرجل الشيخ، فما الذي سيحدث لو تركتموه يعود إلى بيته؟... قال: فأجاب رئيس المركز: - إن الخميني نفسه، الذي قلب نظام الحكم في إيران، كان في مرحلة شيخوخته؛ لذلك، فلا اعتبار لكلامكم عندنا. فعجبنا من كلام رجل الأمن، وتفطّنّا إلى كيفية اختلاف نظره بمقتضى مهنته، عن الناس من أمثالنا، والذين يتوهّمون أنهم فطناء... وعندما رأى الشيخ تعجبنا، صار يؤكّد لنا أن رجال الأمن لا همّ لهم إلا إنفاذ الأوامر!... كنّا نشمّ من كلام الشيخ بعض الاعتراض على الحكم وأهله، ولكنني كنت أنا بعد أن توجّهت إلى سلوك الطريق، أتجنّب مثل هذه الأمور، لأنني على علم بمدى تشويشها على القلب. وممن كان يتشوّش لمثل هذه الأمور، عند ظنه بأنها تؤكّد مذهبه في المسألة، صاحبي ورفيق رحلتي، الذي كان يحرص في نظره على موافقة أحكام الشريعة، مع أن أحكام الحكم ضعيفة الذكر في كل الفقه الإسلامي، بسبب تقصير الفقهاء؛ وكل من يظنّ في نفسه أنه موافق للشريعة فيها، كشأن الجماعات الإخوانية، فإنما هو متّبع لهواه فحسب. وعلى كل حال، فإن العامة يكون أسلم لهم أن يشتغلوا بما ينفعهم في أنفسهم، لو أنهم كانوا يعلمون؛ وهذا، بخلاف ما وقع لعموم الشعوب العربية، إبّان ما سُمي في حينه "الربيع العربي"، والتي كان منها وعلى شاكلتها الشعب المغربي الذي ننتمي إليه... ظهر رأي الشيخ السياسي، عندما أخبرناه بأننا -بعد الانصراف من عنده- عازمون على زيارة الأستاذ عبد السلام ياسين؛ لأنه بمجرد أن سمع منا ذلك، تهلّلت أساريره، وتوجّه بالخطاب إلى تلميذه الذي هو رفيقي، قائلا: - أَقِرئوه السلام منّي، وأبلغوه دعائي له بالحفظ والمؤازرة. وأكمل كلامه يُخبرنا: - ذلك رجل مجاهد، نذر نفسه لنُصرة الدين!... لم أكن أنا في ذلك الوقت أسمح لنفسي بإبداء رأيي، ولو في باطني وحده؛ للحفاظ على الأدب مع الجميع، وإن كنت أجد أساسا من الحكم في المسألة، ينحو بي إلى خلاف ما ذكره الشيخ؛ خصوصا وأنني بعد معاينة الآيات من شيخي حمزة على ظاهري وفي باطني، كنت على نية اتّباع شيخي فيما أعلم وفيما لا أعلم. فكان ذلك يغنيني عن تتبع مثل هذه المسائل، وكنت منصرف التوجّه إلى الحق وحده، لا أكترث كثيرا لمن أصاب في رأيه أو لمن أخطأ...
***
بعد انقضاء ثلاثة أيام علينا في الزاوية الدرقاوية، صلينا الصبح خلف الشيخ التليدي وقبلنا يده مستأذنين بالرحيل، ولكنه كأنه كان يريد إبقاءنا إلى ما بعد الإفطار (الضحى). وأما أنا فكان باطني قد انقبض، ولم أعد أقوى على المكوث أكثر من ذلك؛ فألححت على صاحبي بالمغادرة مع الشروق، لأن ذلك أنسب لي، وأنا من لا أقوى على أشعة الشمس التي كانت تزيد الضعف العام الذي أعاني منه ضعفا آخر. فانتهى الأمر بأن وافقني شبه مـُكره... في الليلة السابقة لمغادرتنا، كنا قد اختلينا فيما بيننا، للتداول فيما وصلنا إليه من رأي بخصوص الشيخ التليدي؛ وكان ذلك سوء أدب منّي أنا على الخصوص، عندما ذكرت لصاحبي أن الأمر الباطنيّ الذي كنت أنا أتحرّاه، لم يَبِنْ لي منه شيء عند الشيخ رحمه الله. فتبرّم صاحبي من كلامي، وكأنه يُرشدني إلى السكوت، فسكتّ مكتفيا بما ذكرت؛ ولكنّه كان قد عرف رأيي فيما كان يطمح إليه منّي، من دون إطالة. ولقد كان كلامي سوء أدب، لا لعدم علمي بما أقول، بل لقولي ذلك في زاوية الشيخ، أي في دائرته. وقد حفظني الله ببركة شيخي حمزة، من أن يلحقني سوء من ذلك؛ وأظنّ أننا لم نعد إلى الكلام في هذا الأمر مرة أخرى... كان الشيخ التليدي قد أهدانا في الأيام التي سبقت، بعضا من كتبه التي لاحظنا في ذلك الوقت أنها سيئة الطبع كثيرا؛ وكان من بين تلك الكتب: "المطرب بمشاهير أولياء المغرب"، وهو كتاب نفيس في بابه، قد اختصر فيه الكاتب رحمه الله، ما هو من قبيل الضروري في معرفة أولياء المغرب. ولقد كان هذا الفعل الكريم من الشيخ، مما فهمت منه أن المعاملة بيننا وبينه، لم يُنتظر منها أكثر مما وقع. ولكننا بعد عودتنا من رحلتنا بمدة، وجدنا أن الشيخ قد أخبر أحد طلبته القدماء، وكان يسكن مدينة تاوريرت، بأننا قد سافرنا من عنده فجأة، وأنه كان ينتظر أن يرانا في الصباح. فأبلغني رفيق رحلتي بما أُخْبِرَه هو، وذكر لي أنه كان يعرف ذلك، وأنني أنا من استعجلته فحسب. أما أنا، فقد حمدت الله على سرعة انصرافنا، اكتفاءً بما أدركناه من الرجل، واجتنابا لما يُمكن أن يصدر عنه بخصوص شيخي (ولو من باب التلميح) إن لم يكن موفَّقا، فيصدر عنّي ما لا أرغب في مواجهته به...
*** توجهت مع صاحبي إلى محطة الحافلات، واشترينا تذكرتيْن قاصدين إلى مدينة سلا، حيث كان يُقيم الأستاذ عبد السلام ياسين. كان صاحبي يُصرّ على إمضاء الوقت ونحن في الحافلة، قارئا للقرآن من مصحفٍ جيبيّ صغير. أما أنا فكنت أطلّ عبر النوافذ على بعض المناظر التي نمرّ بها، وأنا أذكر الله، محرّكا في يدي سبحة كانت لا تغادرني. كان باطني بعد الذي مرّ بي مع شيخي، شديد الانجذاب إليه، لا أتمكن من الالتفات عنه البتّة... وصلنا إلى مدينة سلا، بُعيد العصر بقليل، وانطلقنا في اتجاه بيت الأستاذ الذي كان يوجد بحيّ السلام. كان حي السلام ما يزال خارج المدينة، فانطلقنا على أقدامنا إليه تحت أشعة الشمس التي لا أطيقها كما أسلفت. كان صاحبي، يعرف البيت، بحكم سبق زيارات عديدة منه إليه؛ وعندما بلغنا الباب وجدناه مفتوحا، ووجدنا الحديقة قد وقف بها بعض الشباب الملتحين، جماعات جماعات، في دوائر مختلفة الأقطار، وهم منخرطون في أحاديث يبدو عليهم من ملامحهم أنها مـُهمّة... سلّمنا على أقرب جماعة إلى مدخل البيت، ودلفنا إلى غرفة الجلوس التي كانت على غرار غرف الفيلات المغربية التي هي بين التقليد والعصرنة. كان بالغرفة سدّاري يحيط بجنباتها، وكان بعض الشباب يجلسون على السدّاري المقابل للأستاذ، يُكلمونه بخصوص مادّة كانوا يُعدّونها للنشر بحسب ما فهمت... كان الأستاذ عبد السلام، يجلس متكئا على سدّاري في الزاوية، وهو يمدّ قدميه؛ فتركت صاحبي يسبقني إلى السلام عليه، لأقلده في طريقة سلامهم، فقبل هو منكبيه وصافحه، مجيبا عن سؤال الأستاذ له عن أحواله وأحوال "إخوانه"؛ ثم تقدّمت أنا، فقبلت منكبي الرجل أيضا، وانحنيت على يده أريد تقبيلها تعظيما له، فلم يُمكّنّي منها، ولم أُلِحّ. وبعد السلام، صار صاحبي يُعرّفه بي، على أنني زميل له في الدراسة وقريب له في العائلة، بما أنه ينتسب إلى أولاد سيدي أبي القاسم الذين ينحدرون من جبال العيون؛ وكذلك على أنني أشتغل بالتدريس في المستوى الابتدائي... وبعد مدّة قليلة، كان الأستاذ قد انتهى فيها من مكالمة أصحاب الورقة المعروضة عليه، أمر الجميع بالجلوس إلى الأرض التي كنا نحن قد سبقنا إليها، فكان رحمه الله يجلس قبالتي. تأخّرت أنا عن الدائرة حياء، ومن باب الصدق، حتى لا يظنّ أحد أنني من الجماعة وأنا لست منها. فلما رآني الأستاذ أجلس خلف صف الدائرة، أشار إليّ بالتقدّم، ففعلت. وهنا ذكرت في نفسي، ما وقع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعض أصحابه في المسجد. فقد روى البخاري عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه: «أَنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَما هُوَ جَالِسٌ في الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ واحِدٌ. قالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةً في الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا؛ وَأَمَّا الْآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ؛ وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا. فَلَمَّا فَرَغَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلى اللَّهِ فَآوَاهُ اللَّهُ؛ وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ؛ وَأَمَّا الْآخَرُ، فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ.». فقلت في نفسي: أنا لست من المعرضين، ولكنّني مستحيٍ، ولقد كان بإمكان الأستاذ أن يعتبر ذلك تسنُّناً؛ ولكنّني سارعت إلى الامتثال، الذي صار عليّ الآن واجبا وأنا في بيت الرجل. فسألني الأستاذ عن أصحابه بجرادة، فأخبرته: - إن فلانا (وهو الذي كان قد تأمّر على الجماعة هناك)، بينه وبين الجماعات المخالفة جفوة. فسألني: - من تقصد؟ فأجبته: - فلان الفلاني... ثم سأل: - وهل تقصد بالجفوة، من الجفاء؟ فأجبته بالإيجاب، فأطرق ساكتا. كنت أبغي من كلامي إبلاغ مرشد الجماعة الخلل الذي كانت تعاني منه في المعاملة، وبالتالي في الأخلاق؛ ولكنّني لم أزد على ما قلت تأدّبا، ولعلمي بأن الأستاذ لم يفته مرادي، وهو الرجل اللمّاح...
***
ومما كان قد فعله معي ذلك الرجل المتأمّر، عندما علم بانضمامي إلى الزاوية البودشيشية، وكنت أستحيي منه لسبقه لي في السنّ (كان من الجيل الذي يكبرني)؛ أنه بمجرّد أن لقيني، ضربني ضربة قوية على قفاي، وهو يقول في عصبية: - أخذوك!... أخذوك!... وهو يضحك ضحكة هستيرية يعلمها كل من يعرفه. ثم أردف: - كن على يقين أن اسمك الآن قد وصل إلى القصر!... فقلت أنا في نفسي: - وما الشأن في أن يصل اسمي إلى القصر أو حتى إلى الكنيست في تل أبيب؟!... إنما الشأن فيما أكون عليه من طاعة لله أو من معصية له سبحانه!... لكنّ القوم كانوا قد تواطأوا فيما بينهم على النفاق، ولم يكن يُجدي أن أردّ على الرجل بما يليق... كنت لا أشك في أن الرجل ممسوس، فقد جالسته مرّات، ورأيته يتصرّف مع الناس بغرابة: كان يتحكّم فيهم ظاهرا وباطنا، وهم -على عادتهم- كانوا يسايرونه فرارا من شرّه. وبلغني عنه أنه كان يذكر الأسماء الإلهية بغير إذن، وكان من يركبونه من الجنّ لا يقبلون ذلك، وربما سمع لغضبتهم خلخلة لباب بيته، أو زعزعة لسوره؛ فكان يتوهّم أنهم الملائكة، وكان الناقلون عنه يرغبون في تثبيت ذلك في أذهان سامعيهم، تسويغا لما يبدو عليهم من تعظيمه؛ وهذا من الحيل النفسية التي لا تنطلي إلا على الأغبياء وغلاظ الطبع. ورغم أن الملائكة يحرسون الأسماء التي يخدمونها، إلا أن تأديبهم يكون بعد الإكثار من الذكر، لمن لا أهلية له. وأما صاحبنا، فكان طوع نفسه وشيطانه؛ كنت أنا أعلم منه ذلك، من بين كل من يعرفونه؛ حتى إنني مرّة وكان قد تجاوز معي حدود اللياقة، تحدّيته أن نجلس معا للذكر، وننظر من يقوم أوّلا؛ فانصرف عنّي كالسهم، لا يلوي على شيء. وقد بلغ الأمر بأحد معارفي (س. أبـ) من الفقراء البودشيشيّين، الذين سيعادونني أشدّ العداوة فيما بعد، أنه كان يُعظّمه بحضوري وأنا مستغرب من فعله. كان كالآخرين ينفعل له، أما أنا فكنت أواجهه بباطني، وأحيانا بباطني وظاهري. وقد حدث بيني وبينه بعد مدة طويلة، وبعد أن سكن وجدة واشتغل بطبع البحوث لطلبة الجامعة، أن دلّني أحد معارفنا عليه، من أجل طباعة كتابي "الكمال والتكميل"، بعد أن كنت قد نشرت الجزء الأول من كتاب "مراتب العقل والدين"؛ فذهبت إليه في بيته الذي جعل الطابق الأول منه مطبعة، مع من كنت أرافقه في جرادة (ع. إ) الذي كان يخرج كثيرا مع جماعة "الدعوة والتبليغ"؛ فاستقبل رفيقي بأفضل مما استقبلني من أول وهلة، ثم صار يُكثر عليّ في اعتراضاته عندما أعطيته كتابي على "سي دي"؛ وصار كلما اعترض علي يزداد انقباضي، وهو يتلذذ لذلك من مرض نفسه، إلى أن فات وقت أذان الظهر الذي سمعناه بقليل؛ مما يدل على أنه كان يقصد إلى تفويت الصلاة مع الجماعة. وعندما انطلقنا إلى المسجد، ودخلنا، وجدنا الجماعة قد خرجوا من صلاتهم، فعرض عليّ أن أؤمّهم في مؤخّرة المسجد، فأبيت فورا، لسببيْن: الأول هو أنني كنت منقبضا انقباضا، لا أصلح معه للإمامة أدبا مع الله؛ والثاني، هو أنني قليلا ما أقبل الإمامة في الصلاة، وأفضّل أن أكون مأموما يرجو أن تناله شفاعة إمامه، لا شفيعا. شرعنا في الصلاة بإمامة صاحبنا، إلى أن انتهينا وسلم الرجل فسلّمنا؛ لكنه بقي متجّها إلى القبلة، على أربع، كهيئة البهائم، وهو يصيح بأعلى صوته: - آي آي آي آي... فاستحييت أنا من الله، وصرفت باطني عنه، فأُطلق. وعندما خرجنا -وكأنه فهم ما الذي وقع له- صار يُمسك بيدي ولا يتركها، وهو يتودّد إليّ كما لم أره من قبل؛ فلم أره على تكلّف منّي إلا مرة أو مرتيْن، قبل أن أعود عن مشروع طبع الكتاب لديه. ولا أدري الآن هل هو ما يزال من أهل الدنيا، أم يكون قد انتقل عنها؟... وكان قد اتصل بي أيضا بعد شيوع خبر انتسابي إلى الطريقة، أحد أمراء الأسر (وكان أقرب إليّ من غيره) من جماعة "الطلائع"، فأخذ يكلّمني عن الطريقة البودشيشية، مؤكّدا لي أنهم عندما يُقبل عليهم الشخص لأول مرّة، يُعطونه "غريبية" (أحد أنواع الحلوى المغربية) ليأكلها، فإذا أكلها لا يتمكن من مفارقتهم بعدها أبدا؛ ثم أخبرني بأن الفقراء يتبرّكون بغُسالة الشيخ، ليجعل نفسي تنفر؛ فأجبته: - أنت تعرفني، وتعرف بأنني لا أتستر على شيء من الأمور المخالفة للشريعة؛ فلا تحمل همّا، عندما سأذهب إلى زيارة الشيخ، إن رأيت ما ذكرتَ لي فسأعود حتما وأفضح تلك الأمور إن وجدتها؛ ولكنني إن وجدت الله ورسوله عنده، فإنني أيضا سأخبر بذلك. فوجِم الرجل، وأُسقِط في يده... وليلاحظ القارئ هنا، أن الإسلاميّين -رغبة منهم في ربط الناس بهم- لا يتورّعون عن الكذب الصّراح، مع كثرة تظاهرهم بالتّديّن!... فكان أن وجدت الله ورسوله قبل زيارة شيخي، وبعدها، رضي الله عنه. ولكن ذلك "الأمير"، لم يعد إلي ليعلم منّي حقيقة الأمر، فتأكّد كذبه وكذب من هم على شاكلته، ممن يعبدون أنفسهم وشياطينهم؛ ولم أره سوى مرّة واحدة مصادفة بأحد أسواق وجدة، فسلّم عليّ وهو يحمرّ خجلا...
***
وكما يقول الفقهاء: المناسبة شرط؛ فلذلك نرى أنه يحسن بنا هنا أن نذكر ما كان من اتفاق بيني وبين زميلي في العمل (أ. أبـ...)، والذي تطوّع من نفسه وقال لي: - اذهب أنت في الطريقة البودشيشية، وأنا سأبقى مع جماعة العدل والإحسان (التي خرج إليها من جماعة الطلائع)، ولنضرب بيننا موعدا نلتقي فيه، ليُخبرَ كل واحد منا صاحبه بما وجد؛ وهذا حتى نتبع جميعا الحق، حيث كان. فأقررته على رأيه، وأبديت استعدادي لملاقاته عند حلول الوقت، عازما على أن أخبره بما عندي، من دون أن أُخفي شيئا. وبعد أن افترقنا في العمل بشهور، لم نكن نلتقي إلا في المسجد الذي كنت ما أزال أحرص على تأدية جلّ صلواتي به. وهذا، لأنه كان بعد حلول بداية الموسم الدراسي الموالي، قد انتقل إلى مدرسة أبعد حيث كانت تعمل زوجه التي أخبرت عنها في السابق أنها كانت سيئة المعاملة له بحسب ما كان ينقل لي؛ ثم لم يلبث أن جاءني خبر موته وهو بعد شاب. فحضرت جنازته، وذكرت وعده لي، وقلت في نفسي: - ما عاد الآن يمكن أن يُخبرني بما وجد، أو أخبره أنا بما وجدت... فلم تمرّ أيّام، حتّى وجدت نفسي بصحبة رجل من الغيب، أعلم أنه بجانبي ولا أراه. وقف بي الرجل الذي كنت منقادا له، على باب البرزخ، وعلمت أن البرزخ متسع من أسفله ضيّق من أعلاه؛ يُشبه القرن في اتساعه وضيقه وفي التوائه. دخل بي صاحبي إلى داخل البرزخ الذي وجدناه كالمهجع الكبير كبرا عظيما، وعلى جنباته أسرّة بيضاء طباقا من الجانبيْن. كانت أغطية الأسرة بيضاء اللون، كأسرّة المستشفيات، وكنّا نحن نسير في الممر الذي بين صفوف الأسرّة؛ وكنت أبحث أنا بنظري يمينا ويسارا، عن صاحبي، حتى أسأله عن حاله، وأتعرّف من خلاله على حال الجماعة التي كان قد انضمّ إليها... انتهت صفوف الأسرة الطِّباق، ووصلنا إلى حيث انتهت الأسرّة، وحيث ينام الناس على الأرض ذاتها، لكنهم يبدون وكأنهم تابعون لصفوف الأسرّة في الترتيب. ورغم أن الفراش كان أبيض، فقد علمت أن حال هؤلاء أنقص من حال أصحاب الأسرة؛ فصرت أنظر إلى الأسفل، وأنا أمشي، إلى أن وجدت صاحبي على أحد الأفرشة الأرضية، من الجهة اليمنى للصفّيْن العظيميْن، فسلمت عليه وسرّ برؤيتي من جهة باطنه؛ ولكن وجهه كان عليه علامات الضيق والانقباض، لا يتمكّن من أن يظهر عليه ما يَنمّ عن سرور أو انشراح. فسألته عن حاله، فأجابني: - إنهم يُعذّبوننا!... فعلمت من هذه العبارة حاله، وحال الجماعة التي كان منها؛ ولكنّني لم أخبر أحدا من أصحاب تلك الجماعة، لعلمي بأنهم لن يصدّقوني، ولن يزدادوا بعدم تصديقي إلا بعدا عن الحق فحسب... ولكنّني أخبرت قلة من الفقراء، الذين لم ينتفعوا في أنفسهم، ولا نفعوا غيرهم...
***
ولنعد الآن إلى الأستاذ عبد السلام ياسين، الذي جالسته مرة واحدة، وسمعت منه مباشرة قوله: - من لا يشتغل بالسياسة، فلا حاجة لنا به!... وكأنّه كان يُجيبني عن السؤال المحوري الذي جئته به، والذي كان عن طريق سؤال القلب وحده: - ما قولك في أمور التزكية الشرعية؟... وكان ردّي في نفسي على جوابه مباشرة: - ما كان يحق لك اشتراط الاشتغال بالسياسة على الناس، ولكن كان ينبغي اشتراط صدق التوجه إلى الحق تعالى!... ونعني منه: التوجه إلى الحق وحده من غير إشراك. فهذا هو الشرط الأصيل من جهة الدين الحق، والقمين بتحقيق الترقّي للمسلمين. وأما اشتراط الاشتغال بالسياسة، فهو فتح لباب الشرك أمام الناس على مصراعيْه؛ خصوصا وأنهم لا يسلمون منه بدايةً، وعند مغادرتهم بيوتهم إلى "الجماعة"... ما كان يليق بي أن أشوّش على الجماعة ما تظنّه هي أنه الحق، بمحضر من مرشدها، خصوصا وأنّي قد وردت إليهم باحثا في مبتدأ أمري؛ ولكنّني استخلصت بيني وبين نفسي أن الأستاذ ليس ربّانيّا بمعنى المواجهة الذي يكون عليه شيوخ الإسلاك، فانتهيت من القطع بيني وبين نفسي فيما جئت من أجله. وقد ثبتت لديّ صحة هذا الرأي مع مرور السنين، حيث لم يخلُ محيطي من بعضهم: من فضلائهم (بتعبيرهم)، ومن بعض المنتمين لقبيلتنا منهم أيضا. فعرفتهم من أشدّ المتصلّبين في الرأي، وإن بدا لهم غير ما يعتقدون؛ وهو ديدن كل الجماعات الأيديولوجية بجميع أصنافها، وفي العالم بأسره. أما الدّين الحق، فهو يتطلّب من العبد أن يبقى طول عمره قابلا لتغيير بعض قناعاته، إن بدا له أنها كانت مخالفة للحق. وهو ما عملت عليه أنا، مع الطريقة التي انتسبت إليها، ومع شيخي، حتى نالني من بعض جهاتها (أقصد الطريقة من دون الشيخ) شرّ عظيم. وسيأتي ذكر ذلك في محله بإذن الله تعالى...
***
أما الآن فسأذكر نموذجا لتصلّب أفراد جماعة العدل والإحسان الذين عرفتهم وعرفوني عن قرب: كان شخصان من القيادات الجهوية الشرقية، يتفقدانني بين الفينة والأخرى. أما الأول فكان قد سكن بجرادة مدة، ثم عاد عنها إلى مدينته الأصلية؛ وأما الآخر فكان يسكن جرادة، ويشاركني الانتماء القبلي. كانا -جزاهما الله خيرا- يأتيان لتفقّدي، حتى إبّان اعتصامي مع أسرتي في بيتنا طيلة ثلاث سنوات ونصف، بعد التضييق الذي طال ابنة أختي التي كانت ما تزال طفلة، في مرحلة جديدة من التضييق العام والطويل الذي لحق الأسرة جمعاء؛ فكنّا نتذاكر الدّين وأحوال المسلمين في المغرب وفي خارجه، بصدق وشفافية، لم أجدها لغيرهما. ولكن مع ذلك، فقد قصّ علينا الشخص الوافد على جرادة، وصاحبه يستمع، رؤيا رآها للعبد الضعيف، فقال: - رأيت الشيخ الأكبر على أول طريق واضح المعالم، شبّهه بالمحجّة البيضاء؛ وكان الشيخ عليه السلام يُشير إلى نهاية الطريق، حيث كنت أقف أنا... كانت الرؤيا لا تحتاج إلى تعبير، وأنا استحييت من الكلام وأنا مذكور فيها؛ ولكنّني بقيت منتظرا لما سيقوله الاثنان: فأما الرائي، فإنه لم يزد على أن أكّدها لصاحبه بجزم؛ وأما الثاني، فقد سكت على مضض. فبقيت متعجّبا من فعلهما، مقارنة بأسلافنا الذين كان الواحد منهم يُبدّل توجّهه كله، فور رؤيته لما يُنبّهه إلى ذلك من عالم الرؤيا. ولم يكن هاذان منفرديْن بهذا الموقف من الرؤى، بل لقد رأى آخرون ممن كنت أعاشر بظاهري، ما يماثل ما ذكرنا أو ما قد يُجاوزه أحيانا. وكان عمل الرائين بعكس ما رأوا... فعلمت أن الأمر لله وحده، يوفّق إن شاء عباده للعمل بما يُريهم، وإن شاء أبقى الرؤى حُجَجا يُحاسبون عليها يوم القيامة... وهنا أذكر رَأياً لي كنت أذكره لبعض من كان يرافقني، من باب المكر الإلهي، حين كان يسألني: - هل علينا شيء إن لم نتّبعك في هذه الأمور؟... فكنت أجيب بما ينفعني، لا بما ينفعهم، لعلمي بما هي عليه بواطنهم من تكذيب، وأقول: - أنا لست رسولا، حتى تكون متابعتي واجبة يؤاخذ الله عليها عباده!... وهكذا، كنت أضمن بتوفيق الله وبعد قبوله سبحانه، أنا نجاتي عند ربّي. وأما هم، فكان عليهم أن ينظروا إلى المسألة من جانبهم، ويسألوا أنفسهم: هل سيُحاسبنا الله على ما يُرينا في منامنا؟... والجواب واضح لمن كان على أدنى نور شرعي، وعلى أدنى تصديق. وهذه المسائل كلها، مما تتناوله الشريعة من جهة ظاهرها، ومن جهة باطنها؛ من جهة إجمالها، ومن جهة تفاصيلها. ولكنّ الفقه المبتور والمقطوع، الذي يكون الفقهاء فيه على نظر عقلي مشابه لنظر الكفّار، وكأن الدين عقلاني المصدر، لا يعطي من الأحوال سوى ما ذكرنا. وبهذا الفعل منهم، فإنهم قد قطعوا الأمة عن حقيق التديّن منذ القرن الأول، وإلى زماننا هذا. وعدم التصديق الذي يجده جلّ المسلمين من جميع القرون، إنما هو من هذا الصنف المؤسَّس له. وأما أنا، فقد كنت لا أعتبر آراءهم المخالفة للدين الأصلي عقيدة وعملا، حفظا من الله تعالى لسرّي... ومن علم الشريعة من هذا الوجه الذي أومأنا إليه، فإنه سيعلم أحوال الأنبياء عليهم السلام عند نطقهم بما نقل الله عنهم في كتابه الكريم. وهو علم لم نر إلى الآن -بحسب علمي- من تكلّم فيه بالقدر الذي يناسبه. ونرجو من الله أن يجعل ذلك من نصيبي في مستقبل الأيام، كما تفضّل عليّ بمحض إنعامه بالكتابة في العلوم الشرعية التي كتبت فيها. وعندما أقول أنا وأمثالي: "العلوم الشرعية"، فإننا نعني من غير شك: ظاهر الشريعة وباطنها؛ مما يندرج في علوم باطن الشريعة، أو مما يندرج في علوم الحقائق أيضا؛ وذلك لأن بينهما فرقانا دقيقا... |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.