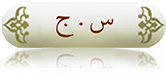اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 | 
2025/11/23 رحلتي إليّ (إلى التسميم الثاني) -7- إلى التسميم الثاني
طيلة الشهور الماضية، كان السم ينتشر في جسمي، إلى أن بلغ بي الأمر إلى أن انقطع النوم عنّي، وكدت أمتنع بالكلّيّة عن أكل الطعام. ولقد سهّل عليّ التعرف إلى أركان الطريق، كما هي لدى الأبدال، من جوع وسهر وصمت وعزلة، أن أكون على ذلك كلّه بما يكاد يكون أمرا واقعا، لا مجاهدة تُذكر لي فيه. فكان حالي كما أخبر الله عن طوفان نوح عندما جاء أوانه، في قوله سبحانه: {فَٱلۡتَقَى ٱلۡمَاۤءُ عَلَىٰۤ أَمۡرٍ قَدۡ قُدِرَ} [القمر: 12]؛ وأعني أن الأمر لديّ قد التقت عليه إرادتي للمجاهدة على نهج الأولين، وانهيار وضعي الصحّي من دون أن أدري. فكان أول ما كنت أعانيه السّهاد والأرق، الذي عندما اشتدّت عليّ وطأته مع مشقة العمل التعليمي المصحوب بالمشي الطويل جيئة وذهابا أربع مرات في اليوم إلى مقرّ عملي، وجدت نفسي مضطرّا إلى عرض نفسي على الأطباء، وقد كنت ما زلت محسنا للظن بهم، وهم من ينتصبون أمام مرضاهم الذين يرونهم بحسب معاييرهم أقل منهم قيمة، وكأنهم قد حازوا علم الأولين والآخرين. هذا -من دون شك- من آثار التخلّف الذي يتجلّى في مجتمعاتنا بتجلّيات عديدة، عندما يحكم الشخص المتخلف على متخلّف آخر، انطلاقا من معايير سطحيّة تُرضي الأمراض النفسية المتغلغلة عميقا في الأفراد والمجتمعات، إلى حدّ قد لا تبلغه نظرات الباحثين والدارسين المتخصّصين. وعندما أحكم أنا هذا الحكم على جلّ أطبائنا الذين عرفت (على الأقل في ذلك الوقت)، فإن حكمي لا يكون اعتباطيّا وأنا الحريص على المنهجية العلمية في كل كتاباتي، مهما بعدت عن العقول العامية؛ وأهم ما أستند عليه في حكمي المقارنة: فأنا قد عرفت معاملة بعض الأطباء من الغربيّين، الذين كنت أجدهم -بعكس أصحابنا- في غاية التواضع، وغاية التفهم، وغاية إتقانهم لعملهم. وأذكر هنا كلامي لأحد الأطباء المغاربة الذين التقيتهم، في هذه المسألة، فما كان منه إلا موافقتي على رأيي. وأضاف هذا الطبيب الفاضل، إن خلاصة هذه المقارنة، تتجلّى في اكتفاء الأطباء الغربيّين القدماء، في وصف دواء واحد للمريض، بعد فحصه وحسن الإصغاء إليه، بخلاف هؤلاء المتأخّرين الذين يكونون داخلين في اتفاقات مع الصيادلة في مدينتهم، والذين يصفون في بعض الأحيان أكثر من عشرة أدوية في الوصفة الواحدة؛ خصوصا للموظّفين الذين يكونون على يقين بأن التعاضدية هي من سيتولّى دفع التكاليف. أقول هذا، وأنا من كنت طيلة فترة عملي في وظيفتي التعليمية، أرفض أن أنخرط في هذه الهيئات التي كنت أراها من منطلقاتي الشرعية، مخالفة من جهة العقيدة لما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توكّل على الله وحده؛ وداخلة من جهة العمل، فيما هو من قبيل الاحتيال على الناس، وأكل أموالهم بالباطل. وعلى كل حال، فلست هنا، بمعرض التأصيل للمسألة، وهذا الكتاب لا يحتملها؛ ولكن أنبه تنبيها عابرا إلى ما عشت عليه، حتى يقترب القارئ منّي بأكثر ما يُمكنه الاقتراب...
***
اضطرني ضعفي الشديد، إلى زيارة الطبيب عدة مرّات، فكان مما دلّني عليه من الأدوية: أقراص منوّمة، كان يُفترض أن أنام بعد تناولها. لكنّ الأمر سار بعكس ما كنت أشتهي أنا والطبيب، لأنني مع تناول المنوم، كنت أُصبح في وقت مغادرتي إلى العمل صباحا، أجد نفسي أضعف مما كنت عليه من دون منوّم في الأيام الأخرى. فصار الأمر يشتدّ عليّ كل مرة، حتى كنت أُضطرّ إلى الترخّص أسبوعا كاملا للبقاء في البيت، لعلي أسترجع بعضا من قوتي، أنا الذي ما أزال في مستهل العشرينيات من عمري... ظهر لي بعد تكرار الزيارات إلى الأطبّاء، أن حالتي مجهولة، لم يتمكّن أي طبيب من مجرّد الاقتراب من التشخيص الصحيح لها. لم يكن يخطر لي أنني أعاني من أمر خاص، لبعد ذلك عن إدراكي، وأنا من اعتاد أن يرى نفسه أقلّ الناس شأنا، وأبعدهم عن الخصوصية بجميع معانيها... لم يطل الأمر عليّ كثيرا، وأنا ما أزال في بداية عملي في الحجرتيْن المستقلتيْن، إلى جانب رفيقي (أ. أبو...) الذي كان السبب في "انضمامي" لشهور معدودة إلى جماعة "الطلائع". كان هذا الرجل لطيف المعشر، كثير المراعاة لشعوري؛ ولكنّه كان يعاني من أزمة حادّة مع زوجه التي كانت تشتغل هي الأخرى بالتدريس في مدرسة غير مدرستنا. كان الأمر بينه وبينها، يصل في كثير من الأحيان إلى الافتراق المـُستدعي لتدخّل كل معارفهما من أجل إصلاح ذات البين، من دون جدوى... وما كان الأمر مع كثرة الوساطات وتنوّعها، يزداد إلا تفاقما... ذات صبح، وأنا أعود من العمل رفقة صاحبي، وعندما وصلنا إلى مفترق الطرق، حيث كان يواصل هو السير إلى بيته، وكنت أنا أصعد الطريق المـُعامد لطريقه إلى بيت والدي؛ قلت له وأنا أودّعه: - لعلّك لن تراني بعد اليوم، فلا تنسَ أن تدعو لي!... ضحك الرجل، وهو ينظر إليّ باستغراب، وواصلت أنا طريقي، أُنفق من بعض ما تبقّى لديّ من قوة، وأنا على يقين من أنني سأموت ذلك اليوم. لا أدري من أين جاءني ذلك اليقين الذي لا يقبل أدنى شكّ، لكنّني تذكّرت ما كنت قد سمعته من أن بعض الناس كانوا يعلمون بوقت موتهم، بطريقة -قطعا- تخرج عن المألوف... عندما وصلت إلى البيت، وقد كان الجو باردا، وكأننا كنّا في بداية فصل الشتاء؛ ناديت على جدّتي قبل أن أدلف إلى غرفتي. جاءت المسكينة، وهي لا تعلم ما يخبّئه القدر لها؛ وسرعان ما ارتسمت على وجهها المستدير علامات الجدّ وهي تنظر إليّ نظرات المتفحّص المتلهّف. كانت هي -رحمها الله- تعلم أن الأمر يكون جادّا، عندما يبدو عليّ الجدّ؛ وأما أنا فدعوتها، لعلمي بقوة إيمانها، ورباطة جأشها، فقد كنت أهيّئها لتبلغ الأمر لوالدتي وإخوتي بكل ما تستطيعه من قوة وحكمة. أخبرتها قائلا: - جدّتي، أنا سأموت اليوم؛ وإنّي أعتمد على إيمانك وقوة شخصيتك، لتبلغي الأمر لوالدتي التي أعلم أنها لن تطيق صبرا على هذا؛ كما أوصيك بعدم بُكائي بالطريقة الجاهلية، من جزع ورفعٍ للأصوات، وأوصيك بعدم اتباع النساء لجنازتي... كانت المرأة تعلم جدّي، وكانت تعلم حرصي على اتباع أحكام الشريعة، فأذعنت بسرعة لما أقول. خرجت المسكينة من غرفتي بسرعة، ربما لكيلا أرى دموعها تنسكب على خدّيها في صمت، وهي التي من فرط حبّها لي كانت تؤثرني على نفسها في كل شيء؛ ولكنّها قد أدّت المهمة التي كلفتها إياها، على أحسن وجه وبسرعة؛ لأنني بعد مدّة قصيرة، وجدت الوالدة -رحمها الله- تدخل عليّ الغرفة وعلامات الجزع بادية عليها، فأعدت عليها ما ذكرته لجدتي. سألتني الوالدة -وهي تظن أن الأمر لا يزال يحتمل خلاف ما ذكرتُ أنا- أن تُرسل في استقدام والدي، الذي كان بمقرّ رئاسة الدائرة يعمل كعادته في مكتب الحالة المدنية، ليأخذني إلى الطبيب كما كان يفعل مرات عديدة قبل هذه؛ فأشرت عليها بألّا تفعل، لأنني كنت أتهيّأ للقدوم على ربّي، من دون أن يفتنني أيّ من أقاربي. فالأمر جَلَل، ومفاجئ. أشارت عليّ الوالدة بأن أذهب إلى الغرفة التي كانت تنام بها جدّتي مع أخواتي اللائي كنّ ما يزلن صغيرات، ففضلت ذلك، حتى تُعدّ لي فراشا مخصوصا، أكون فيه مستقبلا للقبلة، ففعلت -رحمها الله- بسرعة، وذهبت إلى الغرفة المجاورة وأنا مسنود من جهة إلى جدّتي، ومن الجهة الأخرى إلى والدتي. اضطجعت على الفراش الأرضي، وأنا أنوي التواضع لربّي عند قبض روحي عليه، لعله ينظر إليّ نظرة رحمة أكون بها عنده من الفائزين...
***
كان الوقت الذي دخلت فيه البيت في صباح ذلك اليوم، يُقارب العاشرة والنصف؛ وما أن مضى بعضه وأنا ممدد على ظهري فوق الفراش، حتى أحسست وكأن "دكاكة"، كتلك التي تدك التراب قبل تزفيت الطرق، مما يكون له عجلة واحدة حديدية ضخمة؛ قد بدأت تسير فوقي بدءاً من أصابع قدميّ ببطء شديد، حتى إذا بلغت مفصل الكعب توقّفت قليلا ثم واصلت في اتجاه الركبة؛ فإذا بلغتها، توقّفت قليلا، ثم واصلت في اتجاه الحوض؛ فإذا بلغته توقفت أكثر مما سبق بقليل، ثم واصلت صعودا إلى أسفل الصدر فتوقّفت. ثم تكررت هذه العملية ثانية، ثم ثالثة بالطريقة ذاتها: من أصابع الرجليْن، إلى أعلى البطن. فإذا تمت الكرّة الثالثة، شعرت بأنني قد فقدت التحكم في كل الأعضاء التي مرت بها تلك العملية، والسبب المباشر في عدم تحكمي كان هو افتراق عظام المفاصل بعضها عن بعض، والتي عانيت فيها ما ذكرت من توقّفات؛ وشعرت تبعا لكل ذلك، أن طولي قد ازداد على المعتاد، بحيث كانت قدماي قد تجاوزتا الفراش ونزلتا على الأرض. كنت في هذا الوقت ما أزال أستطيع الكلام على ضعف بصوتي، فطلبت من أخي وكان قد دخل عليّ الغرفة، أن يقرأ على مسمعي ما يتيسّر له من القرآن، وألا يترك أحدا يتكلم بكلام الدنيا هناك؛ لأنني علمت أن ما صرت أعانيه، هو ما سمعته سابقا أو قرأته عن سكرات الموت. بعد المرة الثالثة التي بلغ فيها الموت أعلى بطني، صار الأمر يصعد ناحية الصدر؛ وكان ذلك على ثلاث مرّات أيضا، لكن في هذه المرة، يكون كل صعود أعلى من سابقه: عندما صعد الموت ناحية الصدر أحسست بانقطاع نَفَسي حيث بلغ: كان النفس يضيق في كل مرة أكثر من سابقتها، إلى أن صار نفسي يتردّد بعد المرة الثالثة، بين فمي وحلقي؛ أما الرئتان فقد أصبحتا متوقفتيْن عن العمل. فاشتدّ عليّ الأمر أكثر فأكثر، وكان واضحا لمن حولي أنّني أجد صعوبة كبيرة في التنفس. وتذكّرت وصف بعض السلف لخروج النفس، وكأنها تخرج من ثقب إبرة؛ أو كأن السماء بثقلها قد نزلت على العبد المـُحتضَر، فصار ينضغط بينها وبين الأرض التي هو عليها. عندما كان يمر الموت على عضو من أعضائي، كنت أُحس بألم لا يُمكن وصفه، غير أنه كانت لا تخلو منه نقطة من نقط جسمي، وكأن خلاياي كان يودّع بعضها بعضا، حتى صارت كلها تعاني ألم الفراق، بطريقة لم أكن أعلمها... هذا أقصى ما وجدته من تشبيه لما كنت أجد... كان بعض إخوتي يجلسون حولي، وقد أُسقط في أيديهم؛ وأما والدتي، فكنت أراها واضعة جبهتها على الأرض، وهي تدور حول نفسها، وتقول: - أنا أشتعل نارا!... فكنت أرجو أن تصبر وتسكت، لأنني كنت أجد كل من يتكلم بغير ذكر الله، كأنه يعين عليّ الموت، ولا يُعينني عليه. وقبل أن أفقد القدرة على النطق، شددت على الحاضرين بألّا يتكلموا بغير ذكر الله تعالى...
***
بدأ الموت يصعد من حلقي نحو فكّي الأسفل، وعندما بلغ لساني، فقدت القدرة على تحريكه، وكنت عندما أجرب أن أتكلم أجده كجسم متوازي الأضلاع، يملأ فمي، وكأنه من ثقله من رصاص مثبت إلى الأسفل. فصرت إذا أردت أن أتلفّظ بالشهادة التي كنت مواظبا عليها، منذ بدأني هذا الحال، لا يصدر عنّي إلا صوت ممدود لا حرف فيه. كان يُشبه كثيرا، بعض أصوات البُكم، مع فارق هو اتصاله في حقّي، وانقطاعه بما يُشبه الحروف في حقّ البكم. فبقيت على تلك الهيئة مدة قليلة، ثم صعد الموت إلى مفصل الفكيْن، فانفصل العظمان، وسقط فكي الأسفل على صدري، فصرت أتعجّب من عجزي عن التحكم في جسمي، وأنا الذي كنت أعُدّه ملكي سنوات طويلة. ازداد الموت صعودا، فبلغ الأذنيْن، فإذا بي أفقد السمع دفعة واحدة؛ ثم صعد إلى أن بلغ العيْنيْن، ففقدت بصري، ولم أعد أرى إلا سوادا كسواد الفضاء الخارجيّ. وقبل أن أفقد السمع، سمعت أمّي، تقول: - ها قد بدأ جبين ابني يتعرّق، هكذا يحدث لمن يُحْتَضَر!... لم يبق مني حيّا إلا دماغي، وقد كنت أُحسّ به؛ فلما بدأ الموت يصعد مرة أخرى، فقدت الشعور بأسفله كلما صعد الموت إلى الأعلى. كنت أعلم أنني في الرّمق الأخير، وأن خروج نفسي سيكون من أعلى الدماغ؛ فبقي الأمر يضيق ويضيق، إلى أن صرت أترقّب مشاهدتي للعالم الذي سأخرج إليه، ولم يبق حيّا من دماغي إلا دائرة صغيرة في أعلاه. انقطعت عن الدنيا انقطاعا تاما، وصرت أنتظر، بقيت مدّة وأنا أنتظر وأعاني آلاما لا توصف، حتى رحمت كل من مات من الناس قبلي، وقلت في نفسي: - رحم الله كل من مات، فنحن ما كنّا نعلم مقدار ما عانوه في موتهم وحده. وأما ما توعّد الله به أعداءه من عذاب، والذي تكون سكرات الموت كلها أقلّه، فلا يتمكّن عقل مهما بلغ من القدرة على التخيّل، أن يتصوّر أدناه. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين معافاته ورحمته في كل أطوارنا: في دنيانا، وبرزخنا، وآخرتنا...
***
عندما كان الموت قد بلغ منتصف جسمي، وقبل أن أفقد الكلام والسمع والبصر، كانت والدتي قد بعثت إلى أحد أقاربنا، لم يكن بيته بعيدا عنّا، لعلّه يسعى -بحسب ما بلغ سمعي- إلى جلب الطبيب من المستشفى العمومي؛ لأنه كان يملك سيارة، بحكم حاجته إليها في تجارته. دخل عليّ الرجل، وكان اسمه (الط. س)؛ كان رجلا طيبا، مشغولا بتجارته، ودائم السعي في إصلاح ذات البين بين الأقارب، أو في مساعدة المحتاجين. عندما رآني ممدّدا وقد ازداد طولي، استأذن الحاضرين، وطلب أعوادا للكبريت قائلا: - إذا لم تحس قدماه بالنار، فهذا يعني أن الموت قد بدأه... أشعل الرجل عود ثقاب وثانيا أو ثالثا، وقربهما جدا من باطن قدميّ، فلم أشعر بشيء؛ فقال لمن حوله، وهو لا يتمالك نفسه من البكاء: - إن الأمر قد بدأ!... كان الله في عون السّي حمّو (والدي)، فقد ضاع له ابنه. كان العامة عندنا، وما يزالون، يُسمّون الموت ضياعا؛ وهذا من الجهل الكبير بحقيقة ما هو الأمر عليه، وبالتالي بمفردات الدّين... ومع ذلك -ولعل الأمر كان بإلحاح من الوالدة- فقد ذهب الرجل وعاد مع والدي والطبيب. لا أدري هل مرّ على والدي في عمله وأخذه معه إلى الطبيب، أم إن الوالد كان قد عاد من عمله في منتصف النهار في موعده المعتاد، فالتقى الجميع عندي. كل ما أعلمه، هو أنهم عندما دخلوا عليّ، كان الموت قد بلغ صدري؛ شعرت بالطبيب يقيس لي الضغط، ويهزّ رأسه بالنفي، مُعلما الحاضرين بموتي الحتميّ. ثم أردف، إن ضغطه قد بلغ (4)، ولا يمكن أن يعيش؛ اذهبوا وأحضروا فقيها، حتى يُعينه عند خروج نفْسه... كان والدي يتشبّث بي، فرفعني من ذراعي، فلما أيقن بموت ما كان يُمسكه منّي أرسلني، فبقيت في وضع غير مناسب: صدري إلى الأعلى، ورأسي الذي كان ما يزال حيّا، إلى الأسفل، مع عجزي التام عن إصلاح وضعي؛ فزادني ذلك ألما على ألم، وقلت في نفسي: - الناس يفعلون ما بدا لهم، من دون أن يأبهوا للمـُحتَضَر!... لا أدري من تنبه إليّ، وعدّل من وضعي... لكنني في ذلك اليوم، رأيت والدي يجهش بالبكاء وقد تمزّق وجهه، حتى صار بكاؤه يُشبه الضحك. وكان قريبنا الطيب، يواسيه، ويُصبّره...
***
عندما كان قد مات الجزء الأسفل من دماغي، وانفصلت عن العالم من حولي، لم أكن أعلم ما كان يدور حولي، ولا علمت مقدار المدة التي قضيتها واقفا على باب البرزخ أستأذن ربّي... مرّ أمام بصيرتي كل عمري كالشريط السينمائي، كما يقول كل من قاربوا الموت في حياتهم؛ وكان ذلك في لحظة واحدة. فندمت على كل التفاصيل التي كنت أعتني فيها بشيء من الدنيا، مهما بلغ من صغره وبساطته؛ وتمنّيْت -لو أنني كنت أعلم خاتمتي- أن أسجد لله سجدة واحدة، على التراب، ومن غير حائل، لا أرفع من سجدتي حتّى أُقبض عليها، رجاء أن ينظر إليّ ربّي نظر رحمة بفضله... كل ما علمته بعد مدّة لم تخضع في نظري إلى قياس الزمن، هو أن النفس بدل أن تُكمل طريقها إلى الخارج، قد صارت تنزل ببطء كما صعدت: فعاد إليّ الإحساس بدماغي قليلا قليلا، ثم بعد مدة عاد إليّ بصري، ثم سمعي، بالطريقة ذاتها. أما المفاصل التي كانت كلها قد تفكّكت، فقد كان أمرها يتطلب وقتا أطول بكثير، حتى تعود إلى وضعها الأول، وأتمكّن من تحريكها. ولما عاد إلي التحكم قليلا في جسمي، والتحقت القدمان به، كانت الساعة تقارب السادسة مساء، بحسب ما علمت فيما بعد، إن لم تجاوزها قليلا... نظرت حولي، فوجدت والدي يجلس على سدّاري (كنبة) استُقدِم بهذه المناسبة إلى الغرفة من غرفة أخرى، وإلى جانبه كانت والدتي وأخي؛ فلما تمكّنت من توجيه نظري نحوهم، كان أول ما نطقت به، وأنا أبتسم قليلا بقصد التلطّف بهم، وكأنني أنصحهم: - إن الموت ليس أمرا هيّنا!... فرأيت الجميع يوافقون مذعنين، وهم يلهجون بالدعوات الصالحة؛ ولكنني كنت أعلم جازما، أنهم لن يُدركوا حمولة العبارة التي نطقتها، حتى يحين دورهم ويموتوا...
وهنا لا بدّ من أن أذكر رؤيا لوالدتي، كانت قد رأتها في الليلة التي سبقت الحادثة، حكتها لي أنا بعد أن أفقت. رأتني ممدّدا على الأرض ودمي قد خرج كله من جسمي، فخافت عليّ من أن أموت؛ ثم ما لبثت سيارة إسعاف أن حضرت لتقلّني إلى المستشفى، وكان الممرضون الذين نزلوا منها، يلبسون الزّيّ العسكري. فخاطبوا الوالدة قائلين: - لن يموت من هذه المرّة، فلا تخافي!... عبّرت الوالدة رؤياها، فقالت إن العساكر هم أهل الله. وقد صدقت في تعبيرها، لأن أهل النوبة هكذا هم بالنظر إلى غيرهم، رضي الله عنهم...
***
قد يتوهّم القارئ أنني عدت كما كنت قبل هذا الذوق للموت، كما يعود من نسمعهم يتكلمون عن تجربتهم للموت المتوهّم، أو كما يعود المريض من حال الغيبوبة إلى حال الإفاقة ثم بعدها إلى الصحة شيئا فشيئا؛ ولكنّ الأمر فيما بيني وبين نفسي، كان قد حُسم: لقد متّ، غير أنني أبقيت هنا لحكمة يعلمها الله. كان أمري انقطاعا عن الدنيا انقطاعا حقيقيّا، سأعيشه أنا فيما بقي من عمري في كل تفاصيل حياتي، وإن كنت مع المدة، قد اكتسبت خبرة في إخفاء هذه الحقيقة عن الناس، تسهيلا للمعاملة بيني وبينهم. وهكذا سيبقى هذا الواقع الجديد، بعيدا عن كل من يعرفونني، بمن فيهم أهل بيتي... وأهمّ ما يُلخّص كل ما مررت به، هو استهانتي فيما بعد، بكل المخاوف التي تُهيمن على عقول من لم يجرّب تجربتي... فصار التزامي بالحق، لا أُشاور فيه أحدا، ولا أنصاع فيه لقوة أحد أو هيبته، مهما بلغتا؛ وهو ما سيراه الناس منّي عنادا لا مسوّغ له، وهم يعلمون أن الله قد حباني من الذكاء، ما أبلغ به في نظرهم، أرقى المراتب في الدنيا. فسمعت مرّة من معلّميْن كنت أعرفهما، وكان أحدهما -رحمه الله- صديقا لي من دون أن يُشاركني مقرّ العمل، وكان الآخر قد شاركني مدة؛ وكانا جالسيْن على الجدار الصغير المحيط بمدار حيّنا قبل أن تُغيّر معالمه، وأنا واقف غير بعيد عنهما، بهندامي البوهيمي، أنظر إلى الأرض وأسمع ما يقولان. قال أحدهما للآخر، بنبرة جازمة: - ترى هذا (وكان يُشير بعينيْه إليّ)، لو شاء أن يحوز كل الشهادات التي تمنحها وزارة التعليم، لفعل؛ ولكنه لا يشاء!... تعجّبت من معرفة صديقي بي إلى هذه الدرجة، وكنت أعلم أن الرجل الآخر لن يفهم قصده على مـُراده، مهما اجتهد في ذلك؛ لذلك بقيت صامتا، أفكّر فيما كنت أفكّر فيه...
***
في آخر أيام لقائنا، كان أمير أسرتنا في جماعة "الطلائع"، قد أهداني كتابا لعبد السلام ياسين، لم يقرأه (كما أخبرني)؛ ولم يكن الكتاب المذكور، إلا "الإسلام بين الدعوة والدولة"، الذي التهمته التهاما، لكونه كان يجيب عن كثير من أسئلتي حينئذ. ولكن، لا أحد كان يعلم أن هذا الكتاب، هو ما سيوصلني إلى باب شيخي "حمزة بن العباس" رضي الله عنه. وهكذا، بدل أن أكون من مؤسّسي جماعة "العدل والإحسان"، التحقت بالطريقة البودشيشية، بفضل عبد السلام ياسين نفسه!... فسبحان من يُسخّر من شاء لمن شاء!... كان زميلي الذي شاركته السكن رفقة زملاء آخرين في "العوينات"، هو المتديّن الوحيد بيننا ضمن معلّمي المدرسة، واحتراما له (ممن كانوا معنا لا منّي)، فقد منحناه غرفة مستقلة حتى يحافظ على طهارته فيها ظاهرا وباطنا؛ أما نحن الذين كنّا ما زلنا على جاهلية، فقد كنّا نسكن ثلاثة في غرفة أخرى. فكان منّا المدخّن، ومنّا الشارب للخمر، ومنّا المولع بالموسيقى الهندية والراي، كما كان زميل ما لبث أن التحق بفرنسا ليزيد عدد العمال المهاجرين واحدا، وغادر سلك التعليم... كان هذا الشخص، يُشبه الإخوة الجزائريّين في كلّ شيء: في طريقة الكلام، وفي نظرته إلى العالم. وهو عندما غادر إلى فرنسا، فإنما التحق بمن هم على شاكلته من أهل المهجر من الجزائريّين والوجديّين خاصة، كما تلتحق السمكة بأخواتها حيث هنّ من بحر أو نهر... ورغم أن أخانا (م. ز) كان يدعوني في أحيان كثيرة إلى الدين، فإنني لم أكن ألقي بالا إلى دعوته، وذلك لأنه كان ذا شخصية جبانة، وأنا كنت أعرف بالفطرة أن المؤمن لا يكون جبانا. فكنت أنظر إليه بأدب من دون أن أرد عليه، وكان هو لا يُلحّ حتى لا يفقدني، ويعاود الكرة مرة أخرى كلما سنحت له فرصة... ولكنّني عندما قرأت كتاب "الإسلام بين الدعوة والدولة"، ووجدت الكاتب (وكنت أصدّقه من أثر قراءاتي له في مجلة الجماعة) يُثني ثناء بليغا على شيخه الحاج العباس رضي الله عنه (وكان قد انتقل عن الدنيا)، وعلى وارثه وابنه سيدي حمزة رضي الله عنه. فقلت في نفسي: لمَ لا أجرّب اتباع هذا الشيخ، بدل أن أجرب من كان تلميذا لوالده؛ خصوصا وأنني لم أكن أقبل الاستغفال الأيديولوجي، سواء كان مغلّفا بالدين أم كان ذا نزعة يساريّة غريبة عن مجتمعنا، وغريبة عن فطرتي. فشرح الله في الأمسية التي ختمت فيها الكتاب قلبي، ومباشرة بعد أن انتهيت من قراءته، ذهبت عند صديقي الذي كنت ما أزال على صلة به بعد أن انتقلنا إلى العمل داخل المدينة، وطرقت بابه بعد مغيب الشفق بقليل، ففتح لي كعادته ودعاني إلى الدخول. وكم كانت دهشته، عندما سألته أمرا واحدا: أن يأتيني بورد الشيخ حمزة!... فذهب من فوره بمعيتي، إلى مقدّم الطريقة ليستأذنه في الأمر، وبقيت أنا بعيدا، من دون أن أتصل به؛ فجاءني بعد مدّة يسيرة بالورد، وعلّمني كيف أقرأه. أما لماذا لم أذهب إلى المقدَّم المعني مباشرة، فذلك لأنني لم أكن أطمئن إليه، بحسب ما كنت أسمع عنه، وما كنت ألاحظه على أصحابه من "الفقراء"، مما لم يكن ليستثيرني بحال من الأحوال. وسيأتي ذكر ما وقع لي مع هذا المقدَّم من عجائب فيما سيأتي من حكايتي...
***
ذهبت مسرعا إلى غرفتي في بيت والدي، وبدأت ذكر الورد مساء، لأنني لم أعد أقوى على الانتظار حتى أبدأ في الصباح، كما يبدأ الذاكرون في العادة؛ وكأن القيامة ستقوم تلك الليلة. ولقد حدث معي ما لم أكن أتصوره، ولا خطر لي على بال، من أول جلسة ذكر (مما يُسمّيه الخواص: ذوق الحال): شعرت بمجرّد أن شرعت في الذكر، أن صدري (ما بين نحري وبطني)، قد أصبح فارغا فراغا لم أعرفه فيما قبل ولا مرّة؛ وأحسست بعد الضنك الذي كنت أعانيه في دنياي، براحة لم أذقها في كلّ ما سبق من عمري، فقلت في نفسي: هذه الراحة مما يكون عليه أهل الجنّة من غير شكّ، لأن راحة الدنيا لا تبلغها، مع علمي بها من ذوقي لأحوال الدنيا في كل ما سبق من عمري. وإلى جانب هذا، صرت أحس بيد تمسك بقلبي (العضو)، الذي لم أكن أحسّ به في صدري فيما قبل بهذه الطريقة؛ وكأنه مستند إلى راحتها (الكف) في صدري. أحس بذلك إحساسا بيّنا، ولا أشك فيه لحظة!... فكنت أجد لذلك دغدغة تجعلني أضحك بيني وبين نفسي؛ فإذا توقّفت عن الضحك، ضغطت تلك اليد قلبي في لطف كبير، فأعود إلى الضحك مجددا... كنت قد شككت في سابق عهدي، عندما وجدت نفسي أنظر إلى الأمور نظرة مخالفة لكل مَن حولي، أنني إما مجنون أو أسير في طريق الجنون. وهذا، لأنني من فرط التزامي بمنطق الأشياء، لم أكن لأوافق نفسي على مخالفة كل الناس وهم يفوقونني عددا، ومع تأييد بعضهم لبعض، وشهادة بعضهم لبعض، من دون حجّة قوية لا أشكّ فيها. فلما صار معي ما ذكرت من حال، في أول جلسة للذكر، قلت في نفسي: - كنت أشك في أنني مجنون، ولكن يبدو لي الآن أنني جننت حقا ويقينا!...
***
لا أدري هل نمت تلك الليلة أم لا، ولكنّني عندما خرجت حوالي السادسة والنصف صباحا لألتحق بعملي (وقد كنّا نبدأ العمل على الساعة السابعة في تلك الفترة)، كنت ما أزال على ضحكي، وما أزال أشعر باليد الماسكة بقلبي داخل صدري. كنت معتادا على المرور في طريقي، بعمّال البناء الذين كانوا يبنون أحد البيوت في جوارنا، وكنت أعرف أحد المـُشرفين منهم، فخفت أن ألتقيه وأن يعلم بما أنا عليه من حال، فيشهد أمام المدينة بأنني قد تمّ جنوني، فتعمّدت أن أصرف وجهي إلى الجهة الأخرى وأنا أمر بموضع البناء، واجتزت الطريق الترابي الطويل، الذي كنت أقطعه جيئة وذهابا أربع مرّات في اليوم، إلى مقرّ عملي، على ما كنت قد بلغته من تدهور لصحّتي... ولعلّ ذلك (بل لا أشك الآن) قد نفعني من حيث لا أدري... قطعت الطريق إلى أن وصلت إلى مكان عملي، وكان حجرتيْن مستقلتيْن عن المدرسة الأم، كانتا فيما سبق تابعتيْن لشركة المفاحم، فاستلْحَقَتْهما وزارة التعليم؛ وكانت الحجرتان لا تبعدان عن المدرسة المركزية إلا أمتارا معدودة. فكنت أنا وزميلي نظفر باستقلالية في العمل، مع كوننا نعمل داخل المدينة المتوسّعة... دخلنا نزاول عملنا في تلك الصبيحة من بدئي للذكر، وكان من عادتنا أن نخرج بعد أن ننتهي من الحصص إلى الخارج لحظات، بحيث نلتقي في الممر قليلا، لنتداول في الأمور التي كانت تهمّنا معا. كان هذا الشخص هو (أ. أبو...) رحمه الله، الذي ودّعته في يوم "موتي"، ولكنّه لم تمض عليه شهور، حتى كان هو الميِّت، فحضرت جنازته، وأنا أقول في نفسي: - لقد كان هذا الرجل مرشّحا لأن يدفنني، فأصبحت أنا من يدفنه!... ولكن هذا، لم يكن ليزيد من عجبي، لأن جلّ أموري (حتى لا أقول كلها)، كانت عجبا في عجب، بالمقارنة إلى الغافلين من الناس... عندما خرجت مع صاحبي من حجرتيْنا، وأفضى كلٌّ منّا إلى صاحبه بما يريد، كنت أضحك في أثناء كلامه، من غير سبب في الظاهر. أنا كنت أعلم سبب ضحكي، ولكنه هو لم يلبث أن سألني في تعجّب لا يخلو من ضجر: - ما بك تضحك؟!... لم أجد ما أجيب به، غير التصابر ومجاهدة نفسي لكي أُخفي ذلك قليلا... وهل يمكن أن يُخفي امرؤ سروره وهو يتلقّى أعظم بشارة من ربّه؟!... كلا، ثم ألف كلا!... |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.