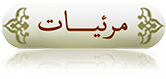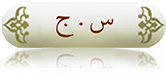اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 |  «السابقالتالي»
2025/10/30 رحلتي إليّ (إلى التسميم الثاني) -5- إلى التسميم الثاني
بعد عودتي إلى العمل بجرادة، وربما قد كان ذلك في آخر سنة 1977، لم أدر كيف تم التنسيق مع دار السينما الوحيدة هناك، لأقوم بأداء غنائيّ، كان من سعى إليه (م.د)، يرى أنني كنت جديرا به. ولقد كانت المناسبة قدوم المغنّي المغربي المشهور: محمد الحياني، إلى جرادة، بقصد تقديم سهرة تشمل مجموعة من أغانيه التي كانت قد انتشرت انتشارا واسعا بين المغاربة؛ فقبلت أنا العرض، وانتظرت في الكواليس إلى أن علمت بمغادرة محمد الحياني إلى وجدة، فصعدت إلى المسرح مع بضعة أشخاص من "فرقتنا"، والذين اكتفوا بالجلوس بجانبي من باب تشجيعهم لي، ما داموا لم يكونوا مهتمّين بما كنت أغنّيه أنا آنذاك. وكانت الأغنية التي اخترت أن أغنّيها، هي "أول همسة" لفريد الأطرش، بالصيغة الموسّعة (الحفلة)... وعندما صعدت إلى الركح، وألقيت بناظري إلى جهة الجمهور، تفاجأت بأن كل من كانوا قد حضروا لسماع محمد الحياني لم يغادر منهم أحد؛ فكنت أرى الناس بعد أن ملأوا جميع الكراسي، قد جلسوا على درجات الممرات؛ ومنهم من صعد إلى النوافذ العليا للبناية، واتخذوها مجالس لهم. ولقد حضر من بين الجمهور والدي وأخي الذي يصغرني بست سنوات، بعد أن علما بأنني سأغنّي تلك الليلة، إلى جانب أناس يعرفونني عن قرب أو عن بعد. ولما جاء دوري للغناء، غنّيت الأغنية بطريقة فريد الأطرش، وأطلت في مواويلها حتى لا يشعر المتفرّجون بأنهم قد عومِلوا بأقل مما عومل به جمهور فريد. ورغم السم الذي كان يتكاثر في جسمي، فإني بذلت جهدا استثنائيا من أجل إمتاع الناس؛ فكان بعد ذلك كل مَن ألقاه ممن لم تكن بيني وبينهم صلة، أو ربما ممن لم أكن أعرفهم من سكان جرادة، يلقونني في الطريق مـُثنِين على أدائي (عزفا وغناء)؛ ولقد التقيت من هؤلاء بعد سنوات من هذا الحدث، من كانوا يذكرون تلك الليلة، ويُخبرونني أنها صارت من ذكرياتهم التي لا تُنسى... أما أنا، فلم أغترّ بصدى تلك الليلة، ولكن كنت ما زلت على طموحي المتعلّق بدراسة الموسيقى دراسة علمية منهجيّة. وهذا جعلني -على صعوبة كبيرة بسبب تفاقم مرضي- أذهب كل صباح أحدٍ إلى مدينة وجدة، لأبدأ دراسة البيانو و"الصولفيج" مع مدام "جيلابير" التي سجّلتُ نفسي بدروسها، مقابل أداء مبلغ شهريّ لم يكن مرتفعا في نظري. وأول ما لاحظَتْه أستاذتي، عندما أرادت أن تعلّمني مبادئ الصولفيج، أنها وجدتني أعرفها كلها. كنت أميّز أشكال العلامات الموسيقية، وأميّز مدتها الزمانية، كما كنت ملمّا بطريقة ضبط مختلف الأوزان عن طريق حركات اليد. فأول ما عرفت أستاذتي ذلك، تعجّبت، وخاطبتني: - أنت تعرف ما لا يعرفه أحد من أصحاب الموسيقى الأندلسيّة بجانبنا هنا!... وقد كانت تعني بالفرقة الأندلسية، الفرقة المتخصّصة في الطرب الغرناطي الذي تشتهر به مدينة وجدة، بوصفه موروثا أندلسيا، جاءت به الأسر المهاجرة إلى وجدة بعد طرد النصارى لهم، في الحركة المعتدية الموسومة في التاريخ بوسم الإرهاب والوحشيّة. ولا يفوتنا هنا، أن نذكر أن إخواننا اليهود، قد ذاقوا من الكأس نفسها التي أُشرِبناها نحن المسلمين؛ فكنّا إخوة في تلك المحنة الكبرى، التي ما كان ينبغي لهم أن يتناسوها سريعا؛ خصوصا، وقد بلغوا تحت سلطة الدولة الإسلامية بالأندلس من الحرية والمعاملة الحسنة، ما جعلهم يعملون على تطوير فقههم على يد أحبارهم الذين يُعدّ "موسى بن ميمون" عمدة لهم. وبلغوا بحسب مؤهّلاتهم درجات الوزارة في الدولة المسلمة، ودرجة أعوان الحاكم المسلم داخل قصره، ودرجة الطبيب الخاص الذي يكون رأس الدولة المسلمة تحت رعايته المباشرة. وقد استعادت اللغة العبرية نفسها مكانتها بين اليهود، وتطوّرت حركة شعرية وأدبية وفلسفية أعادت الشعب اليهودي إلى واجهة الحضارة، بعد أن كانت معاملة النصارى الانتقامية، قد أخّرتهم كثيرا في الصفوف الاجتماعية، حتى صار أغلب اليهود لا يعملون إلا في المهن المستحقرة عند النصارى لا عندنا، كمهنة صناعة الأحذية والخياطة والحياكة وغيرها... ولم تكن الموسيقى التي جاء بها اليهود والمسلمون من الأندلس، إلا ما عُرف من بلاد مـُهاجَرهم، وخصوصا شمال أفريقيا. فكان مما استقر في هذه البلدان من الموسيقى الأندلسية: موسيقة الآلة المعروفة في المغرب بطنجة وتطوان والرباط وفاس؛ أما وجدة، فقد انفردت مع الجزائر بالموسيقى الغرناطية، كما استوطن المالوف تونس وارداً من إشبيلية وقرطبة على الخصوص. وأما فرقة وجدة، فقد كانت تابعة في البداية لإذاعة وجدة، وقد عملت بلدية وجدة على تشغيل بعضهم في وظائفها التي لا تتطلب مهارة، في الوقت الذي اكتفى فيه الآخرون بممارسة حرفهم الشخصية من حلاقة وغيرها... فكان من بين هؤلاء: الحاج عبدالكريم الزرهوني، وإبراهيم الكرزازي، وورّاد بومدين (من الجزائر)، وبنيونس بوشناق، وأحمد الزموري، وقويدر مهدي، والغوتي والعشعاشي وغيرهم... وأما الجوق الغرناطي الذي كانت البلدية قد منحته مقرّا ضمن المعهد البلدي، فقد أنشأه الشيخ صالح محمد بن سعيد ضمن جمعية السلام للطرب الغرناطي عام 1930م؛ التي أكمل عمله بها ابنه محمد شعبان (ولد الشيخ صالح)، الذي أصبحت معه جمعية السلام "جمعية أحباب الشيخ صالح. وقد قصدت أستاذتي بعدم إلمام عازفي هذه الجمعية بأصول الموسيقى العلمية، أنهم -كسواهم من أهل الطرب المحلي- كانوا يكتفون بالسماع. وهذا مفهوم ضمن موسيقى تراثية، لا تتطلّب إبداعا حقيقيا؛ وأما من أراد أن يلج عالم الموسيقى على سعته وتنوع روافده، فلم يكن له بد من التعلّم الأكاديمي، الذي كنت أنا واعيا بقيمته، بأكثر مما كان يعيه الساهرون عليه، بحسب ما استخلصته من تجربتي الشخصية في معاشرتهم...
***
بدأت دراستي بجدّ، واعترضني عائق كبير، وهو عدم حيازتي لآلة البيانو لأتمكن من التدرُّب يوميّا على التقنيات اللازمة في البيت. يعرف عازفو البيانو، أنه يتطلّب ساعات طوالا من التدرُّب يوميّا، كما يعرفون أنه كلما بدأ المرء عزف البيانو أصغر في السنّ، يكون ذلك أفضل له، إن كان من أهل الموهبة جبلّة. وأنا رغم أنني كنت بين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة من عمري، إلا أنني كنت أرى أن تخصصي في البيانو، ربما قد فات أوانه بسبب الفقر أولا. ولكن بما أن هذه الآلة كانت في الوقت، هي الوحيدة التي تُدرّس بوجدة بطريقة علمية، فإنني وجدت نفسي مضطرا لاختيارها. وعندما علمَتِ الأستاذة بظروفي، سمحت لي في كل يوم أحد، بأن أتوجّه إلى بيتها لأتدرّب على البيانو الخاص بها ساعة أو ساعتيْن في وقت الزوال: ما بين الثانية عشرة والواحدة زوالا. فكانت تستقبلني استقبالا جيدا، مرفوقة بزوجها المسنّ، الذي لم أكن أراه إلا هناك. كان بيت أستاذتي، يقع في شارع محمد الخامس، في الطابق الأول فوق متجر "باطا" (BATA). أما في الساعة الثانية من كل أحد، فقد كنت أتوجّه إلى المعهد البلدي، حيث توجد القاعة التي أدرس بها، ضمن مجموعة من الفتيان والفتيات الذين يظهر من هندامهم ومن طريقة معاملتهم أنهم من أبناء الطبقة الراقية في وجدة... غير أن السمّ ما كان ليعتبر برامجي الشخصية، فصار أثره يظهر عليّ جليّا، وصرت أحس به في كل موضع من جسمي. كان السم يعمل أحيانا كعمل مسّاكة الورق (Agrafeuse) في جسمي: كان يتتبع جميع العروق والأعصاب، ويُثبتها بشيء (لم أكن أعرفه) إلى العظام، فتلتصق التصاقا لا تنفكّ عنه، بعد ذلك طيلة سنين... وأما العضلات، فإنني صرت أحسّ بتيبّسها حول العظام هي الأخرى، حتى إن كل جسمي صار على صورة عظامي في مجمله؛ فمثلا، صارت أصابعي تحاكي متوازي الأضلاع بعدما ذهبت طلاقة العضلات. أذكر في يوم من الأيام وأنا عائد من وجدة إلى جرادة بعد درس الموسيقى (وقد كنت أعود بمجرد الانتهاء من الدرس)، أنني وصلت إلى بيتنا بصعوبة كبيرة وإجهاد ضاق به نَفَسي؛ فتحاملت على نفسي، ليأسي من الظفر بمن يُنجدني في كل الطريق؛ وعندما وصلت إلى باب البيت، سقطت على قفاي فوق الدرج، وأنا أعاني من تشنّجات قوية في كل جسمي، صارت بادية على أصابعي بعد أن اتخذت أوضاعا تُشبه ما يكون عليه من يُعاني من الصرع. فطرقت الباب بظهر أصابعي، وظهري على الدرج، فخرجت والدتي لتجدني على تلك الحال، وتسحبني سحبا إلى الداخل. عندما كنت أعرض حالي على الأطباء، كانوا لا يربطون ذلك بأيّ تسمّم؛ إلى الحد الذي لم يخطر لي أنا نفسي أنني مُسمَّم، من شدّة ما سمعت منهم عن كل الاحتمالات التي يعرفون. وكانوا يُرجعون الأعراض التي كنت أصفها لهم إلى مرض الأعصاب، فكنت أصدّقهم، وأحرص على تناول الأدوية التي يوصونني بها؛ ولكن -مع تمييزي لبعض آثار تلك الأدوية- ما كان ذلك يُحسّن من حالي؛ بل كنت أزداد سوءا مع مرور الوقت، إلى حد لا يُطاق وصفه؛ وأما إطاقة عيشه، فكانت من إقدار الله لي على تحمّل ما لا أظنّ أن أحدا غيري كان ليتحمّله مثلي؛ مع أنني لم أكن بعد واعيا بعناية الله الخاصة بي... وقد يعجب القارئ من قولي "أحدا غيري"، فيظنّ أنني أضخّم من نفسي (أنانيتي) بغير حق؛ وأنا من لم أعلم بحقيقة ما كنت عليه إلا في الشطر الثاني من عمري، والذي سينتهي بـ "وفاتي" عند حلول أجلي الأول. نعم، فأنا لا أجد وصفا يليق بما مررت به ولو لا على التمام، رغم أنني واقعيّ جدّا، ولا أقبل المبالغات أو اعتماد المجاز في تعابيري... وحتّى أقرب إلى القارئ الأمر، فإنني أقسّم له عمري بين ثلاث مراحل: - الأولى: وهي المرحلة التي كانت بين ولادتي وأول تسميم لي، ولنجعل بداية معاناتي من أعراض التسميم، مع النصف الثاني من سنة 1969... - الثانية: وهي تبدأ مع النصف الثاني من سنة 1975، وتستمر إلى الآن... - الثالثة: هذه المرحلة لم نصلها بعد عند قصّ الأحداث، ولكنها ستشترك مع الأوليَيْن إلى ما شاء الله... وما أبغي التنبيه إليه هنا، هو أن السم له معي مرحلتان: - الأولى: سم بدون علاج: وقد استمرت منذ 1969، إلى 1994؛ حيث قد بدأت أستعمل العلاج المناسب للتسمّم العضوي. وكان هذا العلاج عشبة هداني الله إليها، تستعملها حيوانات الصحراء، إن أصابتها لدغات العقارب أو الثعابين؛ وهي عشبة مشهورة عند أهل الصحراء في أفريقيا وفي الجزيرة العربية. وقد شاهدت قبل سنوات من الآن، في شريط توثيقي، مسجّل بصحراء الجزائر، ثعلبا اصطاد عقربا ليأكلها؛ وعند تثبيته لها بقائمته صارت العقرب تلدغه فيها، ثم انتهى في آخر الأمر إلى أن أكل العقرب كلّها. وبعد أكله مباشرة، توجّه إلى شجيرة كانت قريبة منه، فأخذ يقضم من أوراقها ويبتلعها؛ فكان هذا تجسيدا لما ستعمله معي هذه العشبة بعد أن اهتديت إليها. وهكذا، فإن معاناتي للسمّ من غير علاج، استمرت ربع قرن بتمامه... - الثانية: هي ما بعد استعمالي للعلاج المناسب للسم العضوي خاصة: وهذه قد بدأت معي منذ 1994، وتستمرّ إلى الآن وأنا أكتب هذه السطور؛ وهذا، لأنه بالرغم من تحسن حالتي كثيرا، فإنني ما زلت لم أتخلّص من السمّ على التمام... وهذا يعني أن هذه المرحلة الثانية قد تجاوزتُ فيها إحدى وثلاثين سنة، وما يزال الأمر مفتوحا إلى ما شاء الله... - وقد توجد مرحلة ثالثة: ما زلت لم أدخلها، لذلك سأرجئ الكلام عنها إلى حينه إن شاء الله... وعلى القارئ، حتى يُدرك بعض ما مررت به، أن يضع في حسبانه أنني طيلة المرحلة الأولى، كنت جاهلا بحقيقة مرضي؛ وكنت أعاني مسلِّما لجريان القدر عليّ، بما لم أره عند غيري؛ إلا جارا لنا كان قد سُمِّم في شبابه، فبقي يذوي اليوم بعد الآخر، إلى أن وافاه أجله بعد بضع سنين. وكنت قد أُخبرت أن عائلته قد بعثت بعيّنات من دمه (وربما من أنسجته) إلى فرنسا، بقصد تحليلها وتشخيص ما به؛ فعاد الجواب بعدم توصّل المختبر الذي قام بالتحليلات إلى أي نتيجة. فكان هذا، مما جعلني أتفهم جهل الأطباء بما أصابني إلى اليوم؛ وعندما سألَ طبيب كان يُشرف هنا في الرباط على تحليلات دمي، أُخبر مِن قِبل صاحب المختبر، بأن إجراء هذا الصنف من التحاليل مكلف جدّا، ويتطلّب أجهزة لا توجد الآن في المغرب. فزاد كل هذا، من فهمي لوضعي بالتدريج...
***
ذكرت فيما سبق، أن الله كان يستجيب لسؤال الحال منّي؛ فكان كل شيء أقصده أجده. فلم أدر بعد مدة يسيرة، إلا ومعهد للموسيقى تابع لوزارة الثقافة يُفتح عندنا في جرادة التي كانت مهملة إهمالا لا مزيد عليه. فكان ذلك، أقصى ما كنت أرجوه؛ خصوصا وأنه كان تابعا لمعهد الرباط الوطني مباشرة. فكان أستاذنا في النظريات الموسيقية (أ. ع)، الذي كان يُشبه في معاملته وجِدّه وإتقانه الأساتذة الغربيّين، مع بعض الفارق سيظهر شيئا فشيئا. وقد كان ذلك يناسبني كثيرا، وكنت أكنّ له احتراما زائدا، طيلة سنين. وأول من أتى إلينا من أساتذة الآلات، بعد ذلك: أساتذة العود، الذين كان أولهم: الأستاذ الجنيوي، الذي كان لديه تحسّس من كلامنا في شرق المغرب، وكان يتوهّم أن كثيرا مما لم يكن يُدرك فحواه، كان طعنا فيه أو تنقيصا؛ والأمر لم يكن كذلك بالقطع، وأخلاقنا لم تكن تسمح لنا بفعل ذلك معه أو مع غيره. ثم بقينا مدة من دون أستاذ، في المقر الوقتيّ للمعهد؛ إلى أن جاء الأستاذ (محمد شيدة)، الذي جاء خصيصا من أجل تدريس الصولفيج والبيانو؛ فكان هذا الرجل، نعم المعين لي؛ لأنه كان يعمل معي على دراسة بعض المقطوعات الشرقية، تطوّعا منه، وبمودّة وتواضع. وقد أهداني نسخة من كتاب دراسة العود "ميتود" (méthode) لعبد الرحمن جبقجي، والذي كان يندر أن يوجد في المغرب، إلى أن أخذه منّي (ع. م) مع كتاب آخر لمجموعة تلاحين محمد عبد الوهاب، مدوّنة بالنوتة؛ وكنت أنا لا أتمكّن من ردّ أحد سألني شيئا حياءً. ولقد علمت فيما بعد، أن هذا الخلق كان مما جبلني الله عليه؛ بخلاف ما كنت أظن وقتها من أن ذلك لا بد من أن يكون من آثار "عُقدي النفسية"، التي لا حصر لها... وبعد أشهر من إصلاح بناء الكنيسة الوحيدة التي كانت توجد بجرادة، والتي وافق من كانوا يُشرفون عليها من أوروبا على اتخاذها مركزا ثقافيا حديثا، انتقلنا إليها رسميّا؛ وكان هذا المركز يحتوي على جناح للموسيقى، وجناح للمسرح، وآخر للرسم؛ بالإضافة إلى مكتبة ضخمة، كانت في الأصل مكتبة شخصية للمهندس الروسي الذي عمل مهندسا جيولوجيا بجرادة. قدم هذا الرجل إلى جرادة فرارا من تداعيات الحرب العالمية الثانية على الاتحاد السوفياتي، وكان معروفا عند العامة باسمه: "فيدانكو". عمل هذا المهندس في القسم الخاص بالجيولوجيا في شركة المفاحم، وتُحكى عنه مواقف كان يستغربها من حوله. فمن ذلك، أنه جاء مرة إلى مركز الإدارة وهو يبكي، فسألوه، فأجاب: - إن الأرض في باطنها تحترق!... فلم يفهم عنه من سمعوه شيئا، وصاروا يستهزئون به على عادة الجُهّال. قيل إن هذا المهندس كان يلتقي بين الفينة والأخرى بالملك محمد الخامس، وأنه اهتدى إلى الإسلام في آخر عمره، الذي أكمل ما تبقّى منه في مدينة الرباط (كما يغلب الظن). هذا المهندس، لم يتزوّج ولم يُنجب، فأوصى بكل ثروته، لأبناء العمّال، وأن يُشاد لهم بها ما ينفعهم في ترقيتهم ثقافيا واجتماعيا؛ فكان المركز الثقافي الذي جاء يفوق كلّ التوقعات. وقد أوصى بجزء من تلك الثروة، للإنفاق على إدارة المركز وإمداده باللوجيستيك، كما ينبغي أن يكون أي مركز في أوروبا مثلا. وقد كانت هذه الثروة، تحت إدارة مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية الذي كان مديره حينذاك المهندس: (م. شهيد)، الذي كانت زوجته النمساوية تُدرّس بالمعهد الوطني للموسيقى بالرباط. وهكذا، فقد صار المركز الثقافي بجرادة، أرفع معهد تُدرس به الموسيقى، بالنظر إلى مستوى الأساتذة، وتوافر القاعات الخاصة بالعزف، ومكتبة موسيقية عالمية حديثة الطراز... لكنّ العقل العربي (المغربي)، سيكون له أثره على هذه المعلمة، فما اطمأن "إخواننا" حتى عاد المركز الثقافي مندوبية إقليمية لوزارة الثقافة، بكل ما تسحبه هذه الوزارة خلفها من تخلّف!... ومما كنت أعاني منه في سنوات دراستي للموسيقى، انتشار السم في جسمي المؤدّي إلى تيبّس الأوتار والأعصاب والعضلات، ودخول مادة السم في كل الأنسجة والعضلات، بحيث صارت مكوِّنا من مكوناتها. وكان من أثر هذا الانتشار العجيب للسم، ضيق مجال الإبصار لعينيّ، وزيادة سمك الغشاء الطبلي لأذنيّ. أما دماغي، فأنا لا أعلم إلى الآن كيف بقي يعمل بصورة عادية (أو شبه عادية) بالنظر إلى غيري من الناس، مع يقيني بتسرب السمّ إليه هو أيضا؛ فأما تيبّس أوتار يديّ، فقد صار يجعل العزف صعبا عليّ المرة بعد الأخرى؛ حتى كنت في بعض الأحيان أجد من يديّ عصيانا لما أريده منهما؛ ومع هذا، فربما كنت العازف الأول في المستوى الذي أدرس به في المغرب. وأما أثر سمك الغشاء الطبلي، فقد وجدته في مادة الإملاء الموسيقي، حيث كان الأستاذ يقوم بالعزف، ونحن نكتب على المدرج اللحن المعزوف. كانت نقطتي في مادة الإملاء آخر نقطة، مع أنني في الصولفيج والنظريات والعزف (على صعوبته عليّ) كنت في المقدّمة. ومن فرط سذاجتي، لم أكن أعرف السبب في عدم تمكني من تمييز الأصوات، إلا منذ سنوات قليلة من الآن فحسب؛ وهو ما يجعلني مقاربا في الحال للموسيقي العالمي "بيتهوفن" في آخر عمره. وهذا يعني، أنني كنت أجهل نفسي، ولا أجد أسبابا ظاهرة لما كنت أعيشه في جسمي وفي قلبي؛ علمت فيما بعد أنه كان من عناية الله الخاصة بي. وأعني من هذا، أن الله قد خلقني له سبحانه، لذلك رغم سيري وقتيا في عدّة طرق، إلا أن نهايتي كانت محتومة، وهي: الانقطاع عن تلك الطرق، واحدا بعد واحد؛ بعد أن أكون قد استخلصت زبدتها. وإن لهذه الحال العسيرة، مدخلا فيما سينعكس على إنتاجاتي العلمية والفنية، في آخر الزمان، بما لا يستطيعه أحد من المتخصّصين...
***
لم يلبث الأساتذة المتخصصون أن تقاطروا على معهدنا، الذي كنت أمنحه جلّ أوقاتي واهتمامي: فكنت بمجرّد أن أنتهي من تدريس حصة الصباح على الساعة العاشرة، أتوجه بعد خروجي مباشرة إلى المعهد؛ وكذلك كنت أفعل بعد أن أنتهي من حصة تدريس المساء على الساعة الرابعة؛ وكنت أختار دوما هذه الصيغة من "استعمال الزمان"، لأتمكن من الجمع بين التدريس والدراسة. وكنت أفعل ذلك يوميّا، ومن دون كلل، رغم مرضي المتزايد... تعرّفت في المعهد على الأستاذ (ع.م) الذي سيصبح أستاذي في مادة العود، وعلى الأستاذ (بلعيد عكاف) الذي كان أستاذا لمادة القيثار الكلاسيّ بجوارنا؛ فصرنا أصدقاء بعد مدة يسيرة، حتى إنه كان يزورني حيث كنت أسكن مع زملائي في "العوينات"، كما زرته أنا في بيت زوجته التي كانت أختها زميلتي في التدريس مرة أو أكثر. ثم تعرّفت على الأستاذ الركراكي الذي كان أستاذا للكلارينيت، ثم الأستاذ الغزاوي الذي خلف عكاف في تدريس القيثار، وأكمل معنا دراسة الصولفيج، إلى أن صرنا نقرأ المفاتيح السبعة كلها قراءة فورية... كنت أظنّ أنني بعد أن تركت دراستي العادية، قد وجدت البديل الذي يروي ظمئي إلى الحقيقة؛ وهذا لأنني بفطرتي كنت لا أرى أيّ دراسة إلا موصلة إلى معرفة الحقيقة بقدرٍ ما، ما لم يحد القائمون عليها عن الحق. وبالتبع لاعتقادي، فإنني كنت أشترط في الموسيقيّين عموما، والأساتذة خصوصا، أن يكونوا على أخلاق عالية في معاملاتهم؛ فالموسيقى لم تكن عندي أقل من الدين عند أهله؛ حتى إن زميلي في التدريس (م. ز)، كان يوما جالسا على الأرض وأنا أعزف على العود وأنا أجلس على كرسي، فخاطبني: - يا فلان، أنت شخص طيّب، ولا ينقصك إلا أن تصلي!... فأجبته على الفور من دون أن أتوقّف: - أنا، هذه هي صلاتي!... نعم، كنت أظن ذلك؛ خصوصا وقد صدّقت التعريفات التي يتفوّه بها الموسيقيّون، مما هو من قبيل: الموسيقى غذاء الروح، وهي تهذّب النفس بحيث قد يصير صاحبها من حكماء جيله على الأرض؛ وهيهات!... فما بلغت سنة التخرّج، وبدأ صيتي يتسع بولوجي مجال التلحين، حتى انهالت عليّ الضربات من كل جانب... هذا هو ما سيجعل خيبة الظنّ تصيبني هذه المرة في الموسيقى، عندما انقلب الأساتذة عليّ وصاروا يؤذونني إيذاء مقصودا ولا شُبهة فيه. وهذا لأنه لو لم يكن الأمر فجّا، ما كنت لأُدركه مع سذاجتي وحسن ظنّي...
***
وقبل أن أستمر في سرد حكايتي مع أساتذة الموسيقى، ينبغي أن أذكر أنني كنت على تعظيم لكل من يعلّمني شيئا، بصفة رسمية أو بصفة غير رسمية. ورغم كل شيء، فإنني لم أكن أفهم أسباب انقلاب من كانوا يعرفونني، وإن كنت أصرّ على عدم تنازلي في المقابل، عن مبادئي، وإن وقع ما وقع!... ومما وقع من ذلك، ترسيبي في امتحان التخرج في مادة العود؛ وقد كان ذلك الترسيب عمدا، لأنني كنت أمهر من يعزف من بين الطلاب المغاربة، الذين يحجّون إلى قاعة الحاج أبا حنيني بمقر وزارة الثقافة بالرباط، رغم تشنج عضلاتي وأعصابي. وهذا يعني أنني كنت أمهر مما كان يبدو عليّ، لأنني كنت كمن يسبق منافسيه في السباق، مع كوني أجر معي ثقلا لم أكن قد تبيّنته بعد، ولا كان منافسيّ سيطيقونه لحظة...
***
كنت أحرص على أن أكمل دراستي الموسيقية النظرية والتطبيقية في المغرب، وكنت أنوي أن أذهب إلى العراق لأجل استكمال بعض التقنيات على يد الأستاذ "منير بشير"، ثم أعود بعدها إلى فرنسا لدراسة "الهارموني"، فقد كنت أتلمّس فقر الخط اللحني العربي إلى تعدد الأصوات، قُبيْل مباغتة العولمة لنا. لكنّني كنت على وعي بأن قواعد الهارموني العربي، لا بد أن تخالف -ولو جزئيا- القواعد الغربية؛ فكنت أتهيّأ لمواصلة أبحاثي بهذا الخصوص. ولقد كان الأستاذ عكّاف على دراية برغبتي هذه، وهو ما كان يجعله يخوض معي في بعض قواعد الهارموني أحيانا. وقد كان هذا المخطّط يتطلّب منّي ألا أجتاز امتحان الترسيم في التعليم الابتدائي الذي كنت قد أمضيت فيه سنتيْن بصفة مؤقّتة، وزدت الثالثة التي كنت أتوقّع أن أسافر بعدها مباشرة. ولكنّ مشيئة الله، كانت مخالفة لما كنت أظنه أنا... لم يكن يخطر ببالي أن أبقى موظّفا تابعا لوزارة التعليم. وحتى الأستاذ (أ.ع)، والأستاذ (م. أبو درار) اللذان وعداني أكثر من مرة بإلحاقي بوزارة الثقافة (détachement)، حتى أتمكن من تدريس الموسيقى، لم أنفعل لكلامهما، ولا كنت حريصا على ذلك، لعلمي من جهة غيبي، بأن أموري لا تسير وفق ما يعتاده الناس من أنفسهم؛ وإنما هي تخضع لمنطق خاص، سأعرف فيما بعد أنها التربية الربانية؛ فأنا قبل أن أعرف التربية السلوكية بالمعنى الاصطلاحي، كانت حياتي كلها تربية على عين الله، والحمد لله... قبل أن أُنهي دراسة العود، كنت قد بدأت التلحين؛ ولكن بما أنني كنت أطمح إلى استكمال دراستي الموسيقية إلى النهاية، فإنني ما كنت أعتبر ذلك كثيرا. ومن عجيب المصادفات (ولا عجب!)، أن أول قصيدة لحّنتها، كانت قصيدة البردة للشاعر المخضرم رضي الله عنه: كعب بن زهير، والتي مطلعها: بانَتْ سُعادُ فَقَلْبي الْيَوْمَ مَتْبولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَها لَمْ يُفْـــــــــــدَ مَكْبــــــــــولُ وهي -كما يعلم الجميع- قد قالها الشاعر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي مسجده. ولم أكن حينئذ أربط بين خصوصيتي عند الله وبين هذه القصيدة، لأنني كنت من جهة الظاهر بعيدا عن التديّن، على ما كنت عليه من قوة الفطرة. ولمـّا كنت أعامل أستاذي في العود (كما كان يعاملني) معاملة الصديق، فقد أطلعته على لحني، فرأيته -بعكس ما كنت أتوقّع- ينظر إليّ باندهاش؛ ثم استنتجت فيما بعد أنه قد أخبر مدير القسم الموسيقي بالمعهد، لأنني فوجئت به ذات صباح يُناديني، ويُدخلني معه إلى قاعة البيانو، يطلب مني الجلوس إلى جانبه على كرسيّ هناك. فأطعته، وأنا الذي كنت أحترم أساتذتي احتراما جمّا؛ فبادر بإطلاعي على ورقة، أخبرني بأن القصيدة المكتوبة عليها، كانت مكتوبة بخط يد صاحبها: الشاعر المغربي محمد الحلوي. جلس الأستاذ إلى البيانو، وهو يعزف التوافقات الأولى، ثم أسمعني المقطع الأول بغنائه (وهو كان يفتقد للصوت المؤدّي بله المغني)، وسألني عن رأيي. أنا لم أكن لأُبين عن رأيي، أمام أستاذي؛ ولم أكن أسمح لنفسي بأن أنظر في اللحن بعين نقديّة وأنا من لا يزال في نظر نفسه تلميذا، فكنت أرد: - جيد... ويسأل هو مرة أخرى: - ما رأيك؟... وأجيب أنا مرة أخرى: - جيد!... فتيقّن الأستاذ أنني لن أقول شيئا، وأظنّه لم يكن يُدرك دافعي، فأشار إليّ بالانصراف، وهو يُخفي بعض التّبرّم؛ فخرجت من القاعة، وأنا أتوقّع أن تنتهي القصة عند هذا الحدّ؛ ولكنني كنت مخطئا كعادتي... لقد فهمت بعد سنوات عديدة، أن الأستاذ كان يبغي أن أساعده على صياغة اللحن في أبهى حلّة، ما دمت أنا قد كنت متخصّصا في الموسيقى الشرقية، التي لا يتمكّن هو من أن يملك أسرارها، وهو من اعتاد على الموسيقى الغربيّة الكلاسيّة... وربما قد وجد الأستاذ في تصرّفي إعلانا عن تحدّيه، وإصرارا على ذلك التحدي باستقلاليتي بنفسي في مجال الألحان. نعم، أنا كنت كذلك؛ لكنّه لو أوضح لي الأمر، ما كنت لأتخلّف، من باب الأدب معه... ولكن الله يفعل ما يشاء!... ربما قد سبق ذلك بشهور، ذهابي إلى مقرّ الإذاعة الوطنية، بأول لحن لي أقدّمه لها، برجاء أن تتم الموافقة عليه، لأغنيه بمصاحبة الجوق الوطني الذي كان يترأسه آنذاك الأستاذ: عبد القادر الراشدي. كان عليّ أن أقدّم اللحن، ليُعرض أمام لجنتيْن معروفتيْن لكل من غنّى للإذاعة، وهما: لجنة الكلمات، ولجنة الألحان. وبما أن القصيدة التي لحنتها قد كانت لإيليا أبي ماضي (بعنوان النهر)، فإنها ما كانت تتطلّب موافقة لجنة الكلمات، وبقيت أمامي لجنة الألحان وحدها، والتي كان يترأسها الأستاذ أحمد البيضاوي، الذي كان يترأس في الآن ذاته قسم الموسيقى كله بالإذاعة... كان كل ذلك يتطلّب منّي أن أذهب إلى مقر الإذاعة بنفسي، وأنا من كنت لا أرغب في التنقل، بسبب تفاقم مرضي، وبسبب بعض بداوة ما تزال تحكم تصرفاتي. ولكنّني مع ذلك، عملت على الاتصال بابن عمّ والدي (م.ع) الذي كان يعمل ممرضا للتخدير بالمستشفى العسكري "محمد الخامس". قصدت ابن عمّي في مدينة سلا، وكنت قد اصطحبت اللحن معي مكتوبا بالنوتة، وبعد التعرف على مقرّ الإذاعة، وعلى مكتب الموسيقى، تحيّنت وجود الأستاذ أحمد البيضاوي يوما، فدخلت عليه متأدّبا. سلمت عليه، وأخبرته بمشروعي وأنا أضع "البارتيسيون" أمامه؛ فرفع إليّ طرف عينيْه من خلف نظّارته قائلا: - يا سيّدي، نحن لا نعمل بهذه الطريقة؛ نحن لا نقرأ النوتة... فسألته: فما الذي عليّ أن أفعله؟.. فأجاب على الفور: - عليك أن تسجّل اللحن على شريط كاسيت، ثم تأتينا به حتى تتمكن اللجنة من الاستماع إليه... ودّعت الأستاذ مسرعا، وخرجت أفكّر في كيفية تسجيل الشريط، وأنا الذي لم يحمل معه من بلدته سوى عوده. وعندما عدت إلى بيت ابن عمّي -وقد كان مهتما بكيفية سير الأمور- أخبرته بأنني محتاج إلى جهاز تسجيل؛ فعرض عليّ فورا إمكان استعارته لمسجّلة من أحد معارفه، وهكذا أستطيع تسجيل اللحن في بيته الذي كان فارغا حينئذ، بسبب سفر والدته وشقيقتيْه. فجلست في أحد الأيّام أسجّل اللحن على شريط كاسيت، مما كان رائجا في ذلك الزمان، وذهبت في يوم الاثنين الموالي إلى قسم الموسيقى بالإذاعة الوطنية، وانتظرت خارجا، إلى أن رأيت الكاتبة التي سبق أن شاهدتها تجلس في مكتب الأستاذ البيضاوي، خلف مكتب بجانب النافذة. فتقدّمت إليها أسألها بقرب الباب: - هل سيفتح قسم الموسيقى الآن؟... فلم تردّ عليّ، وإنما دلفت إلى البهو الذي يفصل المدخل عن باب المكتب، فتبعتها. وكم كانت دهشتي عندما انهالت عليّ الكاتبة بسيل من عبارات اللوم، وأنا واقف لا أكاد أتبيّن الأمر. قالت: - لمَ سألتني قبل أن أدخل إلى المكتب؟... وما الذي كان سيحصل لو رآك زوجي وأنت تخاطبني؟... وهو الذي كان قد أوصلني بسيارته إلى مقرّ عملي: فما أدراني لو أنه كان ما زال لم ينصرف بعد؟... في هذه اللحظات، كان قد تعطّل منّي التفكير؛ لأنني أُدخلت إلى أمر لم يكن يخطر لي على بال، وأنا من كنت مشغولا بعرض الشريط على اللجنة، منتظرا لقرارها بلهفة غير حقيقية. لكنني بعد أن استرددت وعيي، قلت في نفسي: - هذه العبارات كان يمكن أن تتكلم بها نساء القرى المتحجّبات، واللائي لا يقبلن بمخاطبة الغرباء لهن؛ أما هذه الشقراء التي ترتدي تنورة قصيرة في قلب العاصمة الرباط، كيف لها أن تزعم أنها لا تقبل أن يُخاطبها الغرباء؟!... وفيمَ خاطبتها أنا؟... في شأن يخص عملها، لا في أمر آخر... ثم: لقد كانت هي -كما يبدو- تقارب سنّ الأربعين، وأنا كنت ربما في التاسعة عشرة من العمر؛ وهذا يعني أنني لن أجرؤ على التفكير بها إلا ضمن كل معاملات الاحترام، خصوصا وأنني كنت من الناحية العقلية أشبه الغربيّين؛ أي لم أكن شرقيّ التوجهات العقلية، المنصرفة في الغالب إلى الغرائز، بل كنت أنظر إلى المرأة نظرة الندّيّة، لا أُطالبها إلا بما تشترطه المواضيع والأوضاع من شروط منطقية، بحسب مختلف السياقات... لم تلبث المرأة أن انقلبت بعد موجة الغضب المفتعلة، تخاطبني بكل لطف: - ما الذي تريده؟... فأخبرتها أنني قد أتيت في المرة الماضية، وأن الأستاذ قد طلب منّي أن آتيه بشريط كاسيت أكون قد سجّلت عليه لحني. فسألتني: - وهل أتيت به؟... فأجبتها بالإيجاب، وأنا أمدّ إليها يدي بالشريط. فقالت: - الأستاذ غائب، وأنا سأحتفظ بالشريط حتى أعطيه إياه عند عودته. هو مسافر مع "سيدنا" (تقصد الحسن الثاني) إلى مدينة إفران، وإن شئت أنت، نلتقي هناك جميعا غدا (الثلاثاء)... كنت أنا أتلقّى كلماتها، وكأنها من عالم آخر؛ لأنني لم أكن أجد الرابط المنطقي ضمن كل ما سمعت؛ فودّعتها وخرجت وأنا أقول في نفسي: - الرباط هذه مختلفة عن كل المغرب الذي أعرفه. والحمد لله أنني قد خرجت سالما من عند هذه المرأة... وأين أنا من الملك؟!... لم أكن معارضا للملك، وأنا من لا يزال لم يخط خطوة معتبرة خارج العشّ!... ولكنّني لم أكن أعلم أيضا، أن الناس سيفسّرون رفضي لمساعدة أستاذي في تلحينه لأغنية وطنية؛ على أنه معارضة سياسية. وقد زاد من ترسيخ هذا المعنى، رفضي لزميل لي في المعهد، أُرسل إليّ برسالة مفادها: - يقولون لك: هل تقبل أن تغنّي أغنية وطنية يقومون "هُمْ" بتلحينها؟... (من دون أن يُفصح). فأجبت بالنفي، لا من منطلق سياسي؛ ولكن لأنني لم أكن أطمح إلى احتراف الغناء، بعد الذي علمته من مدى تخلّف مجتمعي. كل هذا، قد انضاف من دون أن أدري، إلى رفضي لدعوة عامل الإقليم لغرض تنشيط احتفال عيد العرش (في زمن الحسن الثاني)، وإلى رفضي لرسالة "القائد" مع والدي، الذي كان يعمل وقتها تحت إمرته بمكتب "جوازات السفر"، والتي جاء فيها صراحة: - إنهم لن يسمحوا لك بالتقدم في الموسيقى، إن لم تعمل على إنتاج أغنية وطنية!... فأجبت بسذاجتي المعهودة: - لن أفعل!... فبقي والدي فاغرا فاه، وهو لا يكاد يتصوّر أن ابنه الضعيف، يواجه بصلابة "المخزن" الذي يُخلص له العبادة هو وأمثاله، ومن هم أفضل منّي ومنه... لم أكن أعلم عن المخزن في تلك السنّ شيئا، وكنت ما زلت أتوهّم أنني إذا التزمت بدراستي من دون أن أعتدي على أحد، فلن يعترض طريقي شيء؛ وهيهات!... لقد عومِلت وكأنني معارض سياسي خطير، مع أنني لم أكن أمارس شيئا آخر غير الصدق (بيني وبين نفسي، وبيني وبين الآخرين)؛ لكنني استنتجت بعد سنوات طويلة، أنني ربما كنت مسجّلا ضمن كبار المعارضين لنظام الحكم. وسيأتي ما يؤكّد هذا الاستنتاج مما سأعرفه من أحداثٍ في مستقبل أيامي... |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.