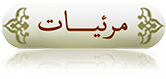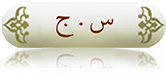اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 | 
2025/10/18 رحلتي إليّ (إلى التسميم الثاني) -4- إلى التسميم الثاني
جاء موعد امتحان الباكالوريا في شهر يونيو من سنة 1976، ولم يعدُ كونه فيما يخصّني تسجيل حضور لمرة واحدة؛ لأنني لم أعد بعد الرسوب لاجتياز الدورة الثانية من الامتحان. وكان هذا الرسوب أول رسوب أعرفه في مساري الدراسي كلّه، والذي كان نموذجيّا في التفوّق. كنت أخرج قبل انتهاء مدة أي مادّة، إلى الساحة، حيث أجد نفسي وحدي، وأنا أعيش الانسلاخ في باطني، عمّا كنت أظنه قبلاً طريقي الانسيابي الحافل بمراكمة النجاحات تباعا ومن دون عناء. كان هذا الانسلاخ، أول صنوف الموت التي سأعرفها في حياتي المليئة بمعاني الموت. أذكر هنا تعدد الموتات، قياسا على ما يعرفه الصوفية من ذلك في أثناء سلوكهم؛ فالكامل عندهم من مات بكل اعتبار. ولسنا هنا بمعرض الكلام عن معاني الموت في التصوف، لذلك سنضرب عنها، تعويلا على تكميل القارئ لمثل هذه الثغرات بنفسه، ومن مظانّها... كان يزيد من تأكيد موتي في طريق التحصيل العلمي الكسبي، استغراب من كانوا يعرفونني؛ فهم على الأقل كانوا ينتظرون مني إعادة المحاولة. وحتى أبي الذي ربما كان ينتظر أن يقطف ثمار إكمال تعليمي، بالصورة التي تناسب إدراكه، لم يلحّ طويلا أمام قراري الانقطاع عن الدراسة؛ وبقي يرقب عيشي وكأنه متفرّج حيادي، لا يعنيه الأمر كثيرا... أما والدتي وجدتي، فقد عاشتا معي موتي، وهما ترددان بين الفينة والأخرى همهمات تعبّران فيها عن شدة نقمتهما من أعداء، لم أكن أنا قد تبيّنت وجودهم بصورة كافية بعد... عدت إلى مدينة جرادة، وصرت أعمل على تمتين الصلة بقريبي (ب. م)، الذي كان يعيش على هامش المجتمع المحلّي، حياة الانحراف الذي يكون عليه المنقطعون عن الدراسة من أقراننا. كان يعيش ضمن مجموعة قد تكبرنا قليلا في السنّ، وكان ضمن هذه المجموعة كتّاب وقتيون يعملون في مكاتب "رئاسة الدائرة" (الباشوية اليوم)؛ حيث كان والدي يعمل كاتبا بمكتب "الحالة المدنية" منذ بضع سنوات. فكنت أنا بمعاشرتي لهم، والتي لم تكن إلا جزئية، وبسبب عدم توافقي معهم باطنيّا وظاهريّا على التمام، أروم معرفة المجتمع من وجهه الآخر المعتم، بعد أن كنت لا أعرف إلا وجهه الذي تحت الشمس. كان إصراري على معرفة ما غاب عنّي، طلبا لاستكمال التجربة الذوقية لما يُسمّيه أهل الطريق "جاهلية" في حق الواحد منّا، وإن كنت لا أميّز التفاصيل بعد. ورغم أن مصطلح "الجاهلية" هو بالاعتبار الأول مصطلح شرعي قد ورد به القرآن الكريم في مثل قول الله تعالى: {وَقَرۡنَ فِی بُیُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَـٰهِلِیَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ} [الأحزاب: 33]، فإن الثقافة الإسلامية العامة، قد جعلته منوطا بالجاهلية التاريخية التي سبقت البعثة الشريفة حصرا. ففقد المصطلح مدلوله الشرعي السلوكي، الذي يعني جميع أفراد المؤمنين، وكاملي الإيمان خاصة. وأنا هنا أميّز بين أهل الكمال وغيرهم، من صالحي الأمة الذين عاشوا على موافقة الشريعة مع بدء سنّ تكليفهم؛ بل إن منهم من وافق الشريعة من قبل سنّ التكليف إن تربّى في بيت علمٍ وتقوى. وهؤلاء بالمقارنة مع الأولين الموصوفين بكمال الإيمان، يكونون نظراء للملائكة الذين {لَّا یَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَاۤ أَمَرَهُمۡ وَیَفۡعَلُونَ مَا یُؤۡمَرُونَ} [التحريم: 6]؛ وأما من تسبق جاهليتهم إسلامهم، فإنهم يكونون على صفة أبيهم آدم عليه السلام خليفة الله الذي جاء فيه: {وَعَصَىٰۤ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ} [طه: 121]، ثم جاء في حقّه بعدُ: {فَتَلَقَّىٰۤ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَـٰتٍ فَتَابَ عَلَیۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِیمُ} [البقرة: 37]؛ وهذا الصنف أكمل من الصنف الأول من غير شك، وإن كانت العامة ينفعلون لأمور الظاهر أكثر من الباطن. وهذا العلم مجهول لفئة الفقهاء الذين يخترعون لأنفسهم طريقا نظريّا، لا يذوقون فيه شيئا من ثمار الإيمان الأصلي. وحتى نقرّب إلى القارئ هذا التفريق بين الفريقيْن، فلنجعل فريق السالكين، نظراء للجنود الذين ينخرطون في الجيوش، ويُعانون قتال الأعداء، مع ذوق الصعاب في أثناء ذلك، واجتراع الآلام. وهؤلاء يُرقَّوْن بعد عودتهم إلى إدارتهم المركزية، إلى الرتب العليا من مجموعتهم، ويُمنحون الأوسمة الفخرية ويتسلمون الشهادات على رُتبهم. وقد يصيرون بعد مدّة، مدرِّبين لغيرهم (شيوخا للتزكية الدينية)، كما قد يصل الأفراد منهم (الألوية والأفرقاء) إلى قيادة القوات المختلفة من أرضية وبحرية وجوية، وغير ذلك من التخصصات المكملة لهذه الأركان الأصلية. وأما الواحد الذي يصير قائدا عاما للجيش، فإنه يكون نظيرا في طريق الله للقطب الغوث الذي تعود إليه مقاليد الحكم كلها إجمالا وتفصيلا. وقد يكون رئيس الجيش رئيسا للدولة في أحيان كثيرة، وهذا يُشبه ما يكون رئيس دولة المسلمين عليه إن صحت له الخلافة الربانية، كما هو شأن الخلفاء الاثنَيْ عشر على امتداد عمر الأمة... ومن طبقة السالكين أيضا، من يكونون نظراء لأصحاب المناصب المدنية في الدولة؛ ومن هؤلاء الشطر الأكبر من شيوخ التربية ومن على قدمهم من السالكين. وأما غير السالكين من الأمة، فهم نظراء لعموم الشعوب، وقد يكون منهم علماء الدين وأتباعهم؛ وهؤلاء هم السواد الأعظم للمسلمين في جميع الأزمنة... وقد أشار أحد كبار خلفائنا، وهو عمر الفاروق عليه السلام، إلى مكانة ذوق الجاهلية في حقّ الكامل، فقال: "ما عَرَفَ الْإِسْلامَ، مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجاهِلِيَةَ!"، وقد أخطأ شطرَ معنى الكلام، كلُّ من حصر الجاهلية في الجاهلية العامة السابقة للبعثة المحمدية الشريفة؛ لكونهم ما تصوّروا أن يكون المسلم في بعض عمره على جاهلية ينطبق عليها المصطلح حقيقة. وإذا علمنا مدلول العبارة العمريّة، فإننا سنعلم أن لكل سالك من خواصّ هذه الأمة، جاهلية تخصّه، ولا يُستثنى منها ظاهرا إلا بعض خواص الخواص، من جهة صور المخالفات، لا من جهة معناها وحقيقتها. وهذا، كما يدل عليه سبق الفتح في حقّ بعض أئمتنا، من دون تحقيق شروط التربية المطلوبة؛ فيُضطرّ العبد الخاص بعد الفتح إلى تدارك ما فاته من تفاصيل التربية؛ وهكذا، فإن الجاهلية فيمن هذه حاله، لا يشعر بها إلا هو، وأما سواه من الناس فإنهم لا يشهدون له إلا بالتقوى في سابقه وفي لاحقه. وأما أنا، فإنني قد سرت في طريق الظلمة بحسب الظاهر ما يُناهز ثلاث سنين أو يزيد قليلا؛ وهي المدة التي خصصتها لدراسة الموسيقى كما سيأتي...
***
عندما عدت إلى الرفقة الطالحة في الشهور التي تلت قرار انقطاعي عن متابعة دروسي، ما لبثت أن انخرطت في مشاركتي لهم فيما كانوا عليه، ما لم يكن ذلك مخلا بالحياء. كنت أريد أن أجرّب طريقهم -بعد فقدي للمعايير- لعلّي أظفر ببعض ما يبدو على رفاقي من طمأنينة وهناء؛ وهيهات، فقد كان الجدّ الذي يسكنني، يُفسد عليّ طلبي للغفلة؛ وهو ما كان يزيد من همّي، وكأنني لست من طينة مَن كانوا حولي... وهذا، لأنني لم أتصوّر قطّ أني مميّز عن غيري!... فكانت عندما تسوء أحوالي، أوقن بأنني أقل من كل الآخرين؛ إلى الدرجة التي صرت معها لا أشكّ في نقصي. وكان يزيد من رسوخ هذا الحكم في ذهني، عمل الآخرين على تجاهلي والزهد في صحبتي... كان يجمعني مع رفاقي، ميولنا المشتركة نحو الموسيقى التي كنت قد عزمت فيما بيني وبين نفسي أن أجعلها البديل عن الدراسة النظامية. زعمت لنفسي، أنني كنت أبحث عن الحقيقة في المؤسسات التعليمية فلم تُفلح هي في أداء مهمتها إزائي، ولا أفلحت أنا في بلوغ مرامي منها، فوقع الطلاق من الجهة الرسمية بائنا. وعندما كنت على تذوّق للموسيقى (رغم معاناتي من التسميم) لم يبلغه أحد ممن عرفتُ من الناس في طريقها فيما بعد، صرت أحضّ رفاقي الجدد على تعلّم العزف على آلات التخت العربي قدر مستطاعي، وكانت الغاية إنشاء فرقة قادرة على إقامة حفلات تسدّ الفراغ الذي يشكوه مجتمعنا. لكنّ أصحابي، كانوا ضعيفي الهمة، لا يكادون يهتمون بإتقان شيء، باستثناء (ب.م) الذي كان يبغي حفظ مجموعة من أغاني الصنف الشعبي الجزائري، ليتخذها -كما بدأ يفعل بعد مدة قصيرة- سببا لطلب الرزق عن طريق إحياء حفلات الأعراس والختانات وما شابهها. أما الآخرون، فإنهم كانوا يختارون أوقات تماريننا، لكي يدخنوا أو يشربوا شرابا فرديا ينزوون به بعيدا عنّا... تعرفنا في ذلك الوقت على بعض الطبوع الأندلسية الجزائرية، وصرنا نردد بعض قصائد "أبي بكر بن زرقا" وبعض أغاني "أحمد وهبي" ذات الطابع الوهراني. كان هذا الصنف من الغناء مطلوبا في شرق المغرب، على ما به من يُسر في التعلّم، إن هو قورن بالأعمال الشرقية الكلاسيّة (هذا أفصح من الصيغة الشائعة)...
***
انضم إلى فرقتنا، أحد المكلفين بالتدريس في المستوى الإعدادي، وكان الوحيد بيننا من له راتب شهري متوسّط؛ وهذا، لأن أصحابنا الذين كانوا يعملون وقتيّا في الإدارة التابعة لوزارة الداخلية، كانوا يأخذون أجورهم دقيقا وزيتا...، من إدارة الإنعاش الوطني المعلومة للمغاربة. قام هذا الأستاذ بشراء آلة عصرية لقراءة الأسطوانات وأشرطة الكاسيت، لنتمكن من سماع ما نريد تقليده جيدا؛ ثم اقتنى عودا لنفسه، كما كنت أنا أحتاز عودي منذ أن جاءتني به جدّتي كما أخبرت سالفا. ثم زاد كمانا جاهرا، كنت أنا من يعزف عليه، عندما يكونون هم من يغنون أغانيهم. وبما أنني أعسر، فقد أُجبرت على العزف على الكمان بطريقة معكوسة؛ لكن جلستي على الكرسي ما كنت أتمكن مع الثقل الذي نجم عن السمّ الذي تناولته، أن أجلسها مستقيمة؛ بل كنت أجلس على طرف الكرسي، لأتمكّن من وضع كتفي بكل ثقلي على ظَهْرِيَّتِهِ، في وضعية تلفت انتباه الناظرين إليّ من غير شك؛ حتى إن أحد من كان من مجموعتنا، كان يلاحظ عليّ ذلك؛ ولكنه كان يظنّ أنها جِلسة اخترتها من باب الترف أو ربما الدلال؛ وأنا لم أكن أجد ما أرد به على الملاحظات، بل لا أتوقف عند هذه الملاحظات البتّة، وأنا من كان قد فقد كثيرا من التعلق بالأشياء، وكان في طريق فقد ذلك التعلق جملة واحدة!... قد لا يتمكّن أحد من التسليم لي بما أقول، خصوصا إن قاس ما يقرأه هنا، على ما يعرفه من مراحل حياته هو، إذ لا اشتراك!... ومن كان يذكر من القرّاء قولي بأنني قد وُلدت على الولاية ومعرفة الحق، فإنه سيجد رابطا بين ذلك في حينه، وبين صنف الخطاب الآن. وقد زاد صدق لهجتي من نفور الناس من حولي، باطّراد كل مرّة. ومع هذا، فما كنت أعترض على أحد في خطابه، لأنني أعلم أنني غير مأذون (فيما بيني وبين نفسي) في تقييم كلام غيري ما لم يكن يخصني، وكنت أسعهم وأترك لهم أن يختاروا ما يشاؤون من أساليب المعاملات التي يرتضونها لأنفسهم. ثم، إنني كنت في بدايتي منشغلا بنفسي، وأنا الذي لم أفرغ منها بعدُ حتى أتوجه بالتقييم إلى غيري... وكان من أفراد فرقتنا، رجل من قبيلتنا، يسبقنا في العمر بجيل. كان هذا الرجل يعاملنا ككبير لنا، وكان تخصصه في الفرقة "العزف على آلات الإيقاع"، أو هكذا كان يُفترض. وقد ساهم هذا الأمر في الحرص على الجد في أغلب ما كنا نأتيه، وهو ما منعنا أن نسقط فيما كان يسقط فيه بعض أفراد الفرقة من سفالة خارج اجتماعاتنا. وهذا الشأن كان يُناسبني، لأنني كنت جادا في أموري منذ صغري، ولا أقبل السفاسف، رغم هذه التجارب التي وقعت فيها من باب الفضول وتحقيق الأهلية في نفسي للحكم على مختلف الأمور... كان هذا الرجل (م.د) طيبا على العموم، وحارسا لنا من الأضرار التي كان يُمكن أن نقع فيها، إن نحن قارنّا أنفسنا بأقراننا من مجتمعنا المتخلّف، وإن كان جلّ شبابه في ذلك الوقت من المتعلّمين. وكان هذا الحارس لنا، يعمل في شركة المفاحم تقنيّا كهربائيّا. وكانت له صلة بأحد رؤساء النقابات العمالية، الذي سعى لنا عنده، من أجل أن يمنحنا مقرّا نتدرّب فيه. فكان من نصيبنا "غارصونيير" (garçonnière)، تتكون من غرفتيْن مفتوحة إحداهما على الأخرى، ضمن مجمع (bloc)، كان في أصله سكنا للعزّاب من عمال المناجم. وكان السكن الذي إلى جانبنا بمحاذاة المدخل ذي الدفتيْن، مخصصا لمكتب رئيس النقابة، وللاجتماعات الصغيرة التي تعقدها النقابة. وكان وجودنا في غالبية الأوقات، وحدنا في تلك البناية الواسعة، يُعطينا شعورا بالاستقلالية، فكنا نمضي جل أوقاتنا في الليل هناك، من أجل التدرّب على بعض الأغاني والافتتاحيات الموسيقية. كنت أنا متخصصا في أغاني فريد الأطرش، التي كنت مضطرا لغنائها بمفردي، ما دام أصحابي لا يُتقنونها. وعندما كنا نُدعى إلى بعض الحفلات، كان يغلب على ما تقدّمه الفرقة الأغاني الشعبية المغربية والجزائرية، فكنت أنا أبقى متفرّجا لعزوفي عن الاشتغال بالموسيقى الشعبية في صورتها البدائية. وما كان يزيد من اندهاشي، هو التخلف في تذوق الموسيقى، الذي يكون عليه مجتمعنا، فزاد هذا من عزلتي داخل المجتمع، إلا من قلّة من رجال التعليم ومن التقنيّين التابعين لشركة المفاحم، أو للمعمل الحراري فيما بعد. ومع مرور الأيام، صار لنا جمهور يتابعنا في حفلاتنا أينما كنّا. وكان من أبرز هؤلاء المتابعين: معلم من الجيل السابق لنا، سأعرفه عندما أنخرط في مهنة التعليم لاحقا، وهو الأخ الأكبر لصديقي في طور المراهقة (أبو. الأ). كان هذا المعلم كوميديا بالفطرة، وكان على ثقافة مزدوجة تثري مجالسنا في كثير من الأحيان...
***
مرّت الشهور التي انقطعت فيها عن الدراسة، والتي صار السمّ الذي تناولته في سنتي الأخيرة منها، يتوالد ويتكاثر في جسمي، من دون حول منّي ولا قوة على الحد منه أو القضاء عليه. وهكذا سيحتل السمّ العضويّ جسمي كله، وبدأ لوني ينحو نحو الازريقاق، وبدأت عضلاتي تتيبّس شيئا فشيئا حول عظامي، لتأخذ فيما بعد أطراف جسمي شكل العظام ذاتها. ورغم أن جسمي لم يكن على هذه الشاكلة، إلا أني ظننت مع بلوغ هذه السن، أني قد صرت إلى ما ينبغي أن أكون عليه، ظنا منّي أن هذا كان تطورا طبيعيا لجسمي. وهذا لقلة علمي بما كنت أمر به، من آثار التسميم؛ حتى إن أحدا ممن كان يعرفني في طفولتي، لقيته بعد سنوات كثيرة، فقال لي كمن يُفضي إليّ بسر: - لقد تغيّرت كثيرا يا سيد فلان!... فأجبته على الفور: - ربما ذلك مما يطرأ على المرء عنما يكبر!... - فأصر، وهو ينظر إليّ نظرة ذات معنى: كلا!... ربما كان الرجل ينتظر مني أن أستزيد من شروحه، ولكنني أنا لم أكن مهتما بنفسي ولا حتى بمصيري؛ فوليت وجهي عنه متغافلا، ومنخرطا في الحديث الذي كان يدور بين مجموعة أشخاص آخرين حولنا... مرت هذه الشهور الأولى، وهي تشبه العطل الصيفية التي كانت تعقب وقت الدراسة في كل عام؛ فلم أشعر باختلاف الأمر عليّ، إلا بعد افتتاح السنة الدراسية الجديدة، التي لم ألتحق فيها بالدراسة بعد طلاقنا البائن. هنا بدأت أشعر بما لم أشعر به من قبل: وهو استثقالي أن أعيش عالة على أبي. فهو لم يُطالبني بشيء، وبقي يراقبني وأنا أخرج من البيت مساء، ولا أعود إلا صباحا؛ بحيث كنا نلتقي في كثير من الأحيان بالباب، حيث يكون هو خارجا وأنا داخلا. كان ينظر إليّ نظرة المتفحّص، من دون أن يقرّعني أو يعاتبني. وكان هذا يزيد من لوم نفسي ومن استشعار الحياء بإزاء وضع عائلتي الفقير مادّيّا، بعد أن توقّفت والدتي عن الخياطة. فبادرت إلى مراسلة بعض الجهات، وكانت تستجيب لطلبي إكمال دراستي عندها بدءًا من عملي بصفتي تقنيّا، مع إبقاء فرصة إكمال الدراسة لنيل شهادة المهندس إن توافرت الشروط. وكان من بين من استجاب لطلبي الالتحاق بهم: المكتب الشريف للفوسفاط، الذي أخفت والدتي رسالة قبوله، خوفاً عليّ من النساء كما قالت. قالت: إذا ذهب ابني إلى هناك، فلن أراه مرة أخرى. وقد كان هذا يحدث لبعض أقراننا، وتسمعه الأمهات، فيزداد خوفهن على أبنائهنّ. وممن وقع له ذلك، زميل لي في الدراسة كان قد انتقل إلى مدينة جرسيف معلّما، فما شعر إلا وهو متزوّج بامرأة، ابنتها تكاد تكون من عمره. والمحزن في الأمر، هو أنه أهمل أمه حيث تركها في قنفوذة (بين جرادة ووجدة) تعيش على ما يجود به عليها معارفها... استقر رأي والدي، وكنت حريصا على إرضائه، على انتسابي إلى التعليم. والتعليم آنذاك، كان يفتح أمامنا عن طريق التوظيف المباشر، إما أن نكون مكلّفين بالتدريس في المستوى الإعدادي، وإما أن نلتحق بالمستوى الابتدائي بمرتبة معلم بديل (instituteur suppléant)؛ فاخترت أنا العمل في المستوى الابتدائي، لصغر سنّي الذي لم يُجاوز الثامنة عشرة؛ حيث خفت أن تحدث المشاكل بيني وبين تلاميذ لا أكبرهم كثيرا. وحقّا، لقد كنت مرتاح البال مع صغار التلاميذ، وما كانت تأتي المشاكل في هذا المستوى، إلا من الكبار: زملاء العمل وهذا نادر بالنظر إلي، بسبب عزلتي؛ أو من المديرين والمفتّشين الذين كان يجدر أن يُنسبوا إلى الرتب السلطوية التي تكون لرجال الدرك أو لرجال الشرطة؛ وهذا لأنه لم يكن لهم من الشقّ التربويّ في عملهم إلا الحظ اليسير؛ باستثناء فئة قليلة العدد، كنت أنا أبجّلهم لجمعهم بين الكفاءة التربوية وحسن التوجيه في الدروس مع دماثة الأخلاق. أما الغالبية من هذه الطائفة، فإنهم كانوا "مخازنية"، يمسك بهم المخزن المجتمعات التعليمية، كما سيأتي تفصيل ذلك في حينه. وربما قد يأتي موضع أعدّد فيه سلبيات خضوع رجال التعليم للوظائف المخزنية غير المعلن عنها، وأذكر معها السلبيات التي تعود معها على رجال التعليم أنفسهم، ثم على التلاميذ بالتّبع. وهو ما نراه العامل الأول في فشل منظومة التعليم منذ سنوات الاستقلال، وتفاقم ذلك الفشل الذي صار عجزا وإعاقة محقّقَيْن إلى اليوم...
***
سررت كثيرا لموافقة أمر توظيفي لرغبة والدي، الذي كان يُذكّرني بإمكان تسلّق درجات الترقي في هذا المجال بسهولة كما أريد. وعندما جاءني الرد على مراسلتي لنيابة (مديرية التعليم) وجدة، يُخيّرني بين الالتحاق بمستوى الإعدادي أو بمستوى الابتدائي، أخبرتهم بأنني أفضل المستوى الابتدائي، فعيّنوني معلّما بديلا، تابعا لمجموعة مدارس النعيمة. ولما ذهبت إلى المدرسة المركز، وجدتهم قد ألحقوني مدرِّسا لاثني عشر تلميذا، شطر منهم في المستوى الثالث والشطر الآخر في المستوى الرابع؛ وكنت سأدرّس الرياضيات واللغة الفرنسية في شطر الحصة، وأدرس اللغة العربية في الشطر الثاني؛ وكأنني أدرّس أربعة أفواج، بينما لا يُكلَّف معلِّمو المدن إلا بالتفرغ لمستوى واحد ومادة واحدة، وإن قُسم التلاميذ مع ذلك إلى فوجيْن... وهكذا بدأت مدرسا للرياضيات ولمبادئ اللغة الفرنسية مع اللغة العربية، في مدشر لقبيلة الزكارى يُسمّى "الحاسي الأحمر". كان معنا في المدرسة معلم يسبقنا في التجربة، طيب القلب، وكثير المساعدة لي؛ إذ كنت لا أزال لم أتوصل من الوزارة بأي راتب. وكان معنا معلّم رسميّ آخر، يدرِّس المستوى الخامس (السنة النهائية في ذلك الوقت): العربية والفرنسية؛ وكان شخصا محترما، يعتني بدروسه عناية مثالية. لكن قدومي إلى التدريس بعيدا عن بيتي، ومن دون تلقٍّ لراتب أستعين به على متطلَّبات معيشتي، زيادة على أن المدشر لم يكن به إلا دكان واحد، لا يشتمل إلا على المواد التي يبتغيها السكان منه؛ علما بأن هؤلاء يأتون بأغلب طلباتهم من الأسواق الأسبوعية التي تعرفها جميع مناطق المغرب؛ سيجعلني أعيش على بعض ما كان يُخصّص من طعامٍ للتلاميذ الذين يأتون من أماكن نائية، خصوصا السمك المعلب، وأكياس التمر المجفّف؛ وربما لم أكن لأفعل ذلك لولا نصيحة ناصح، لأن طريقة نظري للأمور المختلفة ما كانت لتدلني على ذلك. وأما الخبز، فقد كان السكان الطيبون متفقين فيما بينهم على أن يأتيني به كل يوم، واحد ممن يدرس أبناؤهم عندي. وكنت أستعين في الإفطار بالشاي صباحا، وأشربه بعد انتهائي من العمل أيضا، طلبا لإذهاب مشقّة ذلك اليوم. ولكنّني إن نسيت، فلن أنسى دعوات زميلي "نائب المدير" إلى ولائم عشاء قرويّ دسم عدة مرات. كان الرجل (ع. ح)، كريما ودمث الأخلاق، لا يخاطب أحدا إلا باللين؛ فكنت أجد منه بعض الحنان الذي لم يكن والدي يبديه لي...
***
لقد كنت أعيش على رأس جبل وحدي، وكانت الطريق الترابية التي تربط بين جانبَيِ الدوار، تمر بجانب بيتي؛ وأما في الطرف الآخر من الطريق قبالة بيتي، فقد كان يوجد ضريح لأحد الأولياء أظن أنهم كانوا يسمونه "سيدي موسى". وبما أنني كنت أعيش كالبوهيميّين، أعجمي الباطن، فإنني لم أزر ذلك الولي يوما، ولا اهتممت به. أما البيت الذي صرت أسكنه، فقد كان بيتا متهالكا من الطراز الفرنسي، الذي كانت تبنيه الدولة الفرنسية لموظّفيها. كانت الجدران به سميكة، وحوافها يملأها الجبس في خطوط منحنية جميلة. كان الباب خشبيا متينا، غير أنه -كما يظهر- لم يُكرمه أحد ممن مرّوا عليه بطبقة طلاء تقيه عوامل التعرية ولو مرة؛ لذلك كان على لون ترابيّ باهت، لا يُشكّ في أنه كان بنّيّا مُدهامّا في أصله. كان المرء بعد دخوله يجد مطبخا من الطراز الفرنسي، ثم يجد بابا جانبيا يُدخله إلى غرفة يُفترض أنها كانت للجلوس؛ ثم كان لهذه الغرفة باب في الجهة الأخرى يُدخل إلى غرفة النوم، التي كان يوجد بها موقد للحطب على الطراز الغربي... لم أكن أشغل أنا من البيت إلا غرفة النوم، التي كان سريري فيها أحد الأبواب المخلوعة. كان الباب يرفع الفراش عن الأرضية الإسمنتية القديمة ما يقارب السنتيمتريْن، وكان هذا الارتفاع يُجنّبني البلل عند هطول الأمطار، ما دام البيت لم يُرمّم منذ عشرينيات القرن الماضي على ما يبدو. كانت بالأرضية الإسمنتية حفر: في الحفرة التي كانت تتوسط الغرفة، كان يسكن ثعبان يُطل عليّ المرّة بعد الأخرى، لكنه لم يكن يزيد على أن يرفع رأسه ويديره في الغرفة ثم يعود. وأما الحفر التي كانت تحت الباب الذي أتخذه سريرا، فكانت تسكن بها أُسر من قبيلة للفئران. كنت في بعض الأحيان، وعندما أكون ممدّدا، أرى واحدا منها أو اثنيْن يبتعدان عن الباب، وأرى حمرة لآذانهما على ضوء الشمعة (بما أن الكهرباء كان من المحال بلوغه حيث أنا)، وهما يبتعدان قليلا عن مقرّ إقامتهما، أي في الطابق السفلي من إقامتي... وأما البراغيث، فلا تسل عنها، لأنني لم أكن أعرفها قبلا من بيت أسرتي، فصارت ملازمة لي وكأنها قد أنست إليّ بعد تحقّق التعارف بيني وبينها. وأنا بسبب ما كنت عليه من مرض، ومن بوهيمية، ما كنت أعير ذلك اهتماما، لولا أن والدتي كانت تجد آثار تلك البراغيث على ثيابي عندما أعود إليها من منفاي ذاك... كان انتقالي من عيشة البيت تحت رعاية أمّي، مباشرة إلى العيش وحدي مع مرضي، صعبا وغريبا عليّ؛ لأنني لم أكن أُحسن طهو أي شيء. فالشاي نفسه، لم أكن مهتما بصنعه، فكيف بغيره مما يؤثّث الموائد المغربية من أطباق مشهورة عالميا. نعم، لقد وجدت في الشعرية التي كانت تجربتي الأولى لها كارثية، وجبة سهلة الإعداد؛ فكنت كثيرا ما أجعل عشائي منها. أما صديقي "ابن يوسف" الذي تعرفت عليه من بين شباب المدشر، فقد كان طيّبا جدا، يأتي إليّ بعد أن ينصرف التلاميذ، ويؤنسني بأخباره إلى أن يبدأ ظلام الليل في إسدال ستائره على المكان. وبما أنني كنت أبقى في مقر عملي في بعض نهايات الأسبوع، ما دام السفر إلى جرادة كل أسبوع يفوق ما أستطيع أن أتحمّله من مشاق، فقد كان صديقي ذاك يستضيفني لتناول الغذاء في بيته، إن لم يكن هو نفسه خارج المدشر بسبب موافقة يوم عطلتي ليوم انعقاد السوق الأسبوعية في "النعيمة"... لم يكن يخفف من وحدتي في مقر إقامتي، إلا المذياع الصغير الذي كنت قد اصطحبته معي، وبعض الكتب النظرية لمبادئ الموسيقى التي كنت مصرّا على شق طريقي فيها. وأما رحلتي من أعلى جبل الحاسي الأحمر إلى بيتنا في جرادة، وعودتي إليه مرة أخرى، فقد كانت قطعة من العذاب: كان عليّ في كل مرة أن أنزل من أعلى الجبل وأسير على قدميّ مسافة لا بأس بها؛ كنت لا أعرف مقدار طولها إلا من شدة تعرّقي عندما أصل عند الذهاب إلى الطريق الترابية التي تمر منها الشاحنة، أو عندما أنزل من الشاحنة وأصعد الجبل محمّلا بحقيبة تحمل أغراضي... كان والدي قد أوصى سائق الشاحنة التي تأخذ رواد الأسواق من جرادة وإليها، والذي كان رجلا قويّ البنية شديد الحياء؛ لا يكاد يرفع عينيه من حيائه. فوعد هذا الرجل والدي أن يُجلسني في مقدمة الشاحنة معه، إن لم يكن بين المسافرين امرأة؛ وهو ما لم يكن يحدث إلا نادرا. وهذا يعني، أنني في الغالب كنت أركب مع رواد السوق، بين البضائع من أعناز ودجاج وزيت وسمن وغير ذلك... وما كنت آبه لسفرتي في طريق العودة إلى جرادة، لأن فرحة العودة إلى التمدّن كانت تغطّي على وعثاء السفرة؛ ولكنّي عندما كنت أقفل عائدا بعد قضاء عطلة ما إلى مقرّ عملي، وأنا نظيف الجسم والثياب، كنت أجد لذلك ألما بدنيا ونفسيّا؛ لأن نظافتي كنت أودّعها في الشاحنة عينها، فإذا زدت على الأمر تعرّقي وأنا أصعد الجبل محمّلا بما أستطيع حمله من أغراض، فإنني كنت أعود لما يليق بالبراغيث أن تجده منّي، ولما لا يُنفّر الفئران من روائح قد تستغربها هي الأخرى...
***
لم أُمض في هذه المدرسة النائية إلا ما يناهز الستة أشهر، التي فصلت بين زمن توظيفي في الأسبوع الأول من شهر يناير 1977، وشهر يونيو من السنة نفسها؛ لأن الوالد كان قد وسّط صديقه "المدير" الذي تكلمت عنه زمن مزاولتي لدراستي الابتدائية، ليُعيدني إلى مدرسة بجرادة، كانت لها فرعية بقرية "العوينات". وبما أنني كنت ما أزال معلّما مؤقَّتا، فقد كان من نصيبي أن أُعيّن في مدرسة العوينات الفرعية، والتي كان بها بيت من الطراز الفرنسي الذي وصفته سابقا، سكنته مع جماعة من المدرّسين العزّاب بدءا من سنتي الثانية هناك، بسبب قسوة البرودة، والتي جربت سنة أن أعود فيها يوميّا إلى بيت والدي، مستعملا لدرّاجة نارية كانت كأنها صُمّمت لأجل مضاعفة المشقّة علي... كنت لسذاجتي، قد منحت مجموع رواتبي في الشهور التي عملتها سابقا قبل أن تُسوّى وضعيتي الإدارية، لوالدي؛ لأنني كنت أتوق إلى فرحته بما يُعينه على التوسعة على عياله، أو هذا ما كنت أظنّه أنا. وطلبت منه أن يبتاع لي دراجة نارية (موتوسيكل) أتنقل عليها لسنوات أمامي لا أدري عددها، ولم أكن قد اعتدت على طريقة والدي في الإنفاق؛ فلم أُفق إلا وهو يأتيني بدراجة متهالكة، قد لُحمت أجزاء من محرّكها؛ وهو ما كان يثير عجب كل مـُصلح آخذها إليه، وما أكثر ما كانت تحتاج إلى إصلاح. اشتراها والدي من بين الدراجات القديمة، لأنها كانت أرخصها؛ ولم يُفكّر فيّ برهة، أنا من كانت تنتظره أيام من العذاب وأنا أقودها مشيا بعد توقّفها؛ وما أكثر ما كان العطل يسري إليها. جررتها مرات، تحت سيول الأمطار، فكانت عبئا عليّ بدل أن تكون معينا لي. والغريب، هو أنني رغم ضجري من ذلك، بسبب اعتلال صحتي وطول الطريق الذي كان يُجاوز ثلاثة كيلومترات ذهابا وحده؛ وكأنني كنت أعلم أن قدري هو مقاساة الآلام الظاهرة والباطنة. فكنت كثيرا ما أصل إلى البيت منهكا، أُلقي بنفسي على فراشي بعد التخلص من ثيابي المبللة ومن حذائي، وأنا أكاد أغيب عن الوعي من شدة الإجهاد. كنت في حالي هذا، أُشبه "سيزيف" في الأساطير اليونانية... ما كان أحد يجرؤ على أن يشفع لي عند الوالد ليُحسّن من أحوال استغلالي، لا أنا ولا والدتي أو جدّتي: كنّا كمن حُكم عليه بالسّجن مع الأشغال الشاقة. ولولا تدهور صحّتي، ما كنت آبه لشيء مما أجد، لظنّي أنني قد رفعت عن أسرتي غير يسير من الضنك. هكذا كان يُخيّل إلي، وأنا أسير نحو الموت المحقّق، وإخوتي الذين يصغرونني، لا يميّزون شيئا مما يقع، وأنا أنظر إلى حال الفقر التي لا يخرجون منها حتى عندما أحصل على علاوة فوق راتبي الأصلي. لم أكن من الفطانة بحيث أعلم أن جلّ المال الذي يقع في يد والدي، كان يُنفقه على فسوقه خارج البيت. وأما نحن، فلم يتغيّر علينا شيء بعد دخولي أنا مجال العمل!... وبعد مرور سنوات طويلة، وعندما اشتريت مباشرة بعض ما كانت والدتي تحتاج إليه من أجهزة للطبخ، أو عندما أتيت إلى البيت بجهاز تلفاز ملوّن، قام علينا الوالد مـُغضَباً، يذيقنا من سوء المعاملة الأيام المتتالية... لم أكن أُدرك سبب ذلك، إلا بعد سنوات طويلة، عندما اكتشفت -ويا لهول ما اكتشفت!- أن والدي كان ألدّ أعدائي؛ يفوق في عداوته الغرباء عنّي الذين لا يربط بيني وبينهم شيء. ولعلّ أهمّ ما كان سببا في ذلك، هو أنني لم أكن ابنه من جهة الروح...
|



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.