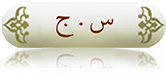اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 | 
2018/11/01 العمل الإسلامي ومنطق الإسلام - 7 - تمييز أولي الأمر إن مصطلح "أولو الأمر"، مصطلح مبهم لدى المسلمين رغم شدة وضوحه في القرآن والسنة. ولقد وقع هذا بسبب التلاعب بمدلول المصطلح، منذ القرن الأول، من أجل التوطئة للانحراف السياسي على الخصوص. لكن هذا التحريف في المدلول، لم يكن ليستمر لولا مصادفته لهوى في نفوس شطر كبير من الناس؛ ظنوا بذلك واهمين أنهم سيجمعون بين الأهواء والدين. ويكاد "ولي الأمر" بعد كل الممارسات التاريخية التي ترسخت في وجدان الأمة، أن يكون الحاكم حصرا، بصرف النظر عن صنفه وعن مدى موافقته للشرع (وإن كان الزعم دائما هو أنه أشد الناس استقامة)؛ لأن الشرع نفسه، يكاد يكون مع القهر، رأي الحاكم ذاته ورأي مذهبه وطائفته. وهكذا صرنا بدل أن نعرف ولي الأمر بالشرع، نتعرف الشرع بالحاكم المعضد بفقهاء الفتنة، الذين يدورون معه حيث يدور. وهذا هو الإيذان بافتراق القرآن والسلطان الذي جاء التنبيه إليه في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَلَا وَإِنَّ السُّلْطَانَ وَالْكِتَابَ سَيَفْتَرِقَانِ، فَلَا تُفَارِقُوا الْكِتَابَ»[1]. يقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59]. فطاعة الله معلومة ظاهرا، وهي طاعة أوامره سبحانه الوارد بها الوحي؛ وطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم معلومة ظاهرا أيضا، وهي طاعة أمره وتوجيهه حال حياته، واتباع سنته بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مع التأكيد على أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي من طاعة الله عينها؛ فهي طاعة واحدة في النهاية. وقد حصرنا علم هذه الطاعة في الظاهر، لتعلقها عند الخواص من الأمة -زيادة على ما ذكرنا- بالمظاهر الربانية التي ذكرناها في الفصول السابقة، والتي على رأسها في كل زمان القطب الغوث من جهة أهل المراتب، والختم من جهة الأفراد[2]، إن كانت الختمية في الزمان لغير الغوث؛ حفاظا على مقتضيات المراتب، وإن كان هؤلاء مجهولين في أغلب الزمان. فهذا كله داخل في طاعة الله ورسوله المنشودة. وطاعة أولي الأمر، تتطلب معرفتهم أولا؛ بما يُشترط لها أن تكون موافِقة وجوبا لطاعة الله ورسوله، كما يدل على ذلك سياق صدر الآية المذكور آنفا، ويدل عليه أيضا عجزها إذ يقول الله فيه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا} [النساء: 59]. فمُتعلَّق الطاعة في البداية الله ورسوله، وفي النهاية الله ورسوله؛ وبهذا تكون الطاعة من حيث المدلول، محفوظة من بين يديها ومن خلفها عن التحريف؛ وتكون الطاعة التي لا أصل لها من طاعة الله ورسوله فسقا وخروجا عن التشريع، وإن بالغ أصحابها في التلفيق لها. هذه هي الطاعة بالمعنى الشرعي!... ولو أن الناس اعتنوا بهذا المعيار وحده، لسهل عليهم تنزيل معنى الآية في كل زمان، ومع أيّ كان!... ولكنها الأهواء. يقول عمر بن الفارض في هذا المعنى (رضي الله عنه): ونَهْجُ سَبيلي واِضحٌ لـِمـَن اهتَدى ... وَلَكِنَّها الْأَهْواءُ عَمَّتْ فَأَعْمَتِ ولقد تكلم المفسرون في مصداق "أولي الأمر"، فأرجعوه إلى صنفين رئيسين هما السلاطين والعلماء (الفقهاء بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي). وهذا وإن كان يصح من وجوه سنعود إليها في حينه، إلا أنه يُغفِل أهم من ينطبق عليهم الوصف، وهم الخلفاء (بالمعنى التام أولا). ولو أن الناس زمن عليّ عليه السلام كانوا يفقهون هذه الدلالة، لما اتبع أحد معاوية في خروجه على الخليفة؛ لأنهم بذلك سيخالفون الآية التي انطلقنا منها مخالفة تُدخلهم في محادة الله، التي لو تعمدها العبد ولم يكن له عذرُ تأوُّلٍ، لكان على معصية كبرى، توشك أن تدخل به في فرع من فروع الكفر. كل ذلك لأن معصية الخليفة معصية لمن استخلفه (الله ورسوله) مواجهة. نعني أن هذه المعصية تكاد تكون ردا للأمر([3])، لا معصية للأمر المبلغ المحكي (القول). وهذا لا يُشبهه فيما مضى، إلا معصية إبليس لأمر الله بالسجود، ومعصية أوامر الله من الأنبياء الخلفاء عليهم السلام، كداود وسليمان ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يأتي بعد أصحاب الخلافة التامة، أصحاب خلافة الباطن (الأغواث)؛ لكن بشرط معرفتهم، لمن هم من أهل الولاية الخاصة والغيب على التخصيص؛ وإلا كفى التصديق العام بهم، كما ذكرنا سابقا، لمن كان من العوام. وعلم هذه المرتبة يكاد يكون غائبا عن العوام على الدوام، بسبب غياب معنى الخلافة عن الله، عن الفقهاء منذ الزمن الأول. ثم يأتي بعد من ذكرنا، الربانيون من أهل خلافة التربية، الذين يتزكى الناس على أيديهم بالمدد النبوي. فهؤلاء كلهم من أولي الأمر الذين تجب طاعتهم وتحرم معصيتهم في المرتبة الثانية بعد الخلفاء الاثني عشر المعلومين. وأما علماء الدين المعروفون لدى العامة، فتأتي طاعتهم بعد الأولين، بشرط الصدق والإخلاص؛ فإن خالفهم إمام من الأولين سقطت طاعتهم، لكون المراتب حاكمة على "أولي الأمر" أيضا. وهذا كحال الفقهاء الذين كانوا زمن جعفر الصادق -مثلا- لو افترضنا مخالفته -عليه السلام- لهم، فإن طاعتهم تسقط في المسألة محل الاختلاف؛ لأن الفاضل يحكم على المفضول دائما، بشرط العلم بهما معا. إذ لا يُتصور عمل الجاهل بما ذكرنا لجهله. وأما السلاطين والذين هم أيضا من أولي الأمر، لكونهم الجهة التي عليها حمل الناس على الأمر (التنفيذ)، فهم إن لم يكونوا خلفاء بالمعنى الباطن، فمرتبتهم تأتي بعد العلماء العاملين؛ لأنهم مكلفون بالاستماع إليهم من أجل بلوغ الحكم في الأمور العارضة لهم. فإن كانوا خلفاء يجمعون بين الحكم والغوثية، فالكلمة الأخيرة في النهاية تعود إليهم، ولو بعد استشارة الفقهاء؛ لأن الأفضلية لهم من حيث المرتبة. وأما الفقهاء المتصنعون الذين يخدمون الحكام، فليسوا من أولي الأمر، لأنهم داخلون في المخالفة. فهم لا يُؤتمنون على شيء من الدنيا، فضلا عن الدين. وهم والعامة سواء في المرتبة، من جهة ما نتكلم فيه؛ وإن كان العامة الصالحون أفضل منهم عند الله من جهة التقوى. وطبقا لما ذكرنا، فإن معاوية -كما سبق القول- لم يكن يجوز له القيام على عليّ عليه السلام، وإدخال المسلمين في فتنة لم يخرجوا منها إلى الآن؛ لأن ولاية عليّ ثابتة على معاوية وجميع من عاصرهما من الصحابة والتابعين. وقتل يزيد للحسين عليه السلام، كان معصية كبرى، قتل فيها المفضول الفاضل، مع حصول العلم بحاليهما ضرورة لدى عموم الأمة. والقتل أشد المعاصي في نفسه، فكيف إن كان في حق سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووارثه في الدين!.. والقاتل عندنا، هو كقاتل نبي من الأنبياء في الأمم السابقة؛ لا فرق!.. وكل من رضي بذلك الفعل الشنيع من ذلك الوقت إلى قيام الساعة، فإنه آثم مشارك ليزيد وأعوانه في الوزر. وكل ما يقوله صغار فقهاء أهل السنة من المقلدة، من كون الحسين عليه السلام كانت تجب عليه طاعة المخذول، من كونه وليا للأمر، فهو ارتكاس وانتكاس وانطماس، لا يُعتبر ولا يُرفع به رأس في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنه إخلال بالمراتب وعبث في الدين. نقول هذا، حتى نرفع اللبس الملازم لهذه المسألة طيلة قرون؛ مع أنها من أجلى المسائل وأشدها وضوحا لدى سليمي الفطرة ولو لم يكونوا عالمين. وأما العلماء فمن أشد النقص لديهم (عمى البصيرة)، أن لا يُدركوا وجوهها بالأدلة القرآنية والسُّنية، التي لن نطيل باستقصائها هنا. ولا بد أن نذكر هنا أن شطرا من الأمة قد دخل في معصية الله ورسوله من ذلك الوقت وإلى الآن، وصار يشبه في الحال بني إسرائيل الذين أخبر الله عنهم بقوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا} [النساء: 46]. ولسنا هنا نزكي الشيعة على أهل السنة كما قد يلوح للناظر؛ لأن تقسيم الأمة إلى شيعة وسنة هو تسطيح للمعنى الذي نرمي إليه. ومن يتتبع كتاباتنا في هذه المسائل، فإنه سيبين له -ولا شك- ما نقول. وأما في زماننا فولاية الأمر لرجال الغيب أولا (كما هو الشأن دائما)، ثم لأهل التربية المسلكين، ثم للفقهاء الصادقين إن وجدوا؛ لأن من يُنسبون إلى الفقه اليوم لا علم لهم بما ذكرنا، بَله أن يكونوا من أهله. وأما حكام الزمان فليس لهم من الأمر إلا ما وافق الشريعة من الأحوال العامة فيما يتعلق بالبلدان والشعوب، وبعد ذلك فيما يتعلق بأنفسهم وبالأفراد أو الجماعات الصغيرة كالقبائل، مما هو مشهور وداخل في العرف. وكل ما عدا ذلك مما قد يدِق قليلا أو كثيرا، فهم يوزنون فيه بميزان الشرع قبولا وردا؛ لأن الحكم (السلطان) ليس من المراتب الدينية في نفسه، حتى يُقال فيه بوجوب طاعة الحاكم، كما صار يُشيع المتاجرون بالدين؛ وإنما هو من المراتب الدنيوية التي ينبغي أن تكون خادمة للدين، والتي ينبغي اعتبارها في المعاملات الدينية من جهة الباطن، كما ننبه إلى ذلك دائما. وبهذا يكون الحاكم مكلفا كسائر المكلفين، عليه أن يعمل بما هو من طاعة الله ورسوله وأن يتجنب ما هو معصية. ولو نظرنا إلى حكامنا اليوم، فإننا سنجدهم من أشد الناس جهلا بأحكام الدين فيما أقامهم الله فيه. وللمداهنين من الفقهاء نصيب من أوزارهم، لكونهم لم يعينوهم على استبانة الحق. وعندما نجد الحكام ينفعلون للقوى العالمية، كما هو مشاهد، والتي هي في غالبيتها دجالية، فإننا سنعلم فداحة ما نحن فيه، ونعلم صعوبة إدراك ما نتكلم فيه عليهم وعلى عموم الناس. وذلك بسبب وقوع أحكام الإسلام تحت حكم الكفر العام، الذي يذهب بمعنى الطاعة المنوط بالأمة بما هي أمة. وهذا شبيه بحال الأقلية المسلمة في البلاد الكافرة، مع وجود الفارق. لكننا في جميع الأحوال، نخالف من يجعل الحاكم كآحاد الناس في المرتبة، قياسا على ما تعطيه الديمقراطية في المواطنة، أو يزدريه لسبب من الأسباب؛ لأننا نعتبر مظهريته الخلافية (من الخلافة). فالحكام خلفاء الخليفة من جهة الباطن، وإن عصوا في الظاهر. وهذا لا يعني أننا نقول بارتفاع تكليفهم كما قد يفهم من لا علم له بوجوه الكلام؛ لأن التكليف هو من جهة نسبة الأعمال إليهم؛ وما نتكلم نحن عنه هنا، هو من جهة نسبة أعمالهم إلى الله. ونحن نذكّر دائما بأن الأفعال لها نسبتان: حقيّة وخلقية، من أجل أن يتبيّن الناس مناطات الأحكام التي نتناولها. وبعد الذي ذكرنا، لا بد أن ننبه إلى أنه لا ينبغي قياس أحوال الحكام في الماضي أو في الحاضر على الخلفاء؛ لأن الخلفاء مرتبة دينية دنيوية لها خصوصيتها. كما لا يجوز قياس أمرهم على الأمراء الذين كانوا زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين ورد فيهم: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ؛ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي»[4]؛ لأن الأمراء زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا محفوظين بوجوده صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأما اليوم فالأمراء يخلطون كما يخلط الناس، وليسوا منسوبين من هذا الوجه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهم يحكمون بما يعنّ لهم، وأحيانا بما يخالف الشريعة صراحة. فكيف يُطاعون وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ! إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ!»[5]. وكل ما نسمعه في عصرنا من فقهاء السلاطين في هذا الباب، إنما هو ترهات يستغفلون بها العامة، الذين يضلونهم فحسب. يتضح من كل ما سبق أن الأمة قد جهلت منذ القرن الأول (إلا طائفة الحق من كل زمان) أولي الأمر الذين يعنيهم الله في قرآنه. وقد نجم عن ذلك الجهل أخطاء في التصور، نحسب أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم قد وقعوا فيها بسبب عدم إلفهم للخلافة بعد النبوة. ولا شك أن ذلك كان في حقهم رضي الله عنهم ابتلاء عظيما، لا ينبغي أن نستهين به وقد جنّبَناه الله. وقد استمر ذلك الخطأ في التصور للمسألة، في الفقهاء الذين جاءوا في عصر التدوين فما بعده، لإحسانهم الظن بجميع الصحابة في كل مسألة ورأي؛ وهو ما أفضى في النهاية إلى التسوية بين الرأيين المتناقضين توهما بأنهما من الاجتهاد المشروع. والحقيقة هي أن الاجتهاد في هذه المسألة على التخصيص لا يصح؛ لكونها تدخل في الفقه الأعلى الذي لا يكون إلا للأئمة من الربانيين؛ وتدخل في معاملة الله في أخص المظاهر. وبما أن أئمة الفقه المشهورين، لم يكونوا من هذه الطبقة العليا، فقد أخذت الأمة -خصوصا عند أهل السنة([6])- برأيهم، فضلت عن "أولي الأمر" الأحقاء، وصارت عُرضة لإضلال المخطئ والمغرض من أهل العلم المفضول؛ فكان هذا كله سببا أساسا من أسباب الفتنة المستمرة إلى الآن. ولا يُنتظر الخروج من هذه المعضلة في الظاهر، إلا مع خروج المهدي الذي ستعلو حجته ويَبين برهانه. وأما من جهة الباطن، فلن يزال من أهل الفقه (بالمعنى الاصطلاحي) وأهل العقائد الكلامية من يُصرّ على ما هو عليه، بسبب انحراف القلوب عن الصحة والاعتدال، وغلبة التعصب للمذهب والرأي، وإن كان الحق في مقابلهما أبلج. هذه سنة الله في خلقه ما داموا في الدنيا، التي هي دار اختلاط. نقول هذا حتى لا يطمع طامع فيما لا مطمع فيه؛ والحكيم من كان سائسه العلم وإن خالف هواه. إن الآية التي صدّرنا بها الكلام، قد بيّنت كيف تُبلَغ طاعة الله ورسوله من توجيه أولي الأمر الذين آل إليهم أمر تبيين الطاعة؛ والذين تكون مخالفتهم دخولا في المعصية، علم الناس أم لم يعلموا. فإذا قام قوم يزعمون -بعد سماع توجيه أولي أمر زمانهم- أنهم لم يعلموا علم يقين دلالة الكلام على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يعلمون دلالته من الكتاب والسنة، وبالتالي فلا حجّية في نظرهم لكلام أولي الأمر، فإننا نعود بهم إلى ختام الآية حيث يُطلب من المنازعين لهم في الرأي أن يعودوا معهم إلى الله والرسول. وقد يسأل سائل: كيف تكون العودة إلى الله والرسول، مع إقرارنا بجهل الجاهلين لدليل طاعة الله وطاعة الرسول؟.. فكأننا نحيل على مجهول!... وفي الحقيقة لا يكون رد المتنازع فيه إلى الله والرسول على السبيل المعهودة عند استواء الطرفين في العلم بالحق، أو عند استوائهما في الجهل به؛ وإنما بأن يسأل الجاهل أولي الأمر من العلماء بالحق، عن دليلهم من القرآن والسنة على ما يقولون فحسب؛ فإنهم لن يعدموا ذلك، وهم من أطلعهم الله من وحيه على ما لم يُطلع غيرهم. ولهم رضي الله عنهم في إرجاع الأقوال إلى الأدلة ما تحار فيه عقول كبار العلماء. هذه هي وسيلة الرد إلى الله والرسول، لا مجادلة العالمين بغير علم، والتي نهى الله عنها في مثل قوله سبحانه: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ} [الحج: 8]. وعندما يُبرز أولو الأمر دليلهم من الوحي للناس، فإن من كان منهم متحريا للحق سيهتدي بإذن الله إليه من أقصر طريق. وأما من كان مريض القلب، فإنه سيُختم على قلبه بسبب تلاعبه مرة عند تظاهره بطلب الحق، ومرة عند جحوده له وقت ظهوره. نقول هذا، حتى لا ينسى العبد أن من الناس من سيصرّ على المعصية، ولو من طريق ملتوية، يزعم معها أنه مخالف في الرأي فحسب. وبعد هذا الذي مررنا به في كل الفصول السابقة، يتضح أن المسلم الصادق في طلب الحق، من جهة الأصول ومن جهة الفروع، قد جعل الله له سبيلا ميسرا إليه، وحماه من الزيغ من كل جهاته، ما دام متبعا لما شرع الله له في ذلك من آداب وطرائق، يتبيّنها كل أحد بمجرد قراءة القرآن قراءة من يعي الخطاب العربي. ولم يجعل الله أمر تبيّن الحق بالعسر الذي يظنه الناس، أو يوهمهم به من يبغي إبقاءهم أسارى له، يستتبعهم ويأكل أموالهم بغير حق. ولو أحسن العباد الظن بربهم، ما أصابهم ما يكرهون قط. أليس هو القائل سبحانه في الحديث القدسي: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي»[7]؟!.. فإن نحن عدنا إلى الإسلاميين في عملهم، فإننا سنجدهم غير عالمين بمرتبة "أولي الأمر" من جميع وجوهها. وسنجدهم تبعا لذلك، إن هم أصابوا وجها، مخالفين لبقية الوجوه؛ خصوصا للوجه الذي هو من نصيب الحكام، عند منازعة الأمر لهم. ونتيجة لهذه المخالفة في العمل ولهذا القصور في العلم، فإن طاعة الله وطاعة الرسول التي هي الغاية، ستكون لديهم غائبة أو جزئية. وهذا يشبه حبط الأعمال الذي حذر الله من الوقوع فيه، في مثل قوله سبحانه: {وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ} [المائدة: 53]. وحبط العمل يكون عند الإتيان به صورة، لا روح لها. ولا روح للأعمال إلا ما يُنفخ فيها من الأدلة الواردة في الوحي. فليُعتبر هذا... والأفدح من هذا، هو جعل القياديين من الإسلاميين أنفسَهم من أولي الأمر (وإن لم يتقمصوا الصفة صراحة)، بغير حجة ولا برهان؛ وإنما هو ترام وغصب. فألزموا أتباعهم بمعاملتهم بما ينبغي لتلك المرتبة، فكانت طاعتهم -بالتالي- واجبة عليهم بحسبهم. وهذا واضح جدا لدى التنظيمات الحركية الإسلامية، التي يخلط أصحابها بين ما هو من الشرع، وما هو من مناهج عمل التنظيمات عموما في العالم؛ حيث لا يُخالف تنظيم ماسوني -مثلا- من هذا الوجه تنظيما إسلاميا. وهذا الخلط المتعمد، هو من أكبر المعاصي التي تكون عليها قيادات التنظيمات الإسلامية، لكونه يدخل في باب الافتراء على الله. فهم من هذا الوجه يشبهون من قال الله فيهم: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ} [الأنعام: 93]. ذلك لأن المراتب التي ذكرناها سابقا لولاية الأمر (من جهة الغيب على الخصوص)، لا بد فيها من وحي خاص، يدخل ضمن الوحي المذكور في قول الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ} [الشورى: 51]. وهذا الوحي مستمر في الأمة إلى قيام الساعة، بخلاف وحي التشريع النبوي الذي انقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يتذرع بعضهم إلى آفة التأمّر على الناس بغير إذن إلهي، بكونه يدعو الناس إلى طاعة الله من صلاة وصيام وغير ذلك مما هو مأمور به شرعا، فيجعل طاعته من طاعة الله وفرعا عنها من هذا الوجه؛ وهو تدليس!.. لأن هؤلاء لا يكتفون في الغالب بما هو متيقَّن من طاعة الله، ويتجاوزونه إلى المواقف السياسية وإلى العمل السياسي الذي قد يكون حزبيا جاهليا؛ وهذا كله ليس من طاعة الله ورسوله المعلومة. بل إن منهم من يدعو إلى المعصية صراحة، عندما يُلزم أتباعه بمعاداة المؤمنين، أو بالانتصار للجماعة من دون تمحيص، إلى غير ذلك مما هو معروف. وهذا الفعل منهم يكون إضلالا لغيرهم عن عمد، لا نرى لهم منه مخرجا إلا التوبة، من قبل أن ينقلبوا إلى ربهم؛ وإلا كانوا في نظر الشرع على بدعة كبرى، وإثم عظيم. وبما أن من أسباب الوقوع في هذه الآفة، عدم العلم بأصناف أولي الأمر وبمرتبة كلٍّ منهم، فإنه كان يجب على هؤلاء المتبوعين من الإسلاميين، العمل على تحصيل هذا العلم وإبلاغه للناس بعد ذلك، لو كانوا حريصين على موافقة الحق. ومن كان على صفة الجهل بما ذكرنا، فأولى له أن يشتغل بما يخصه في نفسه، وأن يبتعد عن الخوض فيما لا يُحسن. والحقيقة هي أن أمراض القلوب، التي في مقدمها حب الرئاسة، هي وحدها السبب فيما وقع فيه جل الإسلاميين. وهذا من أثر غياب التزكية التي كان يجدر أن تداوي عللهم الباطنية؛ ولكنهم -وطاعةً لأهوائهم- جعلوا يتنكرون لهذه التزكية وكأنها من نوافل الطاعات، أو هي من البدع والمنكرات؛ مع كونها في الحقيقة من فروض العين التي لا مندوحة عنها لأحد. بل إن بعضهم جعل التزكية نفسها -عندما جهلها- لا تتجاوز "التأطير الديماغوجي"، الذي تعتمده الأحزاب السياسية والمنظمات الأيديولوجية؛ فازدادوا بهذا تحريفا على تحريفهم الأول، فكانت النتيجة بعدا زائدا عن الحق. وإن كل ما سمعناه من القيادات الإخوانية العالمية في هذه الآونة، ورغم دورانهم في الكلام على الآيات والأحاديث، لهوَ من تلك الديماغوجيا التي لوثت العقول، كما تلوث الجراثيم الأبدان. لو علم الإسلاميون ما أحدثوه في الأمة من خلل، بعملهم على غير علم، فإنهم لن يروا أنفسهم أفضل من الحكام الذين ينتقدونهم على مخالفات ظاهرة، وهم أسوأ منهم حالا. ذلك لأن للحكام بعض عذر -ولا عذر في الحقيقة!- عندما نجد الحكم قد استهواهم ودعتهم منه الدواعي إلى توهم ما ليس لهم. نعني أن خلافة الخلافة، جعلتهم يتوهمون في أنفسهم الخلافة، وإن كانوا لا يعلمونها؛ وكأنهم شموا رائحتها من وراء حجاب. وعندما لا يكون الحاكم من أهل الخلافة، فإنه يدعي الربوبية من هذا التوهم إما بالحال وإما بالحال والمقال. وهذا هو ما وقع فيه فرعون (ومن تبعه ممن هم على شاكلته) عندما أعلن ما حكى الله عنه في قوله تعالى: {فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى} [النازعات: 24]. وهو ما أشار إليه أيضا قول الله تعالى حكاية عن نمرود: {قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258]. فلولا أنه رأى صفة الاستحياء والإماتة منه، دون سائر الناس، ما توهم الربوبية في نفسه. فهذا يشبه العذر، بالمقارنة إلى من ليس من طبقتهم. وأما هؤلاء الإسلاميون، فقد ادعوا ولاية الأمر، من دون سلطان لهم في الظاهر؛ فأبانوا عن نزوع من نفوسهم إلى التربُّب، هو أشد مما يصيب الحكام؛ ولهذا قلنا عنهم إنهم أسوأ منهم. وهكذا فقد وقعوا -من دون أن يُدركوا الخطورة- في تحريف الدين، عندما جعلوه لا يختلف عن الأيديولوجيات في معظمه؛ وعندما جعلوا أساس العمل فيه الفكر، وكأن الله قد أهمل الناس ووكلهم إلى أنفسهم بعد خلقهم، كما ذهب إلى ذلك بعض من المتفلسفين من غير هذه الأمة؛ تعالى الله!... إن من يعتقد هذا، لا يلبث أن يجعل النبوة عبقرية يمكن أن يُقاربها عقلاء المسلمين، إذا هم تحلوا بالذكاء اللازم، وأكثروا من قراءة الكتب في شتى صنوف العلم. وقد حدث هذا، وسمعنا من لا يفرق بين الأنبياء عليهم السلام والفلاسفة في المرتبة في زماننا. بل سمعناه يستدرك على النبوة بعض الأحكام التي يراها هو من جهة عقله (المعصوم في نظره) خاطئة، ويقول حاشا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول هذا؛ مع أن الحديث مضمّن في الصحيح. يظن أنه بقوله ذاك باق على أدبه الذي يقتضيه إسلامه، وهو في الحقيقة يقول بالمعنى: "ما كان للنبي أن يقول ذلك! وأنا بنباهتي، قد تبيّنت بسهولةٍ خطأه!". إن هذا المسكين وأمثاله، يمشون على شفير الكفر، والشيطان يزيّن لهم؛ حتى إذا وقعوا، تخلف عنهم وضحك من غبائهم وضعف إيمانهم. ومتى كان الدين بالذكاء، أو بكثرة المعلومات!... نسأل الله العفو والعافية!... إن جل "الدعاة" الذين جعلوا من الدعوة دكانا مُربحا لهم ولذويهم، صاروا لا يختلفون عن دعاة الماسونية الذين همهم اقتناص المغفلين لِسلْكهم في طرق الشيطان. وفي أحسن الأحوال هم يشابهون دعاة البروتستانت من النصارى، الذين يعقدون الاجتماعات العظيمة، لتمجيد الرب بحسب زعمهم، متوسلين بالديماغوجيا والأكاذيب. ثم يفرحون بنتائج أعمالهم، عندما يرون الحمقى من الناس أمامهم قد دخلوا في هستيريا جماعية، يتوهمون منها أنهم على هدى من الله، وأن ما يرونه كرامات حقيقة، يؤيدهم بها سبحانه. فأولئك وهؤلاء من أشباههم، قد صاروا من أتباع الشيطان؛ وهو من يوحي إليهم ويمدهم بمدده!.. ومع استفحال الحال، نحن نجزم أن عددا لا بأس به ممن كان (أو ما زال) يُحتفى بهم على الفضائيات، وفي المؤتمرات وقاعات المحاضرات، قد انخرطوا منذ زمن في حزب الدجاليين عن علم وإصرار، عندما اتصل بهم الأئمة من عبدة الشيطان وأبرموا معهم الاتفاقات، فعادوا بذلك وبالا على أمتهم. يعرفهم كل ذي بصيرة من كتابة "كذاب" التي لا تفارق وجوههم؛ بينما الجهلة من الشبان والشابات، يذرفون الدموع بين أيديهم، ويتوهمون أن ذلك من الخشوع الذي يصيبهم عند ملاقاتهم. لا يفتُر "أولو الأمر الشيطاني" من هؤلاء الكذبة، عن الخروج على الناس كل مرة (بحسب المناسبات خصوصا في رمضان) بمشاريع "تجديدية" يقدمون فيها الدين تقديما شيطانيا، يأخذ التابعين في متاهات لا خروج منها إلا بنور من الله. كل هذا، وأولو الأمر من فقهاء وحكام -والذين كان ينبغي أن يحرسوا الأمة والدين- صامتون متأدبون، لا يرون بأسا من تقديم الدين في حلة جديدة عصرية، تجمع بين الحق والباطل، هي في الحقيقة صورة متجددة للضلال الذي وقع فيه من سبقنا من الأمم، فأصبحوا به من الخاسرين. ولو أن هؤلاء المتخاذلين سكتوا على التمام، لكان أفضل -مع كون السكوت على الباطل باطلا أيضا- لأنهم عندما يتكلمون، نجد كلامهم يصب في كفة الباطل، وهم فرحون بذلك!... نريد أن نقول من هذا كله، إن بعض أصناف أولي الأمر، وكثيرا من أفرادهم، قد صاروا معاكسين للآية التي انطلقنا منها، عندما صاروا يدلون على معصية الله ورسوله، بدل الطاعة. فليحذر المسلمون على أنفسهم من هذا الانقلاب الديني، الذي كاد يأتي على الأمة؛ حتى صار الشباب يشكّون في حقّيّة الدين، لمـّا فقدوا المعايير... إننا نقول لهؤلاء الحيارى، لا تشكوا في دينكم، وشكوا في بعض "ولاة أموركم". ذلك أهدى سبيلا وخير عاقبة!... [1] . أخرجه ابن حجر العسقلاني في "المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية"، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.