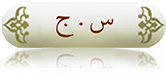اللهم صل على سيدنا محمد الكامل الأكمل، ومظهر الجمال الأجمل، المكمل لكل كامل على مدى الأزمان، والمتخلق على التمام بأخلاق الرحمن؛ القائل بلسان الشكر: أنا سيد وُلد آدم ولا فخر؛ وعلى آله الطاهرين بالتطهير الرباني، وصحابته المشرفين بالشهود العياني؛ وسلم من أثر شهود نفوسنا صلاتنا عليه تسليما. والحمد لله المنعم المفضل حمدا عميما.
 | 
2021/06/04 الحوار الغائب (ج3) -23- المرحلة المدنية (9) (تابع...) ثم يقول الله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} [الأنفال: 57]. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن بعده لكل خليفة؛ والمعنى هو: إن لقيت مِن هذا الصنف النقض لعهدك في الحرب، فنكل بهم وشردهم، حتى يكونوا عبرة لكل مَن يأتي مِن بعدهم ممن يُدركون زمان النبوة، أو ممن يُدركون أزمنة الخلافة. هذا مع اعتبار إمكان عودة الناجين منهم من المعركة، عما كانوا عليه بالتوبة. وهكذا، فإن الآية عامة وشاملة لهذا الصنف ولأحوالهم مع المعاهدات النبوية كلها؛ المباشرة وغير المباشرة... ثم يقول الله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ} [الأنفال: 58]؛ والخطاب دائما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم للخلفاء. والمعنى هو: إن ظهر لك من قوم عاهدتهم، بوادر خيانة، فأعلمهم بإسقاط المعاهدة من جانبك، قبل مناجزتهم؛ لأن محاربتك لهم من غير إعلام لهم بتحللك من المعاهدة، يكون غدرا منك لهم وخيانة؛ والله لا يحب الخائنين. ونحن مع جزمنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، محال منه الخيانة والغدر؛ ومحال من خلفائه وورثته؛ فإننا ندعو عامة المؤمنين إلى تجنب صفة الغدر للأعداء، لأن الله لا يُحبُّها؛ وما لا يُحبه الله، فالنار أولى به. وإن كان هذا هو الشأن مع الأعداء، فما الظن بمن يغدر بالمسلمين ويخونهم؟!... نقول هذا، لأن كثيرا من إسلاميّي آخر الزمان، لا يتورعون عن الدخول في سياسات، لا يمكن إلا أن تندرج ضمن خيانة المسلمين! نسأل الله السلامة لنا ولجميع المسلمين!... ثم يقول الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ} [الأنفال: 59]. وجمهور المفسرين على أن الآية تبدأ بـ: {وَلَا تَحْسَبَنَّ}، بالتاء؛ ويرون أن ذلك أفصح من جهة اللغة. ولكن هذا منهم مع مراعاة معنى سبق الكافرين لله ورسوله بالنجاة بأنفسهم، بحسب ما يتوهمون ويظنون، إذا هم احتالوا وتخفّوا بسوء طويتهم. وعلى هذا فإن قراءة {وَلَا يَحْسَبَنَّ}، التي هي من قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، يعتبرها المفسرون شاذة، إلا إن جاءت "أَنَّهُمْ" أو "أَنْ" مُثبتة بعد "كَفَرُوا" أو رأوا أنها محذوفة، كما في قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} [الروم: 24]؛ أي، ومن آياته أنه يريكم، أو يريكم. ولقد ذكر الشيخ الأكبر عليه السلام، معنى باطن الآية، موافقا للفظ ابن مسعود، فقال ما معناه: لا يحسبن الذين كفروا أنهم يسبقون طلب رحمة الله لهم، والتي هي مـُدركتهم ولو بعد أمد. وجعل رضي الله عنه هذا المعنى مندرجا في قول الله في الحديث القدسي: «سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي!»[1]. وهذا المعنى من غير شك، هو مما يُعتبر عند أهله، بلا خلاف؛ لذلك فإننا نراه نحن معضدا لقراءة ابن مسعود على خلاف قول المفسرين. وسيكون بعد كل هذا، معنى قوله تعالى {إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ}، على وجهيْن: الأول: إنهم لا يُعجزوننا إن طلبناهم بالعذاب، والذي منه في الدنيا القتل في الحرب؛ والثاني: إنهم لا يُعجزوننا بكفرهم، إن نحن طلبناهم برحمتنا. ويكون الطلب بالرحمة، إما بالتوبة عليهم من كفرهم في الدنيا ليتوبوا، وليسلكوا سبيل المؤمنين؛ وهذا يُبقيهم على رجاء في ربهم رغم كفرهم، وهو الأليق بالحقائق؛ وإما يكون بشفاعة الرحمن، عندما يُخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ شَفَعَ النَّبِيُّ لأُمَّتِهِ، وَالشَّهِيدُ لأَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمُؤْمِنُ لأَهْلِ بَيْتِهِ؛ وَيَبْقَى شَفَاعَةُ الرَّحْمَنِ، يُخْرِجُ اللَّهُ أَقْوَامًا مِنَ النَّارِ، قَدِ احْتَرَقُوا فِيهَا وَصَارُوا فَحْمًا؛ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ فِي الْجَنَّةِ يُقَالُ لَهُ الْحَيَاةُ، فَيَنْبُتُونَ كَمَا يَنْبُتُ الْغُثَاءُ فِي بَطْنِ السَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ. فَهُمْ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولا، وَأَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً.»[2]. ومن علم معنى الاسم "الرحمن"، فإنه سيعلم أنه يشفع للكافرين لا للمؤمنين. ونحن نقول هذا، لأن بعض الناس قد يظنون أن الشفاعة المذكورة متعلقة بالمؤمنين من أهل الكبائر الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعد انقضاء مدتهم. وهذا الذي يظنونه، لا يدخل ضمن شفاعة الرحمن، إلا من وجه؛ ويبقى المعنى الذي دللنا عليه هو المعتبر في المسألة. ومن يتأمل ما نذكره هنا، فإنه سيعلم الفرق بين من لا بد له من الخروج من النار بسبب إيمانه، وبين من يخرج منها بشفاعة الرحمن وحدها. ثم يقول الله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 60]. الأمر هنا لحزب الله كله، الذي يكون تحت قيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو تحت قيادة خليفته. والمأمور به، هو الإعداد للعدو (حزب الشيطان المحارب) بما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل. وربط الأمر بالاستطاعة، هو من مراعاة الحكمة فحسب؛ لا كما يظن الغافلون والكافرون. ففي زماننا، صارت الدول يُخضع بعضها بعضا، بالقوة النووية أو ما يماثلها في الدمار؛ لأن المـُخضِع والخاضع معا جاهلان. وأما الحقيقة، فهي أن الغلبة تكون لجند الله، من وراء حجاب الأسباب؛ لأن الله تعالى يقول: {وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ} [آل عمران: 126]. وهذا يعني أن نصر المؤمنين يكون بإدخالهم في دائرة الاسم العزيز؛ وأما الحكيم، فله ترتيب النصر على المتوافر من الأسباب فحسب. وأما القوة المدلول عليها في الآية، فقد عرّفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه، بقوله: "سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقُولُ: «{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}: أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ!»[3]. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن حكم تعلُّم الرماية الوجوب، وأقله الكفاية. وهكذا، فإن الدول الإسلامية التي لا تعمل على تعليم الرماية لكل أفراد شعوبها، فإنها تكون مخالفة للتشريع النبوي. بل إننا ندعو إلى إتاحة السلاح لكل أفراد الشعوب المسلمة، كما هو متاح لأفراد الشعب الأمريكي في زماننا؛ وذلك لكيلا يبقى السلاح حكرا على الجيوش النظامية وحدها؛ لسببيْن: الأول، وهو متعلق بغزو العدو لبلاد الإسلام؛ حتى يتمكن الشعب كله من رد الغزو، وإن ضعف الجيش النظامي عن ذلك. والثاني، حتى لا تعود الجيوش النظامية قامعة للشعوب بقوتها، وخادمة لجهة ذوي السلطان وحدها، في مخالفة صريحة للشريعة الإلهية. وذلك لأن الله قد شرع للأفراد من عباده المقاتلة دون أنفسهم وأموالهم، وإن كان المـُقاتَل مـُسلما. وقد روى أبو هريرة، فقال: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟" قَالَ: «فَلَا تُعْطِهِ مَالَكَ!»؛ قَالَ: "أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي؟" قَالَ: «قَاتِلْهُ!»؛ قَالَ: "أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟" قَالَ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ!»؛ قَالَ: "أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟" قَالَ: «هُوَ فِي النَّارِ!»"[4]. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيد!»[5]. وقد يلتبس هذا الأصل في التشريع، مع النهي عن مقاتلة السلاطين على الدنيا في آخر الزمان، الذي ورد ضمن رواية علقمة بن وائل الحضرمي (وقيل في حديثه إرسال) عن أبيه رضي الله عنه، قال: "سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: "يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ، وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا؟ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ!؛ ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؛ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.»[6]، أو كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثَرَةً شَدِيدَةً؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ! فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ!»[7]، أو في غيرهما من الروايات... وسبب الالتباس هو اتحاد الصورة في الظاهر، عند مقاتلة العبد دون ماله ونفسه وعرضه؛ والحقيقة هي أن المسألة منوطة بأمريْن: الأول: الزمان؛ ونعني أن الحكم في الزمان الأول، يختلف عنه في آخر الزمان، بسبب شيوع الفتنة في آخرهما. وهذا يعني أن الحكم في الزمان الأول يؤخذ على أنه فردي، ما دام العمل بالشريعة من الناحية الجماعية كان ساريا؛ بعكس ما هو الحال في الأزمنة المتأخرة، وبعد الفسوق العام. والثاني: هو اعتبار الفتنة العامة. ونعني أن القتال في آخر الزمان، لا يبقى ضمن حدوده المشروعة، إن كان فرديا؛ بل قد يتطور بسبب العصبيات المختلفة، وبسبب الأهواء، إلى ما يكون اقتتالا جماعيا بين المسلمين؛ والاقتتال الجماعي حرام بالقطع!... وعلى كل حال، فإن المسألة لا ينبغي أن تؤخذ في زماننا بالاستسهال، مخافة الوقوع في الحرام؛ وهي قابلة للاجتهاد، بحسب الأعصار والأمصار. وأما رباط الخيل، فتدخل ضمنه وسائل النقل العسكرية، من سيارات وطائرات وسفن وغواصات. وكل بلد من بلدان الإسلام لا يعمل على تقوية جيشه بما يلزم من الوسائل الضرورية (اللوجيستيك)، فإنه يكون مخالفا للشريعة؛ وبالتالي يكون آثما على قدر مخالفته. وأما المراد من قول الله تعالى: {تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}، فهو التخويف؛ لأن الكافرين لا يتجاوز إدراكهم الأسباب. لذلك هم يخافون، عند رؤيتهم لأسباب القوة من المسلمين. وإن أمر الله بتخويف الكافرين، هو لغايتيْن: الأولى، وهي لإخضاعهم سياسيا؛ وهذا يُجنّب الجميع القتال. وتجنب القتال، على كل حال، يكون دائما في مصلحة الشعوب جميعا. والثانية، وهي أن ينهزم الأعداء باطنيا، إن هم صمموا على القتال. والانهزام الباطني، هو أساس الانهزام الظاهري في النهاية؛ وهذا معلوم لكل جيوش العالم. لذلك يحرص العسكريون على الرفع من معنويات الجنود، قبل المواجهة وأثناءها، دائما. وعدو الله المذكور في الآية، هو عدو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ وهذا حتى لا يقول أهل الكتاب أو غيرهم، ممن يزعمون أنهم عابدون لله، بأن مقاتلتهم تحرم على المسلمين؛ أو يقول بذلك جاهل أو مغرض من بين المسلمين، كما نسمع في زماننا. ومن كان عدوا لله ورسوله، فهو عدو للمسلمين، لا ينبغي الخضوع له، ولا تنبغي متابعته سياسيا؛ بل يحرم ذلك كله. وأما قول الله تعالى: {وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ}، فمعناه: لتُرهبوا أعداء آخرين، من وراء الأعداء الظاهرين؛ لا تعلمونهم بعلمكم القاصر، ولكن الله يعلمهم بعلمه المحيط. وهذه إعانة من الله لعباده بعلمه، لئلا يكونوا عُرضة للمفاجآت السيئة بسبب جهلهم بالمغيّبات. ومن جملة الأعداء غير المعلومين للمسلمين، المنافقون المندسّون بين صفوفهم. وهذا الصنف لا يُعلم ظاهرا، إلا بعد لحوق الهزيمة بالمسلمين؛ فعندئذ يعلنون عن أنفسهم، ويُساندون الأعداء الظاهرين. ومن يعملْ بحسب التوجيه الرباني القرآني في هذه المسائل، يُكفَ شر جميع صنوف الأعداء الظاهرين والأخفياء!... وأما قول الله تعالى في ختام الآية: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}، فمعناه: إن دخلتم أيها المسلمون في قتال الكافرين، بحسب الأسباب والشروط المعتبرة شرعا، ثم نالكم من ذلك ذهاب لأنفسكم بالقتل، أو تلف لأموالكم بالسلب والنهب، فإن ذلك كله يوفَّى إليكم: فالشهيد يُبدله الله حياة من عنده، بدل الحياة الطبيعية الفانية؛ ويُبدله رزقا دائما طيبا، بدل أسباب حياته الطبيعية أيضا. يقول الله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ . فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ . يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ . الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ . الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 169 - 173]. وأما من يفقد ماله، فإن الله يُعوضه في دنياه عنه بأضعاف مضاعفة؛ ويزيده عليه من رزق الجنة الدائم. وهذا، حتى يظهر لعموم الناس قبل خواصهم، أن معاملة الله صفقة رابحة، بجميع المقاييس؛ حتى بمقاييس المادة والحسّ. وأما من بلغ مراتب العبودية العليا من الخواص، فإنه يرى الغاية كلها في طاعة أمر الله ورسوله عن محبة ورضى؛ من دون نظر إلى جزاء. وهؤلاء يعد لهم ربهم من الجزاءات، في الدنيا والآخرة، ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ، مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ؛ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ؛ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ؛ ذُخْرًا! بَلْهَ مَا أَطْلَعَكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ! ثُمَّ قَرَأَ: {فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ}»[8]. وأما قول الله تعالى: {وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ}، فإن الخواص يستحيون عند سماعه؛ لأنهم يعلمون أن الباعث عليه شك النفوس في موعود ربها، ولو بقدر ضئيل، أو بقدر خفيّ. تعالى الله أن يكون من الظالمين!... ثم يقول الله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} [الأنفال: 61]؛ وهذه قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية، لأن السلم عندنا أصل والحرب ضرورة عرضية. وهذا بخلاف ما يُشيع الجاهلون من أن المسلمين يسعون إلى الحروب سعيا!... ومعنى جنوح الأعداء إلى السلم، هو ميلهم إليها، واختيارهم لها على الحرب والقتال. والأمر بإيثار السلم، هو للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكل خليفة بعده؛ هو من باب اختيار الأصل في التشريع على الفروع. لكنّ هذا الجنوح إلى السلم من قِبل المسلمين، لا ينبغي أن يكون عن مهانة أو صغار، كما نرى في زماننا. فإن ذلك لا يُسمّى عندئذ سلما!... فلا يخدعن أحد نفسه، بما لا يُصدّقه الدليل من الواقع!... وإن استجابة المسلمين للصلح مع الأعداء، لا تكون إلا مع التوكل على الله؛ لأنهم لا يعلمون ما يُخفَى لهم من خطط تمويهية، يكون ظاهرها طلب الصلح، وباطنها الإيقاع بهم. وإن هم توكلوا على الله في السلم، كتوكلهم في الحرب، فإن الله يتولى أمرهم بحسب علمه المحيط. وكيف يُغلب من كان الله مُخبره بغيوبه، من دون العالمين؟!... لهذا، ختم الله الآية الكريمة بقوله: {إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}: أي سميع لما تُضمرون في أنفسكم أنتم وأعداؤكم، عليم بكم وبهم... ثم يقول الله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 62]. والمراد من الذين يريدون أن يخدعوا، هم الأعداء الذين يتظاهرون بالرغبة في الصلح. والله يُطمئن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، على أنهم لن يتمكنوا من ذلك؛ لأنه سبحانه وليّه وحسبه. وهذا يكون من باطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ظاهره؛ في مظهره الشريف لا خارجه، كما قد يتوهم المتوهمون. ويؤكد سبحانه تولي أمر نبيّه، بتذكيره بسالف عنايته: من تأييد بنصره من وراء الأسباب، ومن منعة بالمؤمنين من قومه وممن أتى بهم من أقوام آخرين. وهذه العناية الإلهية ثابتة بالوراثة، لكل رباني من هذه الأمة؛ لذلك هم يسيرون بين الناس كالصبيان؛ بسلامة صدر وحسن ظن، من غير خوف خيانة أو غدر. ومن عرف بعضهم عن كثب، فإنه سيعرف حتما ما نشير إليه... ثم يقول تعالى: {وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 63]. التأليف بين القلوب، يُقصد منه ما يكون بين المؤمنين من وحدة في التوجه والفعل والغاية. وهذا التأليف من فضل الله، الذي يوجد بينهم الوجه المشترك، من وراء الوجوه الاسمية المختلفة المدبرة لهم؛ وهذا، لأن لكل اسم معناه الخاص؛ ولو تُرك الأمر لظاهر معاني الأسماء، لوقع اختلافٌ بين المؤمنين، لا يكاد يُوجد له مُشترك من جهة الظاهر. والله -من كونه مسمى جميع الأسماء- يمتن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه هو من ألف بين قلوب المؤمنين؛ وأما النبي من كونه مظهرا، فإنه لا يتمكن من التأليف بين قلوبهم، ولو أنفق جميع ما يُنفق في العادة، من أجل تحقيق الغايات. وهذا لأن التأليف هنا هو تأليف بين القلوب، لا بين الأبدان وحدها؛ والتأليف بين القلوب، لا بد أن يكون من جهة باطن الأسماء، لا من جهة ظاهرها وحده. وتخصيص القلوب بالذكر، هو لأن القلوب هي مسرح الأسماء الإلهية، الذي تظهر عليه تجلياتها، والتي قد لا يرشح على الظاهر منها، إلا بعض ذلك لا كله. وهذا العلم، من علوم القلوب؛ وهي كلها علوم خاصة، لا يعلمها إلا الخواص من العباد. ويختم الله الآية بذكر اسميه: العزيز والحكيم؛ وهذا لأن علم تجلي الأسماء، وعلم ظاهرها وباطنها، عزيز، يضن به على جل عباده؛ وأما الحكيم، فإنه صاحب الإذن على باب العزيز، ليدخل هذا العلم أهله، الذين يختارهم ربهم له. ثم يقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} [الأنفال: 64]. ومعنى الآية: يا أيها النبيّ حسبك الله مولى لك ووليّا؛ فلا تتوكل على غيره. وهو أيضا حسب المؤمنين منك، ليتوكلوا عليه تبعا لك. أو هو: يا أيها النبي حسبك الله من باطنك، الذي هو قبلة توجهك؛ والذي هو أيضا الظاهر بالأسماء التفصيلية في مظاهر أتباعك من المؤمنين. فكأنه يقول له: إن حسبك الله من جهة الباطن ومن جهة الظاهر؛ من جهة قلبك ومن جهة ما يشهد بصرك!... وهذه هي الإحاطة الإلهية، التي تحيط بالعبد المخصوص من جميع جهاته؛ حتى لا يجد مخلوق طريقا إليه إلا بإذن من الله!... ثم يقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ} [الأنفال: 65]. يأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتحريض المؤمنين على القتال؛ وذلك يكون بذكر ما أمر الله به، وبالترغيب في تحصيل أجره، والترغيب في دخول الجنة لمن مات شهيدا في سبيل الله. وهذا التحريض لا بد منه، حتى يجد المؤمنون إعانة على خوفهم الطبيعي وعلى الشح النفسي الجبليّ. والمؤمنون بانفعالهم للتحريض النبوي، يكونون كمن يخرجون عن حكم أنفسهم، إلى مطالعة موعود ربهم؛ وهذا لا يستطيعه إلا مؤمن!... فإن غادر المؤمنون حكم نفوسهم، ظهر فيهم من القوة، ما لم يظهر من أحد غيرهم؛ حتى إن الرجل الواحد منهم، الصابر المحتسب، قد يغلب عشرة من أمثاله. ويعلل الله هذه الغلبة، بكون الذين كفروا لا يفقهون؛ وهو ما يجعل الإيمان في أصله علما، يجد المؤمنون أثر العمل به على ما حولهم من الناس والأشياء. وهذه القوة العلمية الإيمانية، التي سماها الله هنا فقها (بمعنى إدراك حقائق الأشياء)، يفتقدها الكافرون، الذين لا يعلمون إلا ما يُعطيه حسُّهم، ومن ورائه ما تُدركه عقولهم المحجوبة. لهذا، لا يمكن للكافر أن يقطع بغلبة الواحد للعشرة، إن لم ير من الأسباب الظاهرة ما يعينه على قبول ذلك. أما المؤمن، فقد تكون المظاهر دالة على عكس ما يدل عليه الإيمان؛ ومع ذلك يُثبته الله، ويحقق من النتائج ما تحار فيه العقول!... وهذا الذي نذكره هنا، يدخل هو الآخر ضمن منطق الإيمان الذي سبقت منا الإشارة إليه، إلى جانب المنطق العقلي العام. فليُعتبر هذا، عند أهل زماننا خصوصا، لأنهم صاروا يعتمدون تديُّنا عقلانيا مشوبا؛ لا يُثمر لهم إلا الهزيمة والخذلان... ثم يقول الله تعالى: {الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 66]. وهذا التخفيف من الله، جاء بعد علمه سبحانه بضعف إيمان المؤمنين. فهو سبحانه بعد أن جعل غلبة الواحد للعشرة، نزل بها هنا إلى غلبة الواحد للاثنيْن. وهذا النزول، هو اعتبار لحال عموم المؤمنين؛ وإن كان الخواص من أمثال كبار الصحابة المرضيّين، سيبقون على الحد الأول، بل قد يزيدون. وأما تكرار الله تعالى للنسبة ذاتها في صورتيْن: صورة المائة إلى المائتيْن، وصورة الألف إلى الألفيْن، فهو للدلالة على أثر كبر عدد جماعة المؤمنين على قلوب ضعفائهم. وهذا يعني -من وجه خفي- أن الألف الذين يغلبون ألفين، هم أضعف إيمانا من المائة الذين يغلبون مائتيْن. وهذا من خروج منطق الإيمان الذي نبيّنه المرة بعد الأخرى، عن المنطق الرياضي البحت، والذي هو من المنطق العام. وليُعتبر هذا، فإنه من أسرار الله في خلقه!... وإن الله يجعل غلبة القلة من المؤمنين للكثرة من الكافرين، بإذنه؛ حتى يعودوا عن نسبة نتائج أعمالهم إلى أنفسهم. وهذا، لأن نسبة النفس في الأعمال تُبطلها في الأصل؛ إلا أن يتجاوز الله عن عبده ويعفو. ومعنى قوله سبحانه: {وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ}، هو أنه سبحانه معين لعباده المؤمنين به، المتوكلين عليه، والصابرين على قضائه؛ ومحال عليه سبحانه أن يترك من لجأ إليه، أو أن يُسلمه إلى نفسه أو إلى عدوه. ثم يقول الله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 67]. وهذا الحكم من الله (باطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم)، جاء بعد موافقة ظاهره لأصحابه، عندما تركوا مطاردة الأعداء، واشتغلوا بجمع الغنائم. فرد الله المؤمنين في جميع المعارك التي ستتلو بدرا، إلى الحكم الأصلي، وهو الإثخان في الأرض. والإثخان في الأرض هو المبالغة في النيل من الكافرين، حتى يظهر انقهارهم وخضوعهم. وذلك لأن الغاية من مقاتلة المؤمنين للكافرين، ليست تغليب جانب الأولين على الآخرين؛ وإنما هي تغليب حزب الله على حزب الشيطان. ولقد اشتغل الصحابة بجمع الغنائم، عملا بعادة المحاربين في ذلك الزمان؛ وحيث لم يكن يُرجى من القتال إلا تغليب العصبيات أو تحصيل الأسلاب والغنائم. وهذه من غير شك، غايات دنيوية، لا يمكن أن تكون من غايات الدين؛ لذلك أخبر الله المؤمنين بأنهم ما زالوا يريدون عرض الدنيا، والله يريد (لهم) الآخرة. وقد سمى الله الأموال عرضا، لأن دوامها في الدنيا قليل؛ أما بالمقارنة إلى نعيم الآخرة، فهي لا شيء. ويُرجع الله الحكم هنا أيضا إلى العزيز والحكيم، من بين الأسماء؛ ليبيّن سبحانه أن غلبة حزب الله للكافرين هي من أثر العزة الإلهية، فلا ينبغي النزول به إلى اعتبار الدنيويات، وهو على مرتبة عليا في نفسه. والحكيم، هو المرتب للنصر على العزة الإلهية، ليُظهر النسبة الإلهية في الفعل الظاهر من المؤمنين. ونحن سنعود إلى مسألة الأفعال، مرارا كثيرة، حتى نزيل عنها اللبس العالق بها من أثر تناول القاصرين من المتكلمين خصوصا... ثم يقول الله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [الأنفال: 68]؛ وهذا حكم من باطن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يُشبه ما تعرفه العامة من حال ندمهم على بعض أفعالهم. غير أن أحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لها أثر في الأحكام التشريعية، وفي تلونات نزول القرآن الحكيم؛ ومن هذا الباب، كان الخواص يفتشون في معاني الآيات، عن حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العلم من أسرار القرآن التي لا يُطلع الله عليها إلا الصفوة من عباده. ولم نجد -بحسب علمنا- من أهل الله من دل عليه، كسيدي عبد العزيز الدباغ قُدّس سره!... ولقد حكم الله على من يُخالف حكمه تعالى في الآية الفارطة من المؤمنين، أن يمسهم عذاب عظيم. والعذاب العظيم قد يكون المقصود منه الهزيمة النكراء في الدنيا؛ ومن هنا يظهر إمكان انتصار الكافرين على المؤمنين بنصر الله لهم، على خلاف ما يتوهم عوام المؤمنين. وقد يكون العذاب العظيم في الآخرة بدخول المؤمنين النار لمدة يعلمها الله، اعتبارا لنيتهم وقصدهم لتحصيل الغايات الدنيوية مما هو مجعول في أصله، من أجل التقرب إلى الله. ومن هنا قال بعض المفسرين بأن ما أصاب المؤمنين في معركة أحد من انتكاس، هو من أثر انقباض قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حقهم يوم بدر. وسنعود إلى هذه المسألة، بما يناسبها من تفصيل في إبانها، إن شاء الله تعالى... ثم يقول الله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 69]؛ وهذا الحكم من الله، بعد أن أذن لأهل بدر في أخذ الغنائم، من بعد قسمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها فيما بينهم؛ وهو من العفو الذي نالهم بمحض الفضل. والعفو من أثر المغفرة التي يمحو الله بها آثار الذنوب؛ والمغفرة من أثر الرحمة الرحيمية الخاصة، التي جعلها الله لعباده المتقين؛ وإن كانت التقوى ما تزال هنا بالنظر إلى أحوال عموم الصحابة غاية يُدعَوْن إليها. لذلك ختم الله الآية بقوله سبحانه: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}. ثم يقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 70]؛ وإن الله من رحمته الرحمنية، كما يعتني بأحوال عباده المؤمنين، فإنه لا يُغفل أحوال عباده المشركين؛ ويأمر عبده الخاص، وخليفته الأعظم، بأن يتنزل لهم في الخطاب، كما تنزل لهم في المعاملة. والخطاب الموجه لأسرى بدر، ولكل أسرى المسلمين فيما بعد: {إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ}؛ وما أُخذ منهم، هو أموالهم بما فيها أسلحتهم ودوابهم، وما نالهم من جروح في أبدانهم من القتال. وأما ما سيُبدلهم الله، فهو الإيمان بالله ورسوله، الذي يجعلهم يعيشون عيشة طيبة في الدنيا وفي الآخرة، عندما يدخلون الجنة في زمرة المؤمنين. وأما ما لو علمه الله منهم، كان السبب في انقلاب أحوالهم، فهو ما في قلوبهم من نيات. وهذا يعني أن من كان منهم يطلب الهداية، بعد ما عاينه من آيات الله البيّنات عند القتال؛ وأن من كان يُسيء الظن بنفسه، ويرى في المسلمين أناسا أفضل منه حالا وأرجح عقلا؛ فإن الله سيهديه بهذا الخير، إلى خير أكبر منه وأوسع؛ وهو ما أسلفنا ذكره. وهذا الخير الذي سيجده الأسرى في قلوبهم، هو من الخير الذي هم عليه في علم الله، والذي تقتضي الحكمة الإلهية، أن لا يخرج إلى الوجود إلا بسبب؛ والسبب هنا هو: النظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتقدير معاملته للأسرى بالرحمة وبما يحفظ عليهم كرامتهم، ومعاينة الآيات، وإحسان الظن بالمؤمنين. فمن ظهرت من قلبه آثار هذه الأسباب غيبا، سارعت رحمة الله الخاصة، بقذف نور الإيمان فيه؛ فانقلبت حقيقته انقلابا، لا يعلمه ذوقا، إلا من تفضل الله عليه بإخراجه من الظلمات إلى النور؛ كما أخبر سبحانه: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [المائدة: 16]. ثم يقول الله تعالى: {وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [الأنفال: 71]. أخرج الطبري في تفسيره: [عن ابن عباس رضي الله عنهما: "{وَإنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ} يعني: العباس وأصحابه في قولهم: آمنا بما جئت به، ونشهد أنك رسول الله! لننصحنّ لك على قومنا! يقول: إن كان قولهم خيانة، فقد خانوا الله من قبل، {فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ} يقول: قد كفروا وقاتلوك، فأمكنك الله منهم. (...) وعن قتادة، قوله: {وَإنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ...} الآية؛ قال: ذكر لنا أن رجلاً كتب لنبيّ الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمد فنافق، فلحق بالمشركين بمكة، ثم قال: ما كان محمد يكتب إلا ما شئتُ! فلما سمع ذلك رجل من الأنصار، نذر لئن أمكنه الله منه ليضربنه بالسيف. فلما كان يوم الفتح أمَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، إلا عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ومقيس بن صُبابة، وابن خطل، وامرأة كانت تدعو على النبيّ صلى الله عليه وسلم كل صباح. فجاء عثمان بابن أبي سرح (وكان رضيعه أو أخاه من الرضاعة)، فقال: يا رسول الله هذا فلان أقبل تائباً نادماً، فأعرض نبيّ الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع به الأنصاريّ، أقبل متقلداً سيفه؛ فأطاف به، وجعل ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يومئ إليه. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم يده فبايعه، فقال (النبي): «أَمَا والله لقد تَلَوَّمْتُكَ فيه، لتُوفي نَذْرَكَ!» فقال: يا نبيّ الله إني هبتك! فلولا أومضت إليّ! فقال (عليه السلام): «إنّه لا يَنْبَغي لِنَبيّ أنْ يُومِضَ!». (...) وعن السديّ: {وَإنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأمْكَنْ مِنْهُمْ} يقول: قد كفروا بالله ونقضوا عهده، فأمكن منهم ببدر.]. وأما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّه لا يَنْبَغي لِنَبيّ أنْ يُومِضَ!»، أي يومئ؛ فهو لأن خليفة الله، يفعل عن طريق التصرف بالأسماء الإلهية إذا شاء، ولا يحتاج إلى الاحتيال من أجل الفعل. وهذا الذي وقع، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، راعى نذر الصحابيّ، فأمهله حتى يوفي به؛ ولكنه لم يشأ ذلك بباطنه الشريف، ومال إلى رحمة الرجل وفتح باب الإسلام له؛ وهو الغني صلى الله عليه وآله وسلم، من هذا الوجه، عن عقوبته وعن إسلامه. ولكن حقيقته صلى الله عليه وآله وسلم، هذه هي، رحمة للعالمين؛ بجميع صنوف الرحمة. فجزاه ربه عنا، ما هو أهله، وجعلنا بفضله على قدمه في الرحمة، إنه سبحانه على ما يشاء قدير. ومغزى الآية العام، هو أن الأسرى، إن كانوا من العقلاء، فإنهم سيعتبرون حالهم بعد الأسر، وبذلك لن يعودوا إلى خيانة الله ورسوله، فيُمكن منهم كما أمكن أولا. ومن هذا الباب كنا نقول إن الإيمان، يدل على عقل صاحبه؛ حيث وُجد، وبالقدر الذي وجد. ثم يقول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 72]: في هذه الآية، يبيّن الله حكم المهاجرين الذين هاجروا من بعد إيمانهم؛ وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، عند ترك ممتلكاتهم وأهلهم خلفهم؛ أو عند الدخول بها في المعركة؛ ويُبيّن حكم الأنصار، الذين استقبلوا المهاجرين وآووهم ونصروهم وجاهدوا معهم. فهؤلاء جميعا، حكمهم عند الله، أن بعضهم أولياء بعض؛ وبهذا يصيرون جميعا سواسية في النسبة إلى حزب الله بقيادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن من أثر ولاية بعضهم لبعض أنهم كانوا يتوارثون فيما بينهم، قبل نزول قول الله تعالى الناسخ: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} [الأنفال: 75] وأما نحن فنرى أن الولاية أعم من الوراثة، لذلك فإن النسخ لم يشمل إلا وجها من وجوه أثر الولاية فحسب: وهو الوراثة. وأما الذين آمنوا ولم يُهاجروا، فهم إما مأذون لهم بالبقاء في أماكنهم كالأعراب؛ وإما غير مأذون لهم، فتكون الهجرة مفروضة عليهم على التعيين. وقد قيل فيما هو متعلق بهم من قوله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا}، هو الميراث. وأما إن استنصر هؤلاء الذين بقوا في بلدانهم، المهاجرين والأنصار، على عدو لهم في الدين يريد السطو بهم، فعلى مسلمي المدينة النصر لإخوانهم في الدين؛ إلا أن تكون هذه الموالاة على قوم بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاهدة، فعندئذ لا نصر. وختم الله الآية بقوله سبحانه: {وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}، ليُبيّن فيه سبحانه أنه بصير بكل هذه الصنوف من عباده، وعليم بحكم كل واحد منهم؛ حتى لا يدخل أحد الأفراد في صنف ليس هو منه، ويظن أنه سينال حكمه. وقد قيل في هذا المعنى: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي، وترك الناس على أربعة منازل: مهاجر، وأنصاري، ومسلم أعرابي، وتابع بإحسان. وقد استنتج ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ! وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ؛ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا!»[9]، أن حكم الهجرة ينتهي في الزمن بفتح مكة؛ وهذا المعنى أليق بالسابقين الأولين، من غير شك. لكننا نحن المتأخرين، نرى أن لنا لحوقا في الأحكام، إما بالهجرة وإما بالنصرة، بحسب الحال؛ ومن جهة المعنى. فإذا رحل العبد من بلده طالبا لشيخ يسلك به الطريق (وقد حدث هذا كثيرا في الأمة)، فعندئذ، يكون هذا التارك لأهله، القاصد للرباني، مهاجرا؛ ويكون من استقبله من أهل البلد بالإيواء والنصرة، أنصارا؛ ويكون الفتح المعتبر هنا، هو الفتح المعنوي الذي يقع للمريدين في سلوكهم. وإذا وقع الفتح، ارتفع حكم الهجرة في اللاحقين معنويا، كما ارتفع حكمها في السابقين ظاهريا، بسبب اتحاد الدار، التي هي صيرورة مكة والمدينة سواءً في الحكم؛ واتحاد الظاهر بالمظاهر شهودا، عند ارتفاع الحجاب في المعنى، في حق الواصل. وهذا يعني عندنا، أن من المتأخرين من هم مهاجرون ومنهم من هم أنصار؛ كما منهم أعراب، لم يُهاجروا وإن كانوا مسلمين. وهؤلاء هم عموم الأمة، الذي أسلموا، ولم يطلبوا السلوك في الطريق إلى الله؛ وهو قصور منهم عن طبقة المهاجرين. وأما الأنصار من المتأخرين، فهم أهل بلد الرباني إن كانوا تابعين له؛ وأما إن كانوا خصوما ومعارضين، فإنهم يلحقون من جهة المعنى بأهل الشرك من قريش، بسبب الظلمة الجامعة بين الفريقيْن. ونحن وإن كنا لا نكفّر من لا يتبع رباني البلد، إلا أننا نجعله على خطر، بسبب دعاء المقامات لأصحابها في الدنيا والآخرة. ولهذا، فنحن لا نغتر بإسلام المعاندين للورثة، بل نراهم على نفاق، إن لم يتوبوا عنه، يُخاف عليهم أن يُثبَّتوا فيه. وربطنا في الحكم بين الأولين والآخرين بهذه الطريقة، ليس ابتداعا منا، كما قد يظن الجاهلون، وإنما هو من اعتبار حرمة الموروث (النبي صلى الله عليه وآله وسلم) في مظهر وارثه. علم هذا من علمه، وجهله من جهله!... ثم يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ} [الأنفال: 73]. وهذه الآية لها معنى عام متعلق بالولاية، ومعنى خاص متعلق بالميراث. ولقد سبق أن قلنا إن الأخوة في الدين بين المهاجرين والأنصار، كانت تبعث على التوارث فيما بينهم. ولم يكن يجوز لأخويْن مؤمنيْن أحدهما مهاجر، والآخر باق بين المشركين أن يتوارثا. وكان العمل بغير هذا الحكم، قبل فتح مكة فتنة، نهى الله عن الوقوع فيها. أما بعد الفتح، فقد ارتفع معنى الهجرة من جهة الظاهر؛ وبهذا، عاد التوارث باعتبار الأرحام بين المؤمنين وحدهم، لأن التوارث بين الكافر والمؤمن لا يجوز وإن كان من الأقارب. وأما المعنى العام الذي تدل عليه الآية، فهو أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، بسبب أخوتهم الدينية؛ وأن الكافرين بعضهم أولياء بعض، من كونهم في الطرف الآخر من صف المؤمنين. وهذا يعني أيضا، أن الكفر ملة واحدة، لا يُعتبر فيها اختلاف العقائد بين الكافرين. وقيل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقبل إيمانا إلا من مهاجر، وكان لا يقبل أن يُقيم المسلم بين المشركين. وهذا لأن المجتمع الإسلامي، كان ما يزال في طور التشييد؛ وكان وجود كل لبنة فيه ضروريا من أجل تقوية بنائه وإعداده لوظيفته الدعوية والحضارية في المستقبل. وأما اليوم، فتجوز للمسلم الإقامة بين المشركين، إن كان يأمن على دينه، وكان له سبب شرعي يدعوه إلى ذلك؛ كطلب علم لا يجده في بلاد المسلمين، أو طلب استشفاء غير متوافر في بلادهم. وهذا -كما لا يخفى- ينبغي أن يكون محدودا في الزمان بما يُحقق الغرض؛ وأما الإقامة مطلقا، فلا نراها نحن. ونرى أن فقه المتأخرين مقصر في تناوله لأحوال المعاصرين، وتاركُهم في الفتنة التي حذر الله من الوقوع فيها. وتتفرع عن هذه الأحكام أحكام أخرى، وهي حرمة موالاة المسلم للكافرين، التي صارت شائعة في زماننا؛ خصوصا إن كان المسلم على جنسية البلد الكافر، وقُدر عليه أن يغزو بلدا مسلما، كما كان الأمر إبان غزو الأمريكان للعراق. وهذا أيضا مما هو الفقه المعاصر متخلف فيه، ومما ينبغي أن يُعاد النظر فيه، من قِبل الفقهاء المجددين؛ وإلا فإنها الفتنة العامة، كما صرنا نرى بأعيننا!... ثم يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [الأنفال: 74]. وهذا يعني أن المهاجرين والأنصار في الزمن الأول، والمهاجرين والأنصار من جهة المعنى في المتأخرين، هم المؤمنون حقا؛ الذين لم يتلبس إيمانهم بشائبة، ولم يكونوا تبعا لذلك عُرضة لفتنة. لهم مغفرة، أي إن الله يجلو بنوره ظلمة نفوسهم الأصلية، جزاء لإيمانهم، ولعملهم بمقتضاه. ولقد غفل متأخرو الفقهاء، عن هذه الجزاءات المترتبة على الأعمال المذكورة في الآيات، فاستسهلوا بذلك البقاء على الظلمة، وحُرموا التنوُّر الذي يكون للمؤمنين سببا في ترقيهم عند سلوكهم لطريق الدين. والرزق الكريم المذكور في ختام الآية، هو ما يجده المؤمنون من أهل الترقي، من زيادة في العلم، بحسب ما تحقق لهم من مقامات؛ وما يجدونه من نور يتقوى به إيمانهم، يُعطيهم القوة على السير قُدما في الطريق، إلى أن يبلغوا اليقين الذي هو غاية الإيمان. وإنّ جل العاجزين عن خوض غمار السلوك من المتأخرين، علماء وغيرهم، لم يقع منهم ذلك العجز، إلا بسبب ضعف نور إيمانهم. ونور الإيمان لا يتقوى بالكلام والتنظير، كما قد صار يُفهم من طريق الفسوق؛ ولكنه يتقوى باتباع الشرع، وبتحصيل المدد من الورثة... ثم يقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [الأنفال: 75]. وإلحاق المؤمنين الذين سيؤمنون ويُهاجرون، بعد تبيين الله لحكم ولاية المؤمنين بعضهم لبعض، هو حتى يبقى الحكم مفتوحا، ينخرط فيه كل من التحق؛ وهذا حتى لا يظن المؤمنون الأولون من المهاجرين والأنصار، أنه منحصر فيهم. هذا من جهة الظاهر، وأما من جهة الباطن فإننا قد عرفنا أن الهجرة مستمرة في الناس إلى قيام الساعة؛ وبذلك فإن الملتحقين، سيكونون أفواجا من كل الأجيال المتعاقبة في الإسلام. وقد رأينا سابقا إناطة الميراث بالأرحام، على قول من قال إنها ناسخة لما كان بين المهاجرين والأنصار من توارث؛ وينضاف إلى هذا المعنى ما كان من توارث بالتعاقد، حيث كان يقول الرجل للرجل: ترثني وأرثك. وستأتي فيما بعد آيات المواريث لتبيّن ما يتعلق بذلك كله من تفاصيل. وهنا لا بد من أن نتناول مسألة طرأت على المجتمعات المتأخرة، وبعد خروج المرأة إلى العمل، ولحوق الظلم بها من قِبل أهلها الذين يُخالفون أحكام الله في المواريث؛ وهي (المسألة) ما صار يُعرف بالمطالبة بالمناصفة. ولقد تصدى الفقهاء المترسمون للمسألة بإعادتها إلى أصلها في الشريعة، لكن من غير نظر في مستحدثات الأحوال؛ والتي صارت مجحفة بحق المرأة من غير شك. ونحن وإن كنا لا نجرؤ على الكلام فيما حكم الله فيه ورسوله، فإننا نقرّ بأن المرأة قد صارت مظلومة في هذا الجانب، بما لم تعرفه في كل الأزمنة السابقة. وعلى هذا، فإننا ندعو إلى إعادة النظر في أحوال المرأة، وفي اعتبار استقلالية مالها إن كانت من العاملات؛ لأن الخلط بين العمل بالشريعة من جانب، وبالقوانين الوضعية من جانب آخر، لم ينتج عنه إلا مزيد من الظلم الاجتماعي. وبما أن المسألة كثيرة التفاصيل، فإننا لن ندخل فيها هنا، ونكتفي بهذا التنبيه... وأما قسمة الله للمواريث من لدنه سبحانه، فهو من علمه بحقيقة صلة الأرحام فيما بينها؛ والتي لا يتمكن الناظر بعقله من الوقوف عليها، إلا بتوفيق من الله. ولهذا فصلها الله في كتابه، لأن كتاب الله أصل كل الأحكام التعيينيّة والنسبية، من جهتيْ الإجمال والتفصيل. ولا شك أن صلة الأرحام هي من النِّسب، التي لا يُحيط بحقيقتها إلا الله من علمه المحيط بكل الأشياء. (يُتبع...) [1] . متفق عليه، عن أبي هريرة رضي الله عنه. |



كلمة الموقع
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكل عبد من الصالحين.
إن الكلام في التصوف قد تشعب حتى كاد يخرج عن الضبط في نظر الناظرين. وإن تحديد موقع التصوف من الدين، كان ولا زال موضع خلاف بين المسلمين. والميل إلى طرف دون آخر متأرجح بحسب خصوصية كل مرحلة من مراحل عمر الأمة الإسلامية. لكننا نرى أنه حان الوقت، وبعد أن أصاب الأمة ما أصاب، أن نقول: إن التصوف إسلام. ونعني أنه تحقيق للإسلام!
قد يرى البعض أن هذا تعسف باعتبار أن الكلمة مبهمة وغير ذات أصل شرعي؛ أو هي دخيلة إن اعتبرنا نسبتها إلى الأديان الكـتابية والوثنية على السواء...
وقد يرى البعض الآخر في ذلك مبالغة وتضخيما، إذا رجع إلى مدلول الكلمة وإلى تجليات التصوف المنصبغة بصبغة كل زمن زمن...
وقد يقول قائل: كان في إمكانكم تجاوز لفظ " التصوف " تسهيلا للتواصل والتلاقي، إن كان المراد مجرد عرض للإسلام أو إعادة تناول لمختلف جوانبه...
لكن، نقول: حفاظا على الأدب مع قوم بذلوا في الله مهجهم، سبقونا، ورجاء في اللحوق بهم، نحافظ على اللفظ؛ ومن أجل التنبيه إلى منهج التصوف في التربية، التي ليست إلا التزكية الشرعية، نقول: إن التصوف..إسلام!
لم ينفع بعضَ المسلمين مجرد انتساب للإسلام واعتبار لظاهره على حساب الباطن. ولم يجد إنكار بعض الفقهاء له وقد كذبتهم الأيام. وهاهي الأمة تكاد تنسلخ عن الدين في عمومها..
وها هي الأزمة نعيشها في تديننا، لا يتمكن أحد من إنكارها.. وها هي تداعيات الأزمة تكتنفنا من كل جانب..
ومن جهة أخرى ، لم يعد يجدي من ينتسب إلى التصوف الانزواء الذي كان مباحا أو مستحبا في عهود مضت، وواجب الوقت بلا شك، هو إقامة الدين ظاهرا إلى باطن، بعد أن ولى زمن حماة الشريعة من الفقهاء الورعين أصحاب النور، المجتهدين المجددين .
ولم يعد يكفي الكلام عن الطريقة التربوية الاجتهادية الخاصة بكل شيخ، إلا مع التنبيه إلى الطريق المحمدي الجامع الشامل، حتى تسقط الحواجز الوهمية التي صارت حجبا في زماننا، تمنع من إدراك صحيح للدين.
لذلك ولغيره، نرى أنه من الواجب في زمن العولمة المبشرة بجمع شمل الأمة الكلام عن التصوف بالمعنى المرادف لتحقيق الإسلام، بشموليته واستيعابه كل مذاهب المسلمين.
ونأمل من الله عز وجل، أن يكون هذا الموقع من أسباب ذلك، راجين منه سبحانه وتعالى السداد والقبول، فإنه أهل كل جود وفضل.